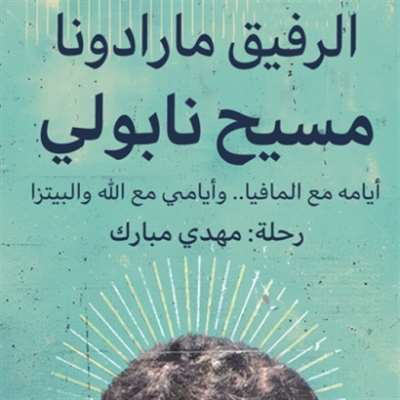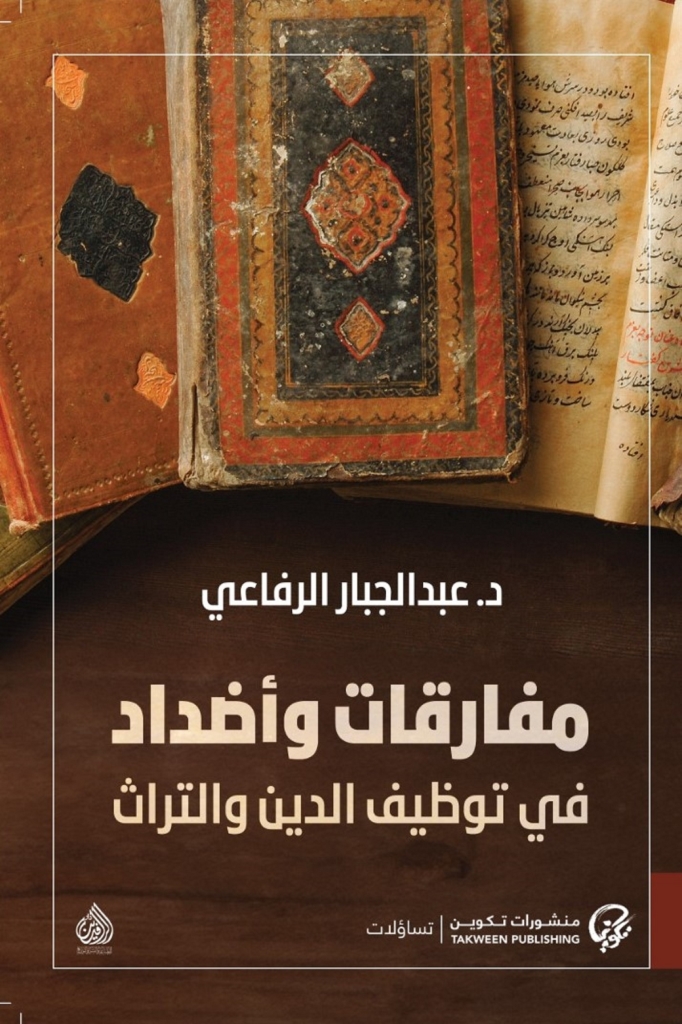
يذهب الكاتب عميقاً في سبر الثقافة العربية ونقدها عبر عرضه ومناقشته لفكر هؤلاء المفكرين العرب والإيرانيين. يناقش فكر علي الوردي، الذي يسمّيه المثقف الديني النقدي الأول في العراق الذي خرج من سجون الأيديولوجيات السياسية عبر قراءته للنصوص الدينية، لأنّ البحث في الدين كان مغيباً في الثقافة العراقية، وانحصر فقط في المؤسسات الدينية. وينوه الكاتب بأنّ مفهوم «المثقف» غامض ومشوّش في العراق، فيسارع كثيرون إلى نفي صفة التدين عن المثقف، وهناك عوامل كثيرة لذلك أولها مركزية الشعر في الثقافة العراقية، وارتباط صفة المثقف بالشاعر. والعامل الثاني هو حضور اليسار الأممي والقومي، الذي اتخذ موقفاً من الدين، معلناً القطيعة بين الجامعات والمؤسسات الدينية، ومحذّراً هذه المؤسسات من الانفتاح على الثقافة، والآداب والفنون.
ولأن المثقف العضوي ــ بحسب الكاتب ــ تناغم مع الأيديولوجيات النضالية، خصوصاً اليسارية، أصبح مشغولاً بتغيير العالم من حوله، وهذا المثقف مسكون بالأيديولوجيا أكثر، من دون أن يأخذ في الحسبان أنّ كل رؤية مختلفة للعالم هي فكرة ينبغي له أن يحترمها ولذلك يقوم بمهمة المفتش. وربما لم يركّز الكاتب هنا على قلة من «المثقفين العضويين» الذين آمنوا بالتغيير، وفي الوقت نفسه لم يأسرهم الجمود العقائدي، لذلك انتقدوا الغرب ولم ينظّروا كثيراً لأيديولوجياتهم بقدر ما اهتموا بكل التراث الفكري، أمثال إدوارد سعيد، الذي كان ناقداً للفكر الغربي الاستشراقي وللإمبريالية الفكرية والثقافية. وقد انتقد أيضاً نظرة الغرب للإسلام. ولكن ربما هنا يعطي الكاتب أولوية للمثقف الذي نهل من التراث وفي الوقت نفسه غيّب كثيراً إلى درجة أننا نجهل أعماله البحثية والفكرية، خصوصاً أنّه ركّز أيضاً على شجاعة علي الوردي بالاعتراف بأخطائه، ومراجعته المستمرة لأفكاره، إذ قال: «ما كتبته بالأمس لا يصلح اليوم، كما أن ما أكتبه اليوم قد لا يصلح غداً».
أما المفكر الثاني الذي تأمّل الكاتب في فكره، فهو المصري حسن حنفي، الذي انتقد الأصولية. كما أن تأويلاته للتراث نهلت من منابع متنوعة، وتخلو كتاباته من التحريض ضد المذاهب. وهو الشغوف بالتراث والتجديد، وكان يتمنى أن ينجز كتاباً عن الثوار في كتابات أميركا اللاتينية، كما أخبر الكاتب حين التقاه. لكن المختلف هنا عن علي الوردي، أن حسن حنفي مثقف رسولي وثائر أيضاً، فقد كان يعتبر نفسه فقيهاً ولكنه في الوقت نفسه، كان يحلم بتغيير العالم بأفكاره. وحين تحدث حنفي في ذكرياته عن رأي الآخرين بكتاباته ومواقفه، قال: «كانت صورتي في الإخوان أنّي شيوعي وصورتي عند الشيوعيين أني إخواني». لقد كان حنفي مسكوناً بيوتوبيا اليسار الإسلامي حيث يلتقي الإسلام بالشيوعية وفقاً لرؤيته، ومن هنا تكمن ثوريته. فهو يصرّ بتساؤل إنكاري: وما عيب الجمع بين العلم والأيديولوجيا، يسارية أو إسلامية؟ ويسأل: هل ينفع تدريس العلم من دون أيديولوجيا؟ وما العيب في أن تؤدي الأيديولوجيا إلى العمل السياسي؟ وما العيب أن يسمع الطالب أيديولوجيات مختلفة ويفكر فيها بدل أن يحفظ كتاباً مقرراً؟ وكان حنفي أيضاً من أكثر المفكرين درايةً بالإخوان المسلمين، فوصف ما تعرضت له الجماعة من اضطهاد، وبرّر نشوء فكر إسلامي معاد للواقع. هكذا، تضمّن تحليله لفكر الإخوان اعترافاً برؤيتهم المغلقة للعالم. ويتحدث أيضاً عن علاقته بسيد قطب الذي تعرّف إليه حين دخل حركة الإخوان المسلمين عام 1951. وسيد قطب أيضاً ـــ في رأي حنفي ـــ هو الذي بدأ ما يسمّى باليسار الإسلامي، فوضع حنفي مشروعه في سياق مشروع قطب، ودافع عن فكره وبرر أخطاءه بإحالتها إلى موضوع السجن والاضطهاد. لكن حنفي يمتلك ــ بحسب الكاتب ـــ مهارة التوظيف البراغماتي للتراث، فقد حاول أن يركب التراث على الواقع والواقع على التراث. وقد تأثر حنفي بالكاهن الكولومبي كاميلو توريس الذي ولد سنة 1929 وقتل مناضلاً سنة 1966. ورؤية توريس الثورية هو لاهوت التحرير الذي هو أيديولوجيا تختلط فيها المسيحية والماركسية، وهكذا كان القرآن بالنسبة إلى حنفي مانيفستو للثورة والتحرير.
وعن المفكر الإيراني داريوش شايغان ( 1935 ـــــ 2018)، يأخذنا الكاتب في رحلة لمعرفة سيرته وميزات فكره. التحق بجامعة «السوربون» ودرس التصوف والديانة الهندوسية، وأصبح أستاذاً مساعداً للأساطير. لعل ما تميز به هذا المفكر هو دراسته للتيارات الفكرية الغربية في موازاة دراسات الأديان والثقافات الآسيوية. عمل شايغان على تطوير ثقافته وتحديث أفكاره، ولم يخجل من المراجعة النقدية، وقد لاحظ أيضاً أن معظم المفكرين الإيرانيين هم شعراء، كجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي. واعتقد شايغان أن جوهر الفلسفة والعلم في الحضارات الشرقية يختلف تماماً عن نظيره الغربي. وتنوعت إحالاته المرجعية، وأمسى قادراً على استبصار تشوهات المجتمعات الغربية والشرقية على حد سواء.
يناقش المؤلّف ظاهرة ثقافية في الفكر العربي، هي الانتقال من الماركسية إلى السلفية
وكذلك كان المفكر الإيراني حسين نصر (1933) الذي نهل من شعراء الفارسية، كحافظ الشيرازي وسعدي الشيرازي وجلال الدين الرومي، وندد بالحداثة الغربية، مشدّداً على أنّ الشرق هو رمز النور والعقل والروحانية. أما المفكر الإيراني أحمد فرديد (1909 ــ 1994)، فقد أعجب بغوستاف لوبون، وانخرط في محفل المثقفين الذين تمحوروا حول القاص الشهير صادق هدايت الذي كان صديقاً له. درس فرديد في «السوربون»، وعاد إلى طهران، ليدرس في جامعتها تاريخ الفلسفة وامتدت مطامحه للحياة السياسية، فاقترب من حزب السلطة وأعلن تأييده للثورة الإسلامية بعد انتصارها. كان هاجس أحمد فرديد هو الهوية والعودة إلى الذات الإيرانية. بعد انتصار الثورة الإيرانية، حرص على ابتكار تفسير ثوري إسلامي لهايدغر، فوجد أن لا تناقض مع تفكير هايدغر والثورة الإسلامية. ويرى فرديد أن الغرب وباء أصاب اليونان القديمة ومصطلح «الإصابة بالغرب» هو وصف لهذا الوباء المتفشي في الشرق المسكون بعقائد الغرب. وعن ظاهرة التحول من الماركسية إلى السلفية، يشير الكاتب إلى فكر المصري محمد عمارة (1931 ــ 2020)، الذي كان ماركسياً ومكث طويلاً في الماركسية ودخل السجن في أيام جمال عبد الناصر. وبعد صعود موجة الصحوة الإسلامية، انتقل إلى السلفية، وتخلى عن وظيفته كأستاذ جامعي، لأنه أراد التفرغ لمهمته الفكرية، فصار يفكر بمنطق مغلق يبدأ بالتراث وينتهي بالتراث. ومع أنه باحث متمرس في التراث، ويكتب بأسلوب ذكي، إلا أن الدين جاء ليحمي الإنسان من الكراهية والعنف والسلفية وفقاً لما يقوله المؤلّف. وهكذا كان جودت سعيد الذي دعا إلى اللاعنف، لكن الكاتب انتقد أيضاً كتاباته التي تفتقر إلى «تفكير متأمل صبور يستخلص رؤية نظرية من النصوص الدينية». أما مالك بن نبي (1905 ـــ 1973)، فكتاباته تنبض بالغيرة على وطنه الجزائر، وتحريره من الاستعمار الفرنسي، والدفاع عن هويته من الاستلاب وحماية دينه وثقافته الإسلامية ويرى القارئ الفطن جروح الاستعمار الفرنسي نازفة في كتاباته التي تمثل الخلفية الفكرية للمقاومة الجزائرية في حرب التحرير. قدّم بن نبي تفسيراً للتخلف والانحطاط في عالم الإسلام في سلسلة «مشكلات الحضارة»، فصاغ معادلة الحضارة من مراحل هي الروح والعقل والغريزة. وكان دقيقاً في توصيف «القابلية للاستعمار»، حيث تكمن مشكلة الإنسان المستعمر.
ولعلّ الأجمل أنّ الكتاب ينتهي بمالك بن نبي الذي ركز على الهوية والمقاومة كأنها دعوة للتفكير في ثورية الإسلام. وهنا نلاحظ أن الواقع وما نعيشه يجعلنا نعيد النظر في فكر الإسلام التحرري المناهض للاستعمار والاحتلال والمقاوم الذي وضع فكره وأيديولوجيته في سبيل مواجهة ذلك الاستعمار. يشكل الكتاب دعوة لإعادة النظر في التراث والفكر الشرقي وعدم الوقوع في فخ الاستلاب الغربي.