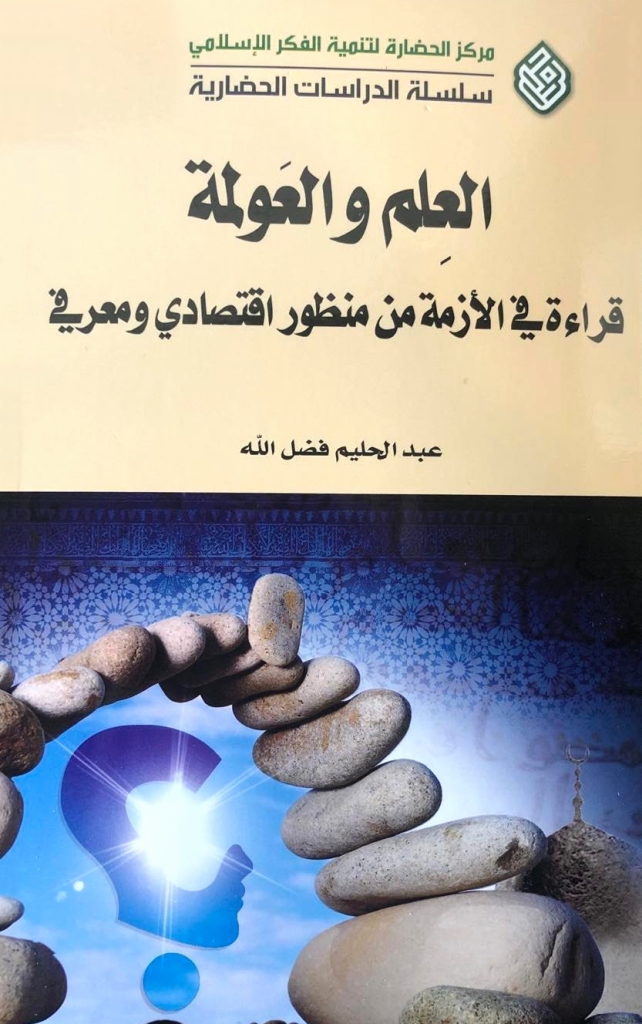
النوع الثاني هو التجاذب بين تحرير الأسواق والتدخّل الحكومي. وهذا أيضاً يرتبط بالمفاضلة بين الحرية الفردية والمصلحة العامة. فالسوق الخالية من القيود هي انعكاس لعدد كبير من الخيارات الفردية، فيما يعبّر التدخل الحكومي عن التفضيلات الجماعية المفترض أن تُحدّد بوسائل سياسية كالانتخابات.
يمكن للأسواق الحرّة أن تُسهم في وضع سلّم الحاجات: ما الذي ينبغي إنتاجه وكيف؟ لكنها لا تقدر على التعامل مع انعكاساتها الخارجية السلبية التي لا يلتقطها تلقائيّاً نظام التسعير، كالإضرار بالبيئة والتوزيع المجحف للأصول والثروات واستفحال الفقر وتقنين بعض السلع الأساسية كالمياه والكهرباء وضعف تأدية الخدمات الحيوية مثل جمع النفايات. ويشمل إخفاق الأسواق على نحو خاص، الفشل في تقديم علاج فعّال لبعض الأمراض المستعصية في البلدان قليلة النمو. تسمح الأسواق الحرة مثلاً برفع أسعار الأدوية مع أنه يتسبّب في موت مئات آلاف الأشخاص سنوياً.
نوع ثالث من التجاذب يتمثّل في التعارض بين المستويين المحلي وما فوق المحلي في اتخاذ القرارات الأساسية التي تمسّ المواطنين. ففي عالم معولم تقع المنظمات الدولية خارج نطاق الضبط الديموقراطي، فلا تأخذ بالاعتبار مواقف المتأثرين بقراراتها وردود أفعالهم تجاهها. يُنظر إلى صندوق النقد الدولي في معظم أنحاء الدول النامية على أنه رمز لاستبداد بيروقراطي مناقض للديموقراطية.
إنّ أشكال التنازع المذكورة هي ذات طبيعة سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، لكنّها تنطوي على جوانب أخلاقية لا يمكن إهمالها. فطريقة استجابتنا للعالم المحيط بنا يحدّدها مزيج من القيم والتاريخ والثقافة والتفاعل مع الخارج. وتأخذ الشركات الكبرى هذا الأمر بالاعتبار، وبقدر ما تعمل على خلق حاجات جديدة للمستهلكين، فإنّها تحرص كذلك، على تقصّي الميول والنزعات الاستهلاكية النابعة من قلب التقاليد الشعبيّة. إنّ الماركات التي لا تتكيّف مع الثقافات المحليّة تجد صعوبة في إيجاد طريقها نحو الازدهار، والماركات المئة الأهم في الترتيب العالمي، والتي هي بمثابة «عُملة اجتماعية» Social Currency، تحصل على قيمتها من خلال خلق صِلات شعورية قويّة مع الزبائن على اختلاف ثقافاتهم. وهذا بالتأكيد لا يتوافق مع الفرضية الشائعة التي تُفيد بأنّ تقدّم العولمة الاقتصادية يؤدّي إلى تراجع التحدّي الذي تفرضه الثقافات المحلية.
جدل الحداثة وما بعدها
أوجدت العولمة سيلاً من السلع والمنتجات والخدمات الجديدة التي ترتبط بحاجات غامضة وغير مؤكدة. ومع ذلك فإنّ الانفصال عنها يخلّف شعوراً بغيضاً بالحرمان، يُضاهي الحرمان من إشباع حاجات أساسية. هذا يجعل موجة الاستهلاك الجديدة ظاهرة ما بعد حداثوية أكثر ما هي حداثوية. إنّها تحظى بقدر أقل من العقلانية، وترافقها تصرّفات اقتصادية لا تتّسم بالحد الأدنى من الرشد. أطلق منظّرو مدرسة فرانكفورت اسم «السيولة الثقافية» على انتشار قيم الاستهلاك العبثي التي تجذب الجماهير إلى مزيد من الشراء. لقد أُصيب أعضاء معهد البحث العلمي في هذه المدرسة بالذهول بعد انتقالهم القسري إلى الولايات المتحدة الأميركية في أواخر الثلاثينيات عندما شاهدوا بأمّ العين كيف تحوّلت الثقافة إلى شكل من أشكال الصناعة في هيوليوود ووسائل البث الإعلامي ودور النشر. آنذاك مارست الشركات الاحتكارية الضخمة، أساليب استغلالية ماكرة، كان لها الأثر البالغ في جعل الناس يهتمون بنظام اجتماعي وتصورات حياتية أحبطت اهتماماتهم الجوهرية وكبتت حاجاتهم الأساسية. إنّ تصنيع الثقافة، بتعبير هؤلاء، يُفقد الثقافة والفنون أصالتها وعمقها وملامحها الثورية، وعوضاً عن أن تكون أداة تغيير وترقٍّ، يُصبح هدفها تلبية حاجات المستهلكين ودمجهم في النسق الثقافي القائم.
تنطلق الحداثة من وجود تصوّرات مسبقة لما هو جميل وما هو مفيد فيما يحاول مؤيّدو ما بعد الحداثة التحلّل من ذلك. ويعبّر شارلز جانكس عن ذلك أفضل تعبير بقوله «إنّ النهاية الرمزية للحداثة في الهندسة المعمارية على سبيل المثال كانت عند الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر 15 تموز 1972، عندما نُسف مبنى بريت-إيغو في سانت لويس المستخدم لسكن ذوي الدخل المحدود، باعتباره بيئة لا يمكن السكن فيها». وبخلاف ذلك كانت إبادة التراث المعماري في وسط بيروت خلال إعادة إعمارها في التسعينيات مثالاً صارخاً على الابتذال الحداثوي الذي مهّد لثورة استهلاكية (يا لغرابة الوصف) لدى اللبنانيين عصفت بقوى الإنتاج، لترث هذه الدولة المتوسطية الصغيرة أزمة لا سابق لها في تاريخ المنطقة ونادرة الحدوث في العالم.
لقد تهاوت بفعل ما تقدّم أفكار ممثلي الحداثة العليا، ما أفسح في المجال أمام ظهور خيارات أخرى تقوم على التعلّم من المشاهد الشعبية العفوية والنسج على منوالها، وبذلك تكون رواية ما بعد الحداثة، كما يذكر ديفيد هارفي، قد قامت بنقلة من «هيمنة الأبستمولوجيا إلى هيمنة الأنطولوجيا»، أو بتعبير آخر الانتقال من الاهتمام بمعرفة الوجود وفهمه إلى تحقيقه وتجسيده.
إنّ تخلّص ثقافة الاستهلاك في حقبة ما بعد الحداثة من ترميزاتها الطبقية والفئوية، واعترافها الظاهري بتنوّع الثقافات، مكّنها من طرق أبواب جديدة والولوج منها إلى مساحات لم تطأها أقدام الحداثة من قبل. فالموجة الحاليّة لثقافة الاستهلاك الملتصقة بثورة المعلومات والاتصالات، تميّز على نحو ذكي وبارع بين القيم الأساسية والمكونات الجوهرية للهوية، وبين عناصر السلوك اليومي الثانوية، فتتحاشى الاصطدام بالأولى، فيما تعمل على تكييف الأخيرة مع متطلّباتها والتكيّف معها في الوقت نفسه.
ومع ذلك لا تخلو النزعة الاستهلاكية من سمات إيديولوجيّة، ففي سياق التقدم الاقتصادي ترتفع المداخيل، وتزداد معها قدرة فئات جديدة من الناس على الادّخار ومراكمة الثروات التي تُستخدم إمّا في المضاربات المسبّبة للأزمات المالية، أو في زيادة الإنتاج الذي يحصل حينها بمعدلات تفوق نمو الطلب الاستهلاكي. وبما أنّ الادّخار يعني سحب قيم متزايدة إلى خارج الدورة الاقتصادية، فهذا يجعل نمط الإنتاج الرأسمالي منطوياً على ميل انكماشي عميق في المدى الطويل، ولا يمكن تفادي ذلك دون إقناع الناس بالإنفاق بلا هوادة لتلبية حاجات ثانوية وكمالية، أو لخلق حاجات جديدة لهم لم تكن موجودة من قبل، وغالباً ما يكون ذلك على حساب أساسيّات العيش.
إنَّ رفع منفعة الاتصال بالشبكة العنكبوتية مثلاً إلى مصافّ المنافع المستمدة من خدمات التعليم والصحة والسكن والسلع، وغيرها من الخدمات كالمياه والكهرباء والطاقة والمواصلات، يسمح للاحتكارات الكبرى بالسيطرة على الموارد الحيوية وزيادة كلفتها، أي خفض إمداد الفقراء بها، وتعويض الحرمان المترتب على ذلك بدفق متواصل من مواد التسلية والترفيه، وبتوسيع قدرتهم على النفاذ إلى الفضاء الافتراضي من خلال تقنيات وتطبيقات متناسلة. وقد شاهدنا في أزمات لبنان مثلاً، كيف كانت ردود فعل الناس عالية القوة عندما جرى المسّ بحقوقهم الافتراضية في الاتصال والتواصل (زيادة الضريبة على خدمة الواتساب عام 2019 مثلاً)، مقارنة مع ردود فعل أقل فعاليّة وقوّة عندما أفتُئت بعد ذلك على حقوقهم الأساسية في الغذاء والدواء والتعليم والنقل والطاقة...
فجوة التكيّف
إنّ من أسباب الفوضى والتشوّش المصاحب للاستهلاك المعولم يكمن في ما أسميناه سابقاً بفجوة التكيّف. فالسِمة الرئيسية للعصر الرقمي، هي أنّ الطفرات التكنولوجية تسير بسرعات متفاوتة بين مسار وآخر. ففي مقابل الثورات المتتالية في المجال الافتراضي، تتطوّر المسارات الأخرى بوتيرة أقل. المؤشّر البارز على ذلك هو الانخفاض الهائل في كلفة الحصول على المعلومات وتداولها. فيما كان تطوّر إنتاج السلع وتكاليفه يجريان بوتيرة أبطأ بكثير، فلو أنّ أسعار السيارات انخفضت بنفس نسبة انخفاض أسعار أشباه المواصلات، لصار سعر السيارة خمسة دولارات فقط! أما كلفة تشغيل خطوط النقل الجوي فتراجعت خلال العقود الأربعة الأخيرة إلى النصف فقط.
إنّ فجوة التكيّف تنشأ أيضاً من اختلاف وتائر التقدم السريعة على المستوى التكنولوجي والبطيئة في مجال الأنظمة القانونية والاقتصادية والاجتماعية المساعدة على استيعاب الأجيال الجديدة للتقانة، وهذه يصعب توطينها من دون تكييف ثقافي موازٍ ومن دون إزالة العوائق الاجتماعية التي تعترض الاستفادة منها. فالعصر الرقمي يزيد قدرة الأفراد على تلقّي البيانات ويعزّز التفاعل فيما بينهم وذلك بغضّ النظر عن انتماءاتهم، لكنّ الموانع الثقافية تُبطئ انتشار تأثيرات ذلك في المجتمع.
وعلى العموم، ما إن تخرج المجتمعات المتلقّية من فجوة ناتجة عن صدمة تكنولوجية سابقة حتى تقع في فجوة أخرى ناتجة عن صدمة لاحقة. لنتذكر استطراداً هنا أنّ الموجات التكنولوجية في تصاعد من حيث قوة التأثير والالتصاق بالأفراد والمجتمع، وهي تنحو أكثر نحو الفردانية. كلمة خصوصية Privacy تقع الآن على رأس قاموس لغة الاتصالات ما بعد الحداثية. كلنا يبحث عن الخصوصية التي تمنع تعقّب خطواتنا داخل عالم الميديا الاجتماعية. لم تكن هذه الكلمة تعني شيئاً بالنسبة إلى موجة الاتصالات السابقة فالتلفاز، كما الهاتف، كان يُستهلك جماعياً ومن دون خصوصية تُذكر. التقنيّة الجديدة تمنحنا فرصة كبيرة للتفاعل المتواصل وفرصة أكبر للانعزال، وتقوم أبجديّتها المتناقضة على الاتصال والانفصال، بحيث يتمدّد الفرد اجتماعياً وثقافياً ونفسيّاً ما بين عوالم مختلفة ومتباعدة يتنقل فيما بينها كما تتنقل أصابع العازف على مفاتيح البيانو، منتجاً سمفونية حياتية غريبة وهجينة.
لا تخلو النزعة الاستهلاكية من سمات إيديولوجيّة، ففي سياق التقدم الاقتصادي ترتفع المداخيل، وتزداد معها قدرة فئات جديدة من الناس على الادّخار ما يجعل نمط الإنتاج الرأسمالي منطوياً على ميل انكماشي عميق في المدى الطويل
وفي خلاصة القول، أحدثت العولمة تحوّلات كثيفة وعميقة في حياة الناس وطرق عيشهم، لكنّ العلوم الإنسانية والاجتماعية تعجز حتى الآن عن التقاط أبعادها ومعرفة سبل التكيّف معها. فمن الشقوق الكثيرة الموجودة في جدران البحث العلمي مرّت موجات الحداثة وما بعدها من دون حسيب أو رقيب. وعلى هذا النحو الخاطئ جرى المزج بين الابتكارات العلمية والثقافة، التي تحوّلت بفعل تقنيات الاتصال إلى سلعة يجري تبادلها وتلقّيها في سوق ارتُئيَ أن تكون متجانسة ومتمحورة حول مركزها الغربي.
وهذا مستمدٌ من نظرة الحداثة المتناقضة للفرد، الذي هو في السياسة والهويّة غارق في الخصوصية، ويعبّر عن انتمائه من خلال التمايز عن الآخرين، لكنه في الاقتصاد منصهر في السلوك الجبري الذي تفرضه قوى الإنتاج، ومنقاد إلى روح القطيع التي تحكم سلوك مجتمع الاستهلاك، ومنطقه وممارساته. وهذه مفارقة تُعزى كمثيلاتها إلى زيادة مظاهر الانطواء على الذات في مجتمع المعرفة والانقطاع المنهجي الذي اتسع نطاقه بين حقول العلم، وتتصل كذلك بإعادة تعريف الوظائف الاجتماعية للعلوم، وترتيبها ضمن هيكليّة لا تعبّر عن حقيقة الإنسان وغاياته وآماله.


