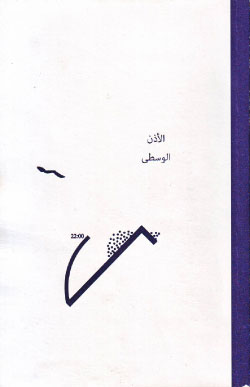للوهلة الأولى، ستصدمنا متاهة العنوان: «الأُذن الوسطى». كتاب صغير الحجم بغلاف أبيض، لا يحمل اسم صاحبه، لكنّنا سنكتشف لاحقاً، أنّ المقصود هنا هو تجليات «الصوت». المشروع اقترحه الكاتب هيثم الورداني والفنّانة البصريّة مها مأمون بمبادرة من «مؤسسة الشارقة للفنون»، على ثمانية كتّاب مصريين، بهدف استجلاء علاقتهم بالصوت عبر نصوص شخصية، تراود مناطق مهملة في الكتابة العربية. المسافة بين العبارة المتوارثة «سمعاً وطاعة يا مولاي» والإصغاء وما تخزّنه حاسة السمع، ترسم معالم خريطة الأُذن العربية في تاريخها المقهور. ثنائية السمع والطاعة، ليست فضيلةً دوماً. لقد جرت محاولات للتحايل عليهما، والانتباه إلى الصوت الداخلي، بعيداً عن سطوة صوت السلطة.
هكذا يقترح محمد عبد النبي أن تتجاوز الأذن قدراتها المبدئية والنفعية، لتكتشف المتاهة الحقيقية، داخلها وخارجها. يقول: «أصابني الضيق حين سمعتُ صوتي الخاص لأول مرة، وكان على شريط مسجل سوف يتم إرساله إلى أحد الأقارب في العراق (...). نسيت الموضوع بالطبع فيما بعد، حتى اكتشفت تدريجياً أن الصوت الذي نسمعه لأنفسنا، ونحن نتحدث أو نغنّي أو نصيح أو نبكي، ليس هو نفسه الصوت الذي يصل إلى الآخرين. صوتان مختلفان تماماً. وأتضايق حين أسمع صوتي من مصدر خارجي». وتذهب إيمان مرسال إلى فضاء آخر للصوت، لتتعقب تفوّق اللغة الأم على اللكنة المكتسبة في إيقاع الجملة، وخيانة التعبير، ما يستدعي استنفار حواسّ أخرى باعتبار أن الصوت في غير مكانه. وهذا ما يجبر صاحب اللكنة الهجينة على أن يتفادى الكلمات التي ـــــ رغم دقتها ـــــ قد تعطّل صوته «لأن ذبذبات اللكنة قد تقطعها بأكثر من طريقة». تكتب إيمان: «لا تصبح اللكنة مصدراً للشعور بالعار، ولا تجعل صاحبها يتوتر، إلا إذا كانت دلالة على وضعيته الأقل من وضعية الأذن التي يتوجه إليها بصوته. ما يحدد الوضعية يكون عادةً أكبر من حبل الصوت ونيّته، قد تكون علاقة المركز بالأطراف، علاقة المستعمر بلكنة سكان مستعمراته، التعليم بالأمية، المدينة بالريف، الطبقات المحظوظة بالطبقات الأقل حظاً. لا يمكنني أن أتخيل صاحب لكنة اكسفوردية يشعر بالعار وهو يتحدث مع صاحب إحدى لكنات الطبقة العاملة في إنكلترا (...) اللكنة هي مجاز شفاف عن علاقات القوة».
وفي نصّه «فرم الأذن»، يشير هاني درويش إلى أنّ المبدأ الأساسي للفضاءات العامة في مصر هو «سلطة الاستحواذ»، وذلك وفق توازن قوى خشن، يجعل من يسيطر على هذا الحيّز من الفضاء، حاكماً شرعياً لما يسمعه أو يراه الطرف الأضعف. الفضاء السمعي إذاً، هو ساحة معركة. صخب ميدان التحرير (قبل دلالاته اللاحقة)، معركة أصوات محركات خشنة وبذيئة، ونداءات سائقي ميكروباصات آخر الليل، لتستكمل عدّتها في مزاج السائق ومختاراته الغنائية... وإذا بالميكروباص يتحوّل إلى كشك موسيقي متجوّل.
ويأخذنا ياسر عبد اللطيف إلى ذاكرة سمعية مختلفة تعبّر عن جيل التسعينيات في تيهه وضجره، وحيرته بين موسيقى «الروك آند رول» عبر أنغام الـ «بينك فلويد»، وآهات أم كلثوم المنبعثة من فضاء آخر. هذا الاضطراب السمعي سوف يقوده إلى التنقيب في التراث الغنائي المصري المهمل والمهمّش أمام الموجات الغنائية العابرة. هجرته إلى كندا، وضعته أمام اختبارات صوتيّة أخرى. الصمت المطبق هنا، وزحام الأصوات في القاهرة، ذاكرتان متضادتان في أرشفة الصوت الشخصي.
ويسترجع وائل عشري أصواتاً لا أجساد لها في رواية «الباب المفتوح» للطيفة الزيات، متسائلاً: «هل من الممكن أن تفوتنا، هنا، ونحن على عتبة الباب المفتوح، غرابة تلك الأصوات التي لا أجساد لها، التي تتجول وحدها في فضاء نصّ يبحث بقسوة، بعنف، عن أذن تنصت إليها؟ علينا أن نخاف، ولو قليلاً، على الأقلّ لأن نيتشه أخبرنا أن «الأذن عضو الخوف»، علينا أن نتوجّس من تلك الغرابة». من جهتها تطلق دعاء علي صيحات استغاثة قائلة: «ما أشعر به شعوراً مباشراً هو أن الأصوات المتحدثة كأصوات داخلية تتحرك مثل خيوط طويلة داخل رأسي وهناك تتسبب في شعور بالشد المؤلم بسبب سم الجثث الذي تخلفه وراءها». من جهته يستدرجنا هيثم الورداني إلى الصمت الكلي لاكتشاف أطياف الأصوات المتراكمة وتفكيكها إلى وحدات منفصلة: «اجلسْ نصف ساعة وسط تلك الضوضاء المزعجة. اترك موجات الصوت تكتسح أي فكرة أو انطباع لديك. وتأمل استحالة تركيز انتباهك على فكرة واحدة».
لا سمعاً ولا طاعةً يا مولاي