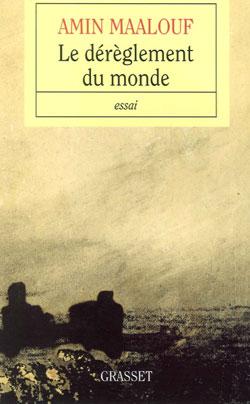وتعوّد ألّا يقضي في باريس سوى شهرين في السنة، خلال فترة الترويج لكل عمل جديد يصدره، ليعود بعدها إلى جزيرته البعيدة. ويتضح ذلك من ردّ فعله الأول عندما سُئل عن شعوره فور انتخابه لـ «الأكاديمية» في 23 حزيران (يونيو) الماضي. عبّر عن سعادته، لكنّه أسف لأن هذا الاختيار سيتطلب منه تضحية كبيرة، إذ سيحرمه التفرغ الكامل للكتابة. يقول لـ «الأخبار»: «بالفعل أنا سعيد جداً، إذ إنّ دخول مؤسسة عريقة مثل الأكاديمية الفرنسية ذو بُعد رمزي بالغ الأهمية، بالنسبة إلى شخص مثلي قرر أن يرهن كل حياته للكتابة. وأنا سأكون عضواً فاعلاً في كل نشاطات الأكاديمية، علماً أنّ ذلك سيتطلب مني تضحية كبيرة، إذ سيضطرني إلى الإقامة فترات أطول في باريس، وبالتالي سيحرمني متعتي الأكبر في الحياة: عزلة الكتابة...».
تمثل «الأكاديمية الفرنسية» واحدةً من أعرق المؤسسات في فرنسا، وتحتضن كتّاباً ومفكّرين بارزين خدموا لغة موليير، ويطلق عليهم لقب «الخالدين». لهذا ربّما تسرّع بعض المثقّفين العرب، ووجدوا فيها واجهة لـ «الفرنكوفونية الرسمية» التي نأى عنها أمين معلوف منذ بداياته الأدبية مطلع الثمانينيات، فيما انغمس فيها أدباء عرب آخرون ممن يكتبون بلغة موليير، ولعل أشهرهم المغربي الطاهر بن جلون. وقد مثّل الموقف من «الفرنكوفونية الرسمية» موضوع تجاذب ونقطة خلاف كبيرة بين الكُتّاب العرب الفرنكوفون، إذ أدانتها أقلام مرموقة من أشهر من كتبوا بالفرنسيّة، من كاتب ياسين إلى محمد ديب، ومن إدريس شرايبي إلى رشيد بوجدرة. وقد عاب هؤلاء على «الفرنكوفونية الرسمية» ومؤسساتها منحاها «النيوكولونيالي»، لكن ها هو الجدل يتراجع تدريجياً، ولم يعد مطروحاً بالحدّة عند الأجيال الجديدة من الكتّاب العرب الفرنكوفون.
أما أمين معلوف، فيتحاشى الخوض في هذه المعارك ذات الخلفيات السياسية. وينظر إلى «الأكاديمية الفرنسية» من زاوية أخرى، مفضلاً كعادته استعادة التاريخ لتسليط الضوء على مكانة هذه المؤسسة العريقة: «حين أنظر إلى تاريخ «الأكاديمية»، أجد فيه لحظات جميلة ومؤثرة كثيرة، وخاصةً منها تلك اللحظات المفصلية التي عبّرت فيها «الأكاديمية» عن قدر كبير من الشجاعة في مواجهة النظام الحاكم، من لويس الرابع عشر إلى نابوليون الثالث. فضلاً عن موقفها المشرّف خلال الاحتلال النازي لفرنسا...».
هكذا هو أمين معلوف، يقف على الدوام في موقع المغايرة، ولا يتردد عن التغريد خارج السرب. من «ليون الأفريقي» إلى «سمرقند»، ومن «موانئ المشرق» إلى «صخرة طانيوس»، تكرّست مكانته كأحد أشهر الكُتّاب العرب في الغرب، لكنه بخلاف أدباء كبار آخرين ممن اختاروا اللغة الفرنسيّة، لم يُدر ظهره للقارئ العربي، ولم ينجرّ نحو مداعبة المخيلة الغربية المشبعة بالرؤى الاستشراقية المشوبة بالمغالطات والتعميم، بل سعى دوماً إلى أن يكون جسر تفاهم وتواصل بين العالمين العربي والغربي، محاولاً التأسيس لتبادل ثقافي وحوار حضاري ندّي بين الشرق والغرب، بعيداً عن الرؤى الاختزالية والأفكار الجاهزة.
منذ كتابه الأول «الحروب الصليبية كما يراها العرب» (1983)، لم يتردّد أمين معلوف في التجذيف عكس التيار، سالكاً دروباً وعرة ومغايرة لخلخلة يقينيات التاريخ الرسمي. في رواياته السبع («ليون الأفريقي»/ 1986، و«سمرقند»/ 1988، و«حدائق النور»/ 1991، و«القرن الأول بعد بياتريس»/ 1992، و«صخرة طانيوس»/ 1993، و«موانئ المشرق»/ 1996، و«رحلة بلداسار»/ 2000) التي نالت جميعها شهرة عالمية، وتُرجمت إلى 38 لغة، وفي العديد من أبحاثه التاريخية ومؤلفاته السياسية، يصرّ أمين معلوف على وضع قارئه ـــــ الغربي والعربي على السواء ـــــ أمام صورة أخرى للتاريخ المتوسطي المشترك، تخالف جذرياًَ الصيغ الرسمية للتاريخ، التي كُتبت على الدوام وفقاً لـ «أهواء المنتصرين». ويفسر ذلك بقوله: «في تناولي للتاريخ، أسعى إلى تحطيم الكثير من الأفكار الجاهزة والأساطير المتداولة التي أعدّها مؤذية فكرياً. وأحاول إبراز الجوانب المشرقة والإيجابية في الميثولوجيا المتوسطية وتثمينها، كإسبانيا العهد الأندلسي، حيث تعايشت الأديان السماوية الثلاثة، أو إيران الشعراء والمفكرين الذين أسّسوا قديماً حضارة الحكمة الشرقية...».
لا يكلّ أمين معلوف في مسعاه السيزيفي، لبناء جسور التواصل والحوار والتسامح بين ضفتي المتوسط، غير عابئ برياح التطرف ونفير «صراع الحضارات»، وهو الشيء الذي يفسّر ما تتسم به بعض كتاباته وقراءاته للتاريخ من نظرة مغرقة في التفاؤل. وهو ما يعترف به، لكنه يستدرك قائلاً إنّ هذه الرؤيا التفاؤلية لا تعني تحريف التاريخ أو تزويره. يقول: «أنا أدرك جيداً أن الحروب الصليبية أو الغزوات الاستعمارية لم يكن الهدف منها الحوار الثقافي، أو التبادل الحضاري. وأعرف أيضاً أن كثيرين من أتباع الأديان السماوية يلعنون أتباع الأديان الأخرى في صلواتهم، اليوم كما بالأمس، لكن هناك على الدوام رجال ونساء يتجاوزون تلك الأفكار المسبقة، وينجحون في إقامة أواصر من الأخوّة والصداقة والمحبة، رغم كل العوائق والحواجز، ويتطلعون معاً إلى بناء مستقبل مشترك ومغاير...».
للتدليل على صواب مقاربته هذه، يضرب أمين معلوف مثلاً ببعض التيارات النادرة من المياه العذبة التي تشق طريقها في أعمق البحار، متحدية ملوحة المحيط: «أشعر بأنني في مسعاي كمن يبحث عن هذه التيارات العذبة النادرة. في العالم المقلق الذي يحيط بنا، أفتّش باستمرار عن أسباب للاستمرار في الأمل والحلم بمستقبل إنساني أفضل. وأنا إذ أفعل ذلك، أدرك جيداً أنني لو قمت بالمقاربة المعاكسة، أي البحث عن أسباب لليأس والتشاؤم، لوجدت ضالتي، بلا شك، بشكل أسرع وأسهل..».
عمله المقبل عن «الربيع العربي»: الكاتب الذي تفاءل بالعولمة
بعد الانتهاء من كتابه السياسي «اختلال العالم» (2009)، أعلن معلوف أنه شرع في كتابة رواية مستوحاة من الحرب الأهلية اللبنانية. لكن تسونامي الثورات العربية، دفعه إلى تأجيلها، والتصدي لعمل سياسي يواكب «الربيع العربي»، يأمل إصداره الخريف المقبل، كما يقول لـ«الأخبار».
كثيرون أعابوا على أعمال معلوف السياسية نزعتها المغرقة في التفاؤل التي جعلته في «الهويّات القاتلة» (1998) مثلاً، يستبشر خيراً بمدّ العولمة، متوقعاً أن تؤسس لـ «ثقافة كوسموبوليتية» تسهم في انتشار قيم الحرية والتسامح. وإذا به يعود بعد عقد ليراجع تلك النظرة المتفائلة. في «اختلال العالم»، اعترف بخيبته من العولمة، قائلاً: «لقد حان الأوان لإعادة النظر في المنطق المهيمن في العالم (...) وقبل أن يفضي الخلل الحاصل حالياً في عالمنا الراهن إلى تفكّك الضمير الإنساني...». يعترف هنا بأن العولمة أفضت إلى تغذية النزعات القومية والحروب العرقية. ويوجّه أصابع الاتهام إلى الغرب: «لقد كانت الحضارة الغربية (...) مختبراً لتوليد القيم والمبادئ ذات البعد الإنساني والعالمي. لكن الغرب ظل عاجزاً عن تكريس تلك القيم أو تقاسمها مع بقية دول العالم، لأنه يميل دوماً إلى استعمالها كأداة للهيمنة على الشعوب الأخرى...». وقد استعرض في «اختلال العالم» مآسي حرب العراق وفظائع سجن أبو غريب، للتدليل على المنزلقات الكارثية التي أفضت إليها «خيانة» الغرب لقيمه. هل تعني هذه المراجعة أنّه تخلى عن «الحلم الكوسموبوليتي»؟ يجيب: «إطلاقاً، أنا واثق بأنّ المخرج الوحيد للأزمة الأخلاقية التي تعصف بالعالم تكمن في بلورة شعور بانتماء مشترك بين الإنسانية». لكن كيف السبيل إلى عولمة ذات بعد إنساني تفسح المجال أيضاً لمرور الأفكار والقيم والبشر؟ هنا، يستعيد معلوف نبرته المتفائلة: «إذا استطعنا توظيف كل التحديات المصيرية المشتركة التي تواجهنا من أجل إعادة صياغة العلاقة بـ «الآخر» على أُسس تحفظ الكرامة الإنسانية، لن يعود هناك أجنبي في هذا العالم، بل رفقاء درب في مسيرة ستفضي إلى إعادة صياغة مستقبل البشرية والتأسيس لعالم من التآخي والتسامح والحرية».
|عثمان...