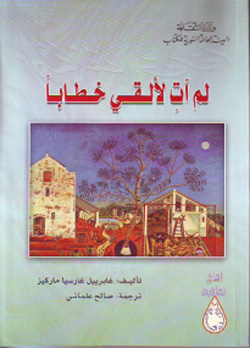يقوّض غابرييل غارسيا ماركيز (1927) كل احتياطاته المسبقة في عدم اعتلاء منصة لإلقاء خطبة ما، نظراً إلى كراهيته الشديدة لإسداء النصائح والحكم التي تتطلبها هذه المناسبات، كما يقول. ها نحن أمام 22خطاباً ألقاها صاحب نوبل خلال حياته المديدة، حتى إنه يحتفظ بالخطاب الأول الذي ألقاه في وداع زملائه في المدرسة، في منتصف الأربعينيات. في «لم آتِ لألقي خطاباً» (الهيئة العامة السورية للكتاب؛ ترجمة صالح علماني)، نتعرف إلى الضفة الأخرى من سرد صاحب «مئة عام من العزلة»، بعدما نفض الغبار عن ملف مهمل وجده أخيراً بين أوراقه، يحتوي بعض خطبه القديمة. لن نعدم المنحى الحكائي الذي تعوّدناه في رواياته، أو في مذكراته «عشتُ لأروي»؛ إذ يتماهى التخييل بالوقائع. وسنتوقف عند عبارات تسلّلت لاحقاً إلى بعض سطور رواياته. ماركيز في المآل الأخير هو ماركيز، سواء أكان يقف وراء منصة في قاعة، أم أمام مسودة رواية. كاتب قلق تجاه نصه أولاً، وتجاه قارته أميركا اللاتينية ثانياً، وتجاه كوكب الأرض المهتزّ تحت وطأة الحروب والمجاعات وسباق التسلح والدمار البيئي ثالثاً. هذا ما نلحظه في خطاب ألقاه في المكسيك (1991). فهو ينبه إلى المصير الأسود الذي ينتظر البيئة في المستقبل القريب، في محصلة لقطع الغابات وسكب أطنان من الفضلات في المياه وتحويلها إلى مكب للسموم. «ما كلّف الطبيعة، ملايين السنين لخلقه، دمّرناه نحن البشر في نحو أربعين عاماً». في خطابه «عزلة أميركا اللاتينية» الذي ألقاه في الأكاديمية السويدية لمناسبة حصوله على جائزة نوبل للآداب (1982)، يستعيد تاريخ الحروب والديكتاتوريات في القارة المشبعة بالأسطورة والأبطال والطغاة. قارة لم تحظ ببرهة طمأنينة نتيجة العنف والمظالم، فعاشت عزلة قسرية، إلى أن كسرت قشرة البيضة بصناعة الجمال، لجعل الحياة معقولة. هذه المحن لم تمنع صاحب «الحب في زمن الكوليرا» من أن يبدو متفائلاً بالمستقبل، واجتراح يوطوبيا جديدة. «حيث لا يمكن أحداً أن يقرِّر عن الآخرين حتّى طريقة موتهم، وحيث يكون الحب صحيحاً حقاً وتكون السعادة ممكنة». يروي ماركيز في أحد خطاباته (1970)، أنه أتى الكتابة الأدبية مرغماً وبنوع من التحدي، حين قرأ افتتاحية الملحق الأدبي لجريدة «الإسبيكتادور» التي كتبها إدواردو ثالاميا بوردا، ويورد فيها يأسه من نشأة جيل جديد في الكتابة الأدبية. فما كان منه إلا أن جلس وراء طاولته، وقرّر كتابة قصة قصيرة، ليفاجأ بها منشورة على صفحة كاملة في ملحق الصحيفة، مرفقة بملاحظة يعترف فيها بوردا بأنه أخطأ، وبأنّه خلف «هذه القصة يظهر عبقري الأدب الكولومبي». هذه الورطة، كما يقول، قادته إلى مواصلة الكتابة.
أمضى ماركيز 19 عاماً في التفكير، قبل أن يقرر كتابة تحفته، «مئة عام من العزلة» التي وضعت اسمه على قائمة نوبل، وأجبرته على نقض وعوده القديمة بالابتعاد عن التكريمات والجوائز باعتبارها «بداية تحنيط».
في خطاب آخر يتطلع ماركيز إلى الألفية الثالثة بعين قلقة، معتبراً القرن العشرين أشدّ القرون شؤماً، بوجود كارثة كونية على الباب تتمثل بخمسين ألف رأس نووي جاهزة للاستخدام. لكن ما قد يخفّف نسبة الهلاك والكوارث، هو الاحتياطي الحاسم من الطاقة لتحريك العالم باستثمار «الذاكرة الخطرة لشعوبنا»، والتراث الثقافي الهائل، وتصريف الطوفان الإبداعي الجارف بوصفه ثقافة مقاومة واحتجاج، «لا يمكن أن يروضها النهم الإمبراطوري، ولا وحشية الطاغية الداخلي».
ما قد يفاجئنا في متن هذه الخطابات هوس صاحب «الجنرال في متاهته» بالشعر، وطاقته السريّة في تأجيج شهوة الحياة. «في كل سطر أكتبه، أحاول على الدوام، أن أستحضر أرواح الشعر المتهربة، وأحاول أن أترك في كل كلمة شهادة عن إيماني بقدراته التنبؤية». بالطبع سيتوقف ماركيز عند الصحافة «أفضل مهنة في العالم»، مؤكداً عبارة واحدة، هي «الصحافة يجري تعلمها بممارستها»، لكن مشكلتها اليوم في طرق تعلّمها في الأكاديميات، وفي «متاهة تكنولوجيا منفلتة من عقالها بلا ضابط نحو المستقبل».
غابرييل غارسيا ماركيز على منصّة العالم