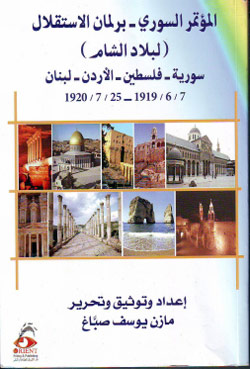في كتابه «المؤتمر السوري ـــ برلمان الاستقلال» (دار الشرق ـــ دمشق)، يستعيد مازن يوسف صباغ ضمن مشروعه في توثيق الذاكرة السورية، وثائق نادرة تتعلّق بنشأة الدولة السورية واستقلالها عن السلطنة العثمانية (1918)، وبزوغ أول برلمان عربي تشهده المنطقة قبل أن تجهضه اتفاقية سايكس بيكو.يحكي الكتاب كيف وصل الأمير فيصل بن الحسين إلى دمشق،
ليتوّج كأوّل ملك للمملكة السورية بحدودها الطبيعية (سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن). وقد شهد المؤتمر السوري الأول (6 آذار/ مارس 1919) الذي ضمّ شخصيات من كلّ هذه «المقاطعات»، قرار إعلان الاستقلال، وتشكيل البرلمان، في ظلّ حكم دستوري نيابي ملكي، وفيما كان البرلمان السوري يعدّ دستوراً جديداً للبلاد، كانت الحكومة الفرنسية تستعد للزحف على دمشق من بيروت، إثر انسحاب الجنرال البريطاني اللنبي إلى فلسطين. ذلك أنّ مباحثات فيصل بن الحسين مع البريطانيين والفرنسيين، لم تفلح عملياً في إلغاء قرارات عصبة الأمم، «بالوصاية والانتداب والحماية»، لكن لجنة الدستور السوري، لم توقف أعمالها في إنشاء لائحة تحتوي على اثني عشر فصلاً، تتعلق بكيفية إدارة البلاد، مؤكّدة «احترام حرية الأديان والمذاهب بلا تفريق بين طائفة وأخرى»، واختيار دمشق عاصمةً لها، «بالنظر إلى وجودها وسطاً بين ساحلها وداخلها». وأقرّت اللجنة ذاتها حق الرأي والانتخاب، إضافةً إلى احترام حقوق الأقليات، على أن تقسّم المملكة السورية إلى مقاطعات مستقلة. ونقرأ في البند المتعلّق بحقوق الأفراد والجماعات: «الحرية الشخصية مصونة من كل تعدّ، ولا يجوز توقيف أحد إلا بالأسباب والأوجه التي يعينها القانون»، و«لا يجوز التعذيب وإيقاع الأذى على أحد بسبب ما»... اللافت في ما يتعلّق بقانون المطبوعات، تأكيد الدستور على أنّ «المطبوعات حرّة ضمن دائرة القانون، ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع». ونص ذاك الدستور على تأسيس مدارس كلية للعلوم والفنون العالية، تقوم بإدارتها وتوفير نفقاتها الحكومة.
بالطبع سيشعر السوري اليوم بالحسرة على دستور متطور مماثل. قبل نحو قرن، كانت سوريا على عتبة دولة مدنية، أطاحتها دساتير لاحقة، ثم أتى قانون الطوارئ مع صعود حزب البعث إلى السلطة (1963)، ليوقف عجلة الحريات تماماً.
يورد مازن صباغ في ملحق خاص أسماء أبرز الأحزاب التي كانت تعمل في البلاد مثل «حزب الاستقلال»، و«حزب العهد». أما الصحف التي كانت تصدر في سوريا، فتتجاوز العشرات، مثل «الحقائق»، و«الرأي العام»، و«الشرق».
حيال الحراك السياسي الذي شهدته سوريا الكبرى مطلع عشرينيات القرن المنصرم، سنجد أنفسنا مرغمين على ترديد: «ما أشبه اليوم بالبارحة»، إذ نكث الحلفاء بوعودهم للعرب، فما إن تنفسوا الصعداء من انتهاء حكم (الرجل العثماني المريض) حتى أُعلنت الاتفاقيات السريّة «وعد بلفور»، و«سايكس بيكو»، ثمّ «لجنة الاستفتاء» الأميركية لمعرفة رأي السوريين في نوع الوصاية التي يرغبونها بناءً على قرار عصبة الأمم. رفض السوريون أي نوع من الوصاية، وطالبوا بالاستقلال التام وعدم تجزئة البلاد، والحد من سيادة الأمة، لكنّ هذه المحاولات فشلت لتنتهي إلى اتفاق «فيصل ــــــــ كليمنصو»، الذي قضى بتعهد الحكومة الفرنسية أن تمنح معونتها وخبراتها الفنية والاستشارية لسوريا، وتضمن استقلالها وحدودها التي سيعترف لها بها مؤتمر الصلح (سان ريمو). وقبل أن يضع الأمير توقيعه مرغماً على بنود الاتفاقية، وصل طبيب الشريف حسين ومعه أمر إلى الأمير بعدم توقيع أي اتفاق يتنافى مع العهود المعطاة له من الحكومة البريطانية، فاكتفى بوضع الأحرف الأولى من اسميهما وتأجيل التوقيع لاستشارة الشعب السوري به، وعاد إلى دمشق. رأى السوريون أن هذه الاتفاقية «صكاً استعمارياً»، وقرروا المواجهة وإعلان الاستقلال وتنصيب فيصل بن الحسين ملكاً على البلاد. وقد جاء في بيان المؤتمر السوري في اجتماعه الأول أنّ «أمتنا السورية تتأهب لحياة استقلالية جديدة، لتحقيق أمانيها الحقة، وقد ارتأت وضع قانون جديد للمملكة السورية، تتخذه دستوراً ليكون سلاحاً مدنياً تتقي به الأمة صدمات السياسة الاستعمارية، وليكون برهاناً جلياً لدى العالم المتمدن على أن السوري على جانب لا يستهان به من الرقي، من غير أن يحتاج إلى وصي أو ولي يقبض على زمام أموره».
مازن صباغ سوريا قبل مئة عام