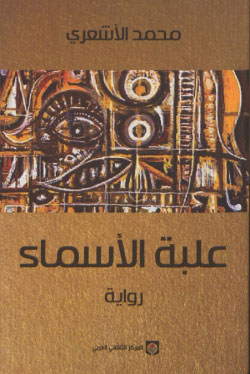من خلالها، يحفر الأشعري في الذاكرة المعمارية لمدينة الرباط ويستحضر التحولات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها هذه المدينة التي احتضنت الهجرة الموريسكية بكل من ما حملته معها من إرث ثقافي. يصحبنا عبر شخصيات الرواية إلى اقتحام أسوار بيت من بيوت هذه الحضارة الأندلسية المهددة بالتبدد والضياع أمام هذا التحول التراجيدي الذي عرفته الرباط بنمط حياة جديد وهجين. تعود بنا «علبة الأسماء» إلى زمن الثمانينيات الساخن بالأحداث. تنطلق الرواية من خلال العلاقة التي ربطت بين «ريتشارد» و»ثريا بركاش» لتغوص بنا في فضاءات الرباط وأمكنتها العتيقة. يولي الأشعري أهمية قصوى للأمكنة والفضاءات التي وظفها بغزارة. أما اختيار الأسماء، فله أيضاً رمزيته عند الأشعري. كل اسم يحمل في طياته حمولة ومساراً يتتبعه الأشعري، فشخصيتا «شيمرات» وعشيقها « بيدرو» مثلاً تمثلان مرحلة أفول الزمن الأندلسي وضياع الهوية. كما أن للموسيقى حضوراً قوياً في الرواية من خلال التوثيق الدقيق للأغنية الأندلسية عبر عرض مقاطع من الموشحات وأسماء النوبات كمن يرثي الماضي الأندلسي الذي لم يبق منه غير متن شعري يغنى في بعض الحفلات الرباطية. يمكن القول إن معظم أحداث الرواية تجرى في أمكنة مغلقة، وتتنوع الفضاءات السردية بين منزل العجوز «شيمرات»، البيت الأندلسي الذي يظل متمسكاً بالماضي الأندلسي غير آبه بالتغيرات الطارئة في المدينة، والمجال العمراني المتوسع في الرباط خارج المدينة العتيقة، ثم هناك الفضاء السجني وتحديداً سجن «لعلو» الشهير في الرباط الذي تنتهي إليه بشكل عجيب بعض شخصيات الرواية.
توثيق دقيق للأغنية الأندلسية عبر عرض مقاطع من الموشحات وأسماء النوبات
تبدو الرواية مربكة قليلاً، إذ يتهيأ للمقبل على قراءتها للوهلة الأولى أنها سهلة. لكنه سرعان ما يضيع حين يتعمق أكثر في علبة الأسماء التي تنتقل بنا بين الزمن الأندلسي المندثر في الفصل الأول (الطفل الذي تبع النوارس) وزمن الاستبداد السياسي والتعذيب في عهد الحسن الثاني الذي سيلمح إليه الأشعري في روايته باسم «الرجل المهم». ستتجلى هذه المتاهة السردية التي تتداخل فيها «العلب» تحديداً حين نصل إلى الفصل الثاني من الرواية الذي عنونه الأشعري بـ «كورال» عندما ستلتقي شخصيات لا تجمع بينها أي روابط تحت سقف سجن «لعلو» التاريخي الذي قضى فيه الروائي جزءاً من شبابه كمعتقل سياسي معارض للسلطة. لكن الفصل الثاني يبقى بعيداً من أن يصنف في خانة «أدب السجون» الكلاسيكي. علبة السجن التي لا تنفصل عن علبة الرباط الكبيرة، فهي تحفل بالحكايات والإثارة وتتضارب فيها المصائر وتتشابك مسارات الشخصيات كما تتعدد أسباب العقاب. داخل هذه العلبة العقابية المغلقة، يجتمع سجين الرأي السياسي المعتقل على خلفية فضح المقابر الجماعية في الناظور (الريف المغربي) عام 1984 والمعتقل الإسلامي والمسجونون اشتباهاً فقط. عبر تتبع خيالات السجناء وأحلامهم ومشاريعهم المؤجلة إلى ما بعد الحرية، يجعل الأشعري من السجن فضاء يمكن ابتكار حياة من داخله، فتنتصر علاقات الحب على القضبان عبر رسائل ملفوفة في علب الكبريت يتبادلها السجناء والسجينات.
الرواية علبة ضخمة من الحكايات تجعل تقديم قراءة واحدة لها أمراً شبه مستحيل. رواية شاملة في قالب نوستالجي حارق تجسد تجربة الإنسان المغربي القاسية في رحلة البحث عن الهوية. تجربة مأسوية خلاصتها إخفاق كلي على المستويين الفردي والجماعي. مرثية فجائعية تتقاطع فيها صورة المدينة الآفلة والمنقرضة والمدينة الجديدة التي حلت محلها، وتفضي هذه المدينة أو «العلبة المغلقة» إلى علبة أخرى يمثلها السجن الذي يحتضن كل هذه الكوابيس المزعجة من فقدان المغرب لأندلسيته تحت ضغط الاختناق الاقتصادي وصولاً إلى المشاعر المتضاربة التي تقلب بينها الإنسان المغربي من الطموحات، والأوهام إلى الإحباطات، والشعور بالخسارة، والألم.