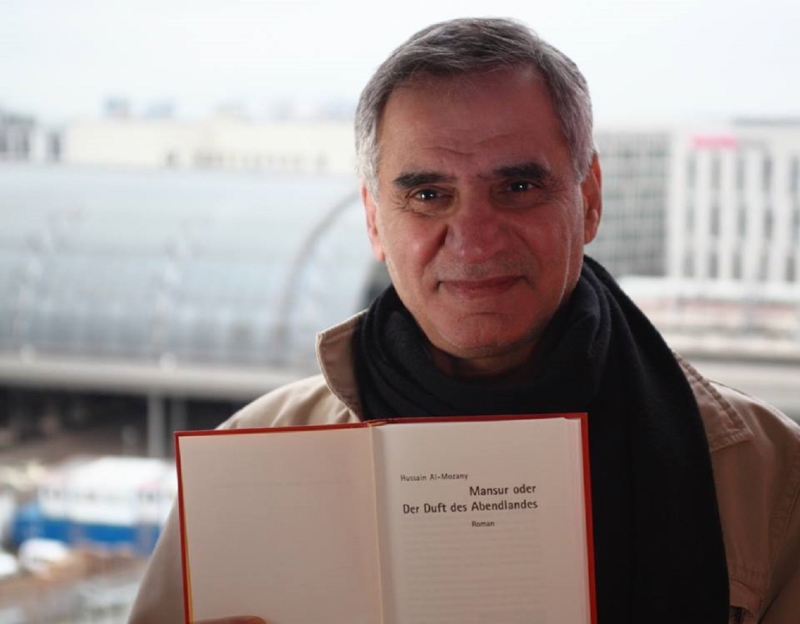حسين الموزاني
كنت قد حضرت قبل ثلاثين عاماً حلقةً دراسيةً لمناقشة كيفية توظيف الصورة في العمل الأدبي. وتناولت عدداً من الكتّاب الألمان الذين اشتهروا بدقّة الوصف الفنّي ومنهم تيودور فونتانه وفولفغانغ هلدسهايمر وتوماس مان. فكانت مهمتي في تلك الحلقة هي العثور على الصور الأصلية التي اعتمد عليها توماس مان في كتابة مسرحية الوحيدة «فيرونسا» وهو اسم بطلة المسرحية التي ترمز إلى اسم المدينة الإيطالية فلورنسا حيث بدأ عصر التنوير الأوروبي. وتتعرض المسرحية إلى نشاط الواعظ الكاثوليكي المتعصّب «سافونارولا» الذي كان مناهضاً للنهضة وفنّها. وكانت المشرفة على الحلقة الدراسية أستاذة ألمانية-إيطالية متخصصة في تاريخ الأدب والفنّ الأوروبيين. وبعدما عثرت على الصور التي استخدمها توماس مان وكتبت بحثاً حول المسرحية وقدمته لها، رفضت البحث دون تعليق. فطلبت منها مقابلةً شخصيةً لكي تشرح لي أسباب رفضها لورقتي النقدية التي استغرق إعدادها أكثر من شهرين. وحملت إليها الأدلة التي عثرت عليها بما فيها صورة بطلة المسرحية. وأثناء اللقاء قالت الأستاذة إنك أخطأت في تحديد الصورة التي اعتمد عليها توماس مان في رسم الشخصية الرئيسية. لكنّني أصررت على رأيي وقلت إنّ وصف الكاتب يتطابق تماماً مع هذه الصورة التي عثرت عليها في كتاب «ثقافة عصر التنوير في إيطاليا» لياكوب بوركهارد. فردّت عليّ بكلام قاطع ويصل إلى حدّ الاتهام بعدم معرفة أدوات البحث العلمي، لكنّه ساهم من ناحية أخرى بتغيير نظرتي إلى الأدب والفنّ بشكل حاسم. قالت: «إنني أعرف الفنّ العربي جيداً، وأنتم العرب لا تمتلكون القدرة البصرية اللازمة لرؤية العمل الفنّي وتمييز نقاط ضعفه عن قوتّه كما يفعل الأوروبيون. ولذلك فقد أخفقتم تاريخياً في فنّي النحت والرسم، وخاصةً رسم البورترية الشخصي». كان اسم السيّدة ليا ريتر - سانتيني، وعلمت فيما بعد أنها «يهودية» الديانة، ما يعني أنها ربّما تكون مطلعةً فعلاً على الفنّ الشرقي، العربي أو الإسلامي، ولذلك أصدرت حكمها. فتطلعت إليها بدهشة وأخذت أدافع عن العرب و«فنّهم التجريدي» والزخرفات والمنمنمات وما إلى ذلك، مدركاً في سرّي بأنّ رسوم يحيى الواسطي وخطوط ابن مقلة لن ترقى في واقع الحال إلى أعمال مايكل أنجلو ورفائيل وكارافاجيو ودافنشي ورمبرانت التي عنتها هذه السيّدة بملاحظتها. ولا بد من الإقرار بهذه الحقيقة، التي يمكن التوصل إليها ببساطة عبر زيارة أيّ متحف فنّي تاريخي. وبدلاً من أن تجتاحني نوبة من الغضب، أنا الشخص الانفعالي والعصبي المزاج، آنذاك، بقيت أجادلها نحو نصف ساعة، حتّى انتهى وقت المقابلة الرسمي، فخرجت محبطاً خائباً، لكنّني كنت عازماً أيضاً على فحص حيثيات حكمها والتأكّد من مدى صحته. ومنذ تلك اللحظة بدأت أقرأ الأدب والفنّ العربيين وأفكر بهما بشكل مختلف عما كان عليه الأمر في السابق، وصرت أقارنهما بالآداب والفنون الغربية حيثما وجدت مجالاً للمقارنة. فاكتشفت بأنّ الأدب العربي الحديث يكاد يخلو ليس من الحساسية البصريّة فحسب، بل من التعامل الفنّي الدقيق مع الحواس الأخرى. وشغلني هذا الأمر في موضع البحث الذي كتبته عن الروايات المبكّرة لنجيب محفوظ، وكذلك في الامتحان النهائي الذي خصص لمناقشة الأعمال الأولى لتوماس مان. وأخذت أقرأ كلّ ما تقع عليه يدي من كتب ودراسات حول تقنيات السرد وبناء العمل الروائي. وفكّرت بكتابة الدكتوراه عن «أشكال الرواية العربية الحديثة». وحصلت على منحة دراسية من «مكتب التبادل الثقافي الألماني» لمدة عام. فذهبت إلى القاهرة عام ١٩٩١، حيث أمضيت عاماً ونصف العام. فكانت تلك الإقامة بمثابة قناة النار التي لا بد من عبورها للتوصل إلى حقيقة العمل الأدبي وجوهرة. وكان المناخ الثقافي العام في مصر مشجعاً للبحث والدراسة والقراءة، فكنت أقرأ الكتب النقدية وأخوض نقاشات يومية حولها مع نخبة من الباحثين والنقّاد والأدباء في المقاهي والمؤتمرات والكليّات الأدبية.
لم تكن الرواية مجرد تطبيق آلي للتقنيات والشروط الفنيّة، إنما جاءت محاولة حثيثة لإعادة قراءة التاريخ والأحداث السياسية والتحوّلات الاجتماعية
وشعرت بأنني أصبحت مطلعاً على أسرار العمل الأدبي ونظريات الأدب وتاريخه، وبت قادراً على تعريف الرواية والتفريق الصارم بينها وبين القصّة الطويلة والقصيرة، وهو الأمر الذي يكن بسيطاً مثلما يبدو، وتعرّفت على آليات النصّ الأدبي وبناء الشخصيات وتطوّرها الذهني في مجرى الأحداث والزمن الروائي والزمن المروي والحوار والحوار الداخلي والارتجاع الفنّي وتيّار الوعي وبناء الجملة الأدبية والتمييز بينها وبين الجملة الشعرية أو التقريرية أو الصحفية.
وفي تلك الأثناء طرحت سؤالاً على نفسي وهو إذا كنت منصفاً وصادقاً وتدعي بأنّك متمكّن من أدوات التحليل الفنّي وأسرار العمل الروائي وتقنياته، فعليك أن تكتب رواية بنفسك. ثمّ تحوّل هذا السؤال إلى هاجس يومي ملحّ جعلني ابتعد شيئاً فشيئاً عن مهمّة البحث العلمي وأبدا بكتابة روايتي الأولى التي نشرت قبل عشرين عاماً بعنوان «اعترافات تاجر اللحوم».
ولم تكن الرواية مجرد تطبيق آلي لتقنيات العمل الروائي وشروطه الفنيّة مثلما فهمتها، إنما جاءت محاولة حثيثة لإعادة قراءة التاريخ والأحداث السياسية والتحوّلات الاجتماعية، وخاصةً في العراق ومصر. وحرصت بالطبع على أنّ يكون العمل أدبياً حتّى لو تناولت فيه أحداثاً سياسةً راهنة، فتصبح كلّ جملة فيه قائمةً بذاتها وتحمل معنى مستقلاً وتشكّل من ناحية ثانية سياقاً نصيّاً. وكنت محترساً تماماً من الوقوع في مغبّة الافتعال والإنشاء والاستطراد والتكرار والإسقاط والمبالغة. وأردت أن أبتكر رواية تطوّرية وتحليلية ومكتوبة من الداخل وتعتمد على الحواس بالدرجة الأولى والمدارك البشرية القادرة على التقاط أكبر قدر ممكن من الصور والمشاهد المتسارعة التي كان لها أن تأتي متوازيةً مع طبيعة تفكير بطل الرواية ومنظوره وتخرج في الوقت نفسه عن أسلوب السرد العربيّ المألوف.
وكان هناك أمر آخر شغلني تماماً وهو الشعور بأنّ العمل الأدبيّ من أشدّ الأعمال البشرية قرباً من الاحتضار والموت، وكلّ يوم يمكن أن يكون يومه الأخير مثلما كتب الشاعر الألماني هانس ماغنوس إنسنتسبيرغر ذات مرّة. فكان من الصعب عليّ أن أتحمل فكرة أن يموت عملي الأدبي، بينما أبقى أنا كاتبه حيّاً. وأصبحت الكتابة معادلاً موضوعياً لحياتي نفسها، وربّما استحالت حياتي الحقيقية إلى نصّ لا ينتهي. وبتّ صارماً مع نفسي فيما يتعلّق بالكتابة: فعليك أن تكتب نصّاً جيّداً، وإلا فلا. ويبلغنا الكتاب النمساوي روبرت موزيل بأنّ كتابة الرواية عمل أصعب بكثير من قيادة الرايخ الألماني، بل أشدّ أهميةً.
لكن هناك أمر آخر تصبح عملية الكتابة بدونه بلا قيمة ولا معنى ونعني به المنظور. فالسؤال الجوهري هو ليس ماذا تكتب وعن ماذا، وليس لمن تكتب، إنما كيف تكتب أصلاً؟! فكانت الإجابة عن هذا السؤال تقتضي إعادة النظر بالمفاهيم والقناعات السياسية والأيديولوجية التي نشأت عليها، ومنها تصوّراتي عن العالم الغربي وثقافته التي كنّا نعتبرها استعمارية وتوسعية وقائمة على النهب والاستغلال. وقد تكون هذه الآراء صحيحة على العموم، بيد أنّ هناك هامشاً واسعاً من الحريّات الفردية ومنها حرية التعبير عن الرأي في البلدان الأوروبية. وبدون استغلال عامل الحرية هذا سيكون العمل الأدبي ناقصاً لا محالة، لأنّ الحرية هي أساس الإبداع الفنّي.
وهنا سألت نفسي من جديد: هل أتيت فعلاً إلى الغرب الأوروبي لكي أحارب الإمبريالية التي كنّا نشتمها ونحاربها في بلداننا دون أن نواجهها في «عقر دارها»، أم أنّني أتيت إلى هنا لأقيم حواراً مع الآخر المختلف عنّي دينياً واجتماعياً وثقافياً؟ فتوصلت إلى صيغة جديدة في التعامل مع هذه القضايا لا تقوم على «الضد من»، إنّما على «العمل من أجل هدف ما»، بدلاً من تبديد الطاقات والجهود في اجترار الماضي وتراكماته السلبية وأحكامه المسبقة.