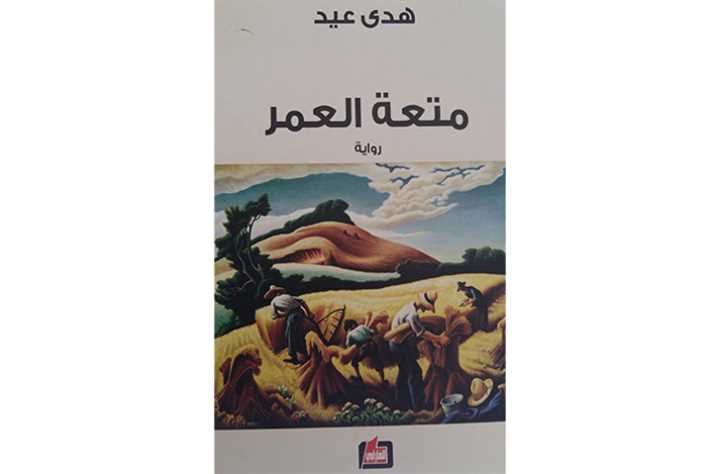القوَّة التي تواجه الموت إذاً هي طاقة نادرة في الوجود، سحر إلهي لم يدرك مخلوق سرَّه المقدَّس بعد، ما يثير سؤالاً هو: من يدرك سرَّ هذه القوة السحرية؟ في القول إشارة إلى إجابة: إنه سحرٌ إلهي، فالله سبحانه وتعالى، هو الذي يدرك سرَّ هذا السحر، وما على الإنسان إلا أن يمتلك هذا السحر ليتحوَّل بعبء الوجود المنتهي إلى الموت، إلى تجربة عيشٍ رائعة، أي إلى مخرجٍ يتمثل في أن نجد قيمةً لما نقوم به، ولا يسكننا الخواء ونحن نفكر في سرِّ الوجود، كما يقول أدهم. وهو كما يقول جدّه حمية له: أنت أدهم تحمل اسم فارس أصيل، ستكون مثله شهماً نبيلاً ومقاتلاً في سبيل حياة أجمل من التي نحيا. وإذ نقرأ الرِّواية، يبدو واضحاً أنَّها تثير أسئلةً، بدا لنا أن العنوان يثير واحداً منها، من هذه الأسئلة: ما الذي يجعل العيش محتملاً؟ ما الذي يجعل العيش ممتعاً؟ هل يمكن أن يكون العيش ممتعاً؟ وكيف؟
يتبيَّن قارئ الرواية إجابات ملموسة عن هذه الأسئلة، أي أنَّ بنية الرواية تنطق بهذه الإجابات من دون تدخُّلٍ من الرَّاوي. إن الرَّاوي، وهو ليس المؤلِّف، وإنما عنصر من عناصر البنية الروائية يوكل إليه الروائي أداء القصِّ وبثه. الراوي، في هذه الرواية، يسرد ويصف، ويتيح للشخصيات أن تحدِّث ذاتها، وأن تتحاور، ويشكل من هذا كله جديلة روائية تنطق برؤيتها، وما على القارئ سوى أن يتبيَّن الدلالة، في مناخ/ فضاء المتعة الروائية، وتبيُّنه الدلالة هو نوع من التأويل الذي يمكن أن يتعدَّد بتعدُّد القرَّاء المؤوِّلين. والنَّصّ الجيد هو النَّص الذي تتعدَّد تأويلاته في مسار قراءات غير متناهية، ما يعني أن القرَّاء المؤوّلين هم منتجون للنَّص من جديد، وكلٌّ من منظوره، وما قراءتي هذه إلا واحدة من القراءات لهذه الرواية التي ستتعدد قراءاتها وتأويلاتها بتعدد قرَّائها القادرين على التأويل، وعلى وصف الدَّال، بغية تبيُّن سرِّ المدلول. بغية بيان ذلك، نرى أنَّ أدهم يتمرَّد، عندما يشعر بأنَّه متروكٌ من أبويه اللذين انفصلا، وعندما يدرك أن أباه يربكه منذ كان طفلاً بسبب زوجته الصغيرة. تصف معلمة اللغة العربية تمرُّده، بقولها له: «ماذا تعتقد أنك فاعل؟ هل أنت راضٍ عما انتهيت إليه؟ في كل يوم مشكلة؟ وفي كل يوم عِراك، بِتَّ أحدوثة المدرسة، بل أنت كذلك منذ وقت طويل؟ هل تدرك ذلك أيها الفتى الـ...؟». لا تكمل لأنها لم تجد اللقب الدائم، وهو يتمرَّد كما يقول، ليرفض ما هو عليه، وليصبح ما يصبو إليه في أعماق أعماقه، ويضيف ربما حدث ذلك «عندما التقيت حبيبتي الجميلة ياسمينة». ترتسم هنا ثنائية طرفها الأول ترك الأهل له، وغدوِّهم مشكلته المفضية إلى أن يغدو أحدوثة المدرسة، وطرفها الثاني حب ياسمينة المفضي إلى أن يصبو من أعماق أعماقه إلى أن يكون جديراً بها وبهذا الحب.
يبدو واضحاً أن تمرُّده يهدف، بداية، إلى تحقيق ذاته وإثارة اهتمام حبيبته وإعجابها به، وحبَّها له. وإذ يتحقق ذلك وتبادله ياسمينة الحب يعيش متعة العمر، ويتغيَّر. ويرى المدير، بعدما نجح في الامتحانين المدرسي والرسمي، أنه قد صار أنموذجاً للإرادة والعزيمة اللتين يجب أن يتحلى بهما كل الطلاب. وكان قبل ذلك يفكِّر في لاجدوى الحياة بلا حب، بعبثية أن يكون ظلاً هزيلاً بائساً، لا يقوى على فعل ما يريد، وبأن النجاح يتمثل في استعادة حياة سُرقت منه في غفلة لئيمة. ما يجعل الحياة ذات جدوى وغير عبثية، إذاً، كما يرى أدهم، هو الحب، وأن يقوى الإنسان على فعل ما يريد، أي التمتُّع بحرية السعي إلى تحقيق الذات في فضاء الحب.
الجدُّ مصطفى، جدُّ أدهم لأبيه، يعيش سعيداً، ما دام يمتلك الأرض ويجعلها معطاء، في سعيه الدَّائم إلى العطاء، وإذ يفقد بستانه، ويشاهد فقد أناسٍ لإنسانيَّتهم يصاب بالشَّلل، ثم يموت... إنَّ الفقد هو ما عجَّل بموت مصطفى الجدِّ، ولنتعرَّف إلى المشهد الذي يمثل هذا الفقد: «مسلح ملثَّم يقطع رأساً، ثم يرفعه في الهواء بفرحٍ سخيٍّ، والدِّماء تقطر منه بغزارة». يقول الجدّ لحفيده: «انظر، انظر إلى ذئاب التاريخ، وإلى ما يفعلونه بالبشر!». عندما يفقد الإنسان إنسانيته، ويتحوَّل إلى ذئب، أو يمسخه التخلُّف إلى ذئب، يغدو وباءً يصيب الإنسان المتحضِّر بالشلل نتيجة الرفض للعيش مع هكذا كائنات.
واللافت أن رامي الذي غدا واحداً من هؤلاء الذِّئاب، يقول: إنَّ هؤلاء هم أصحاب قضيَّة، ويسأل أدهم: وجدُّك ما هي قضيُّته؟ فيجد القارئ نفسه إزاء قضيَّتين متضَّادتين: أولاهما التوحُّش/ القتل وثانيتهما التحضُّر، الحياة.
الجدُّ حميَّة، جدُّ أدهم لأمِّه، هو الأسطورة الحيَّة التي تتباهى بها بلدة مارون الراس، وهو من سمَّاه أدهم على اسم البطل الوطني العاملي الثائر أدهم خنجر. يفاخر حميَّة، واسمه دالٌّ على الحميَّة، بأن ابنه علياً استشهد في سبيل الوطن دفاعاً عن الأرض التي يعشقها ويحبها، كما يعشقها أبوه ويحبها، وانتقاماً لأمه أول شهيدة عرفتها البلدة. يبقى حمية في قريته ويقاوم. ويحيي أرضه ويحميها.
سرد مشوِّق يمضي في تقديم الحاضر واسترجاع الماضيين البعيد والقريب
إن الأرض/ الوطن هي قضيَّة حمية، ومتعة عمره تتمثل في إخصابها وحمايتها، وجعلها معطاء، وحسن بن حمية، يشعر، وهو يواصل تحقيق نجاحه في أميركا، بأنه يعيش في منفى. يقول: بيروت الجميلة سكنتني وبيروت المعذَّبة قهرتني، وبينهما منفى أسكنه في كثير من الوقت. السؤال الذي يُطرح هنا هو: من يجعل بيروت غير معذَّبة وسعيدة، إن كان أبناء الوطن يحققون نجاحاتهم في المنفى؟ ومن المسؤول عن هذه العذابات المفضية بالناجحين إلى المنافي؟
وأبو أدهم يجد متعة عمره في النِّساء. «جنة الدُّنيا هنَّ» هكذا كان يصفهن في ساعات التجلِّي. ويرى أدهم أن المرأة بالنسبة إلى أبيه صارت خطاً دفاعياً أخيراً أمام الحياة التي هزمته، والتهمت كل أحلامه، وسيلة تعويضه الوحيدة... وإذ يشعر بأن المرأة مستحيلة الامتلاك، وبأنها هزيمته الحقيقية، بوصفها هزيمة أمام الحياة وليس أمام الموت، يصبح مزواجاً، لكن زوجته الشابة تسعى إلى نيل جنَّتها هي، وتتمثَّل في الفتى الجميل القوي، الذي يعوِّض لها الفقد المتأتي من زواجها برجل عمره عمر والدها. وتغدو الجنَّة لكل منهما جحيماً، إذ إنها كانت تفتقر إلى الحب، وتخلو منه.
وهكذا، كما يبدو، تتعدَّد الدروب إلى امتلاك سرِّ الوجود، ويكون لكلٍّ جنَّته في هذه الدنيا، وإذ يفقدها يفقد الحياة السعيدة، أو الحياة. الجنان جميعها تفضي إلى تحقيق ما يجعل العيش محتملاً وممكناً، وممتعاً، بالحب، بجنى الأرض بحماية الوطن، بالجنس الآخر، هذه الدروب جميعها تفضي إلى الامتلاك، وإذ يتعذَّر الامتلاك يحدث الفقد، والعجز عن تعويضه، وهل يطاق عيش العجز!؟ هذا هو قدر الإنسان، في هذه الدنيا، يتمثَّل في أن يسعى إلى امتلاك ما يحقق ذاته، ويوفِّر متعة عمره. يتبيَّن القارئ هذه الرُّؤية/ الإجابات في فضاء المتعة الرِّوائية التي توفِّرها بنية روائية، يشكلها الراوي/ الشخصية الرئيسة، أدهم، ويرويها بضمير المتكلِّم، فيمضى في سياق خيطي يبدأ من اللحظة/ الأزمة، من مرض شيرين، زوجة الأب الشابة، كما ادعى الأب، ثم نعلم أنها لم تكن مريضة، وإنما ضبطها الأب مع فتى في شقة له...
ينمو السياق الروائي خيطياً، متكسِّراً بالاسترجاع، وتتداخل الأزمنة في غير موضع، ما يجعلنا نرى أن هذه البنية الرِّوائية يشكلها نسيج روائي تتنوَّع خيوطه بين سرد مشوِّق يمضي كما قلنا في تقديم الحاضر واسترجاع الماضيين البعيد والقريب واستباق الآتي، ووصف دال، وحوار ذاتي وثنائي رشيق يلائم الموقف والشخصية، وإشارات كاشفة يرسلها الراوي في حالات تقتضيها، ما يشكل بنية روائية تمتع وهي تروي سيرة سعي الإنسان إلى امتلاك متعة العمر.