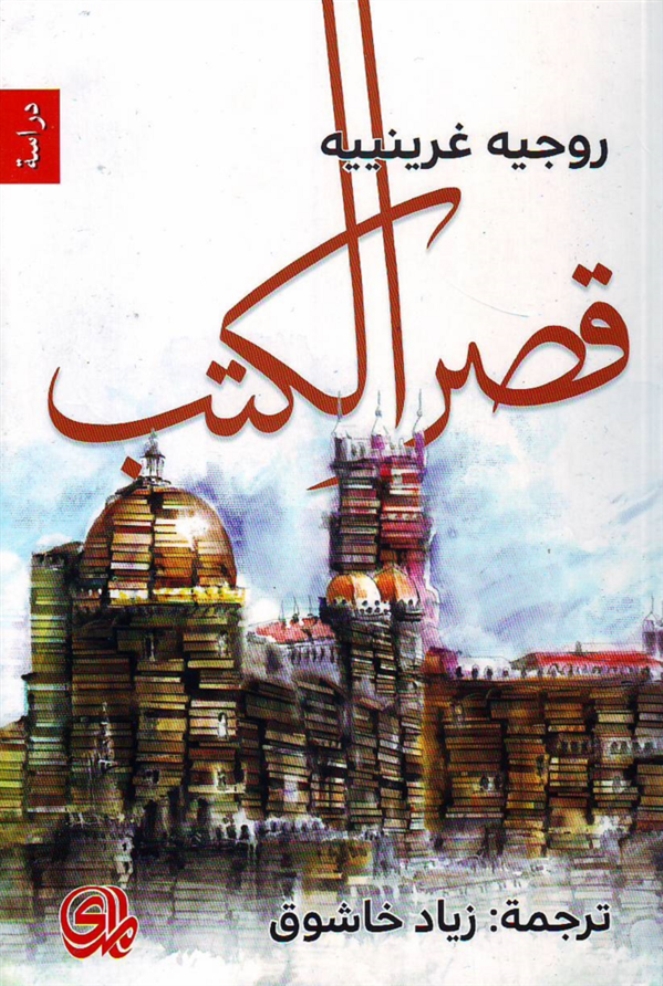
يضع روجيه غرونييه مفردة ما تحت مجهره، ثم يضيئها موشورياً، لتتدحرج من الفردوس الأدبي نحو الواقع اليومي بكل خشونته. هكذا يقرأ «الانتظار» كما ورد لدى الكتّاب، وصورته في الواقع، إذ خلق الطبيب والمعالج الفيزيائي والمؤسسة الرسمية معنى آخر لغرفة الانتظار، وجعلوا منها «المكان الذي بين الضجر والقلق وفراغ الصبر»، فيما يجد في أوديسة هوميروس قصيدة كاملة عن الانتظار. في تفكيك مفردة «الرحيل»، يذهب بعيداً في الاستعارة، وإذا بها تتخذ صفة الانتحار، بإشارات من بودلير وبافيزي ومالارميه وهمنغواي وفلوبير، مختتماً معنى الانتحار بضرورة الصمت كحق أساسي من حقوق البشر.
ولكن هل تُعتبر معرفة الحياة الخاصة لكاتبٍ ما هامة لفهم أعماله؟ يستشهد هنا، بمارسيل بروست أولاً: «بمَ يفيدنا أن نكون من أصدقاء ستندال في الحكم عليه بشكلٍ أفضل؟ بل على العكس، من المحتمل أن هذا قد يشكّل عائقاً كبيراً في سبيل ذلك». ورغم إعجابه ببلزاك، فإنه يراه رجلاً سوقيّاً، فيما يصف لوسيان دوديه، بروست نفسه، بأنه «حشرة مقيتة». أما فلوبير فيقول: «أعتقد أن ليس على الكاتب أن يترك أثراً عنه إلا أعماله، فحياته ليست على قدر كبير من الأهمية. وبئساً للتفاهات». ويؤكد روجيه غرونييه على ضرورة الكشف عن شخصية الكاتب في نصوصه، وملاحقة «ضمير المتكلّم» لاصطياد الحياة الداخلية الأكثر حميمية للمؤلف. فالذاكرة ليست مجرد آلة تسجيل، وفي المقابل، قد يكون ضمير المتكلم مجرد ذريعة سردية لإغواء القارئ («الغريب» لألبير كامو)، وفي «العاشق»، ادعت مارغريت دوراس بأنها تروي قصتها الحقيقية، لإبهار القرّاء، في حين أنه لم يكن فيها أي شيء حقيقي. ويلفت إلى معضلة أخرى تتعلّق بحياة الآخرين، واتكاء بعض الكتّاب على عبارة «كل تشابه مع أشخاص...» للهرب من اتهامهم بانتهاك أسرار شخصية ما. ففي دفاعه عن مصادر روايته «البحث عن الزمن الضائع»، يوضح مارسيل بروست «أن الإساءة إلى الحياة الخاصة لا تُرتكب عن خبث أو مكر، وإنما من أجل اكتشاف الحقيقة العامة للحياة تحت سلوك فردي». ويضيف في رسالة إلى «دار غاليمار»: «كتبت لي امرأة كنت أحببتها منذ ثلاثين عاماً رسالة غاضبة لتقول لي إن «أوديت» ليست سواها بالذات، وإنني وحش بغيض». في كتابة الحب أيضاً، يتابع الناقد الفرنسي قراءة الحياة الحميمية الخاصة، وقصص الغراميات التي تتأرجح غالباً بين الوقائع والإلهام الأدبي. يعترف تشيخوف في قصته «السهوب» قائلاً: «إن قصّة قصيرة تخلو من النساء، ليست سوى آلة دون بخار». لكن ألبير كامو سيكتب «الطاعون» عن نساء غائبات، فـ «الكلام عن الفراق ليس سوى طريقة مختلفة للكتابة عن الحب».
يجد في أوديسة هوميروس قصيدة كاملة عن الانتظار
وستختلف النظرة إلى كتابة الحب، تبعاً لفلسفة العصر: «اليوم، وفي العديد من الروايات، لا يُكتب الحب، بل يُكتب كيف يُمارس الحب. ويبدو لي أن في مثل هذا النوع من الوصف تمضي النساء إلى أبعد مما يمضي الرجال» يقول. هناك وقفة أخرى تتعلّق بالروايات غير المكتملة، كنتيجة لموت مؤلفها أو طيشه. هكذا أهمل كافكا إتمام روايته «القصر»، وقد شبّه نفسه برجل لديه منزل خرب، مصنوع من ذكرياته، فراح يستخدم ذلك المنزل من أجل أخذ بعض المواد الأوليّة لبناء منزل آخر، إلا أن قواه خانته في منتصف عمله بحيث وجد أمامه بيتاً نصف مهدّم وبيتاً آخر غير مكتمل، فيما أهمل بعض الروائيين إتمام رواية ما، خشية الرقابة، أو أجّلوا نشرها، أو ماتوا قبل الانتهاء من كتابتها «في طريق جبلي يشرع كلب غريب بملاحقتك، ثم فجأة يعود أدراجه. لم تعد ذا أهمية بالنسبة له» يقول. في فضاء آخر يتساءل: «هل يكون عمل الكاتب، عملاً أخيراً في نظره هو، أم في نظر الآخرين؟» ويجيب: «قليلون جداً هم أولئك الذين وضعوا نقطة النهاية لإبداعهم عن سابق قصد وتصميم». من أولئك وليم فولكنر الذي اعترف «أعرف أنني أقترب من النهاية، من قعر البرميل». بالطبع، لن ننتظر اعترافاً مشابهاً من كاتب عربي، فكل ما يكتبه، يقع في باب النفائس!


