في روايتك الجديدة «صيف مع العدو»، تؤرخين لمئة عام من تاريخ مدينتك الرقة، كأنك تستدعين عزلتها على غرار ما فعله ماركيز في «مائة عام من العزلة»؟
- أعود بالرقّة في «صيف مع العدوّ» إلى خمسينيّات القرن العشرين. إذ تأتي «كرمة» من مسارح حيفا وبيروت والإسكندريّة، حيث كانت راقصة في فرقة بديعة مصابني الاستعراضيّة، لتتزوّج بإقطاعيّ من الرقّة هو الآغا إبراهيم، ولتكوّن عائلة وتصير جزءاً من المكان وحكاياته. لكنّ المرحلة الأكثر تبئيراً في السرد هي حقبة الثمانينيّات، حيث طفولة «لميس» التي تحكي يوميّاتها مع عائلتها ومع أبناء مدينتها، وتظهر تفاصيل حياة المجتمع السوري، ونعرف منها حكايات مجهولة عن النساء المعذّبات بالعشق والخيانة والاعتقالات السياسيّة. حاولت أن أتلمّس روح الرقّة الأصيلة التي عرفتها، أو توهّمت أنّني أعرفها، أو أحببت أن تكون كذلك. تمرّ الرواية أيضاً بتاريخ بعيد للرقّة عبر شخصيّة نيكولاس الألماني الذي جاء ليتتبّع خطوات عالم الفلك الرقّي الصابئيّ المعروف باسم البتّانيّ.
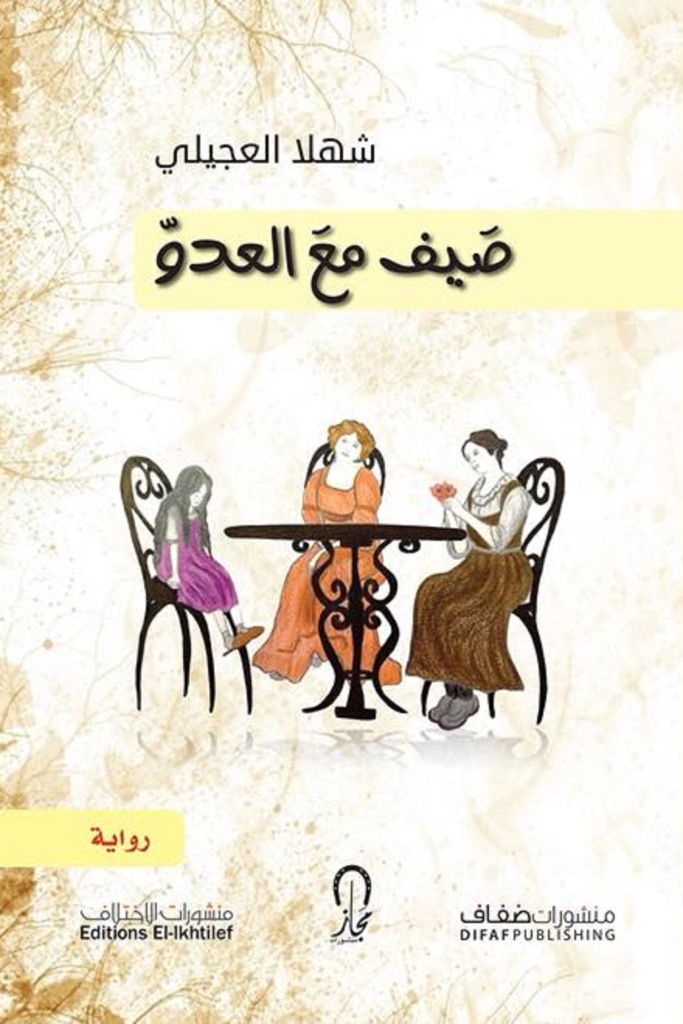
أحبّ المتلقّون المكان على الرغم ممّا يكتنفه من حزن، وقسوة، ومصائر تراجيديّة، حتّى إنّ قارئة كتبت لي بأنّها تمنّت بشدّة لو أنّها انتمت إلى الرقّة، وعاشت بين أولئك النساء والرجال والبيوت والطرقات، وأنها تذهب إلى الإنترنت تطارد الصور القديمة للمدينة. أنا في الحقيقة فاجأتني تلك الصورة الرومانسيّة التي تكوّنت لديها بسبب الرواية! قلت لها إنّها ربّما لو عاشت معنا أسبوعاً حتّى في ذلك الزمان الذي سبق الحرب، فلن يكون ذلك رأيها أبداً، فالرقّة كانت دائماً مهمّشة ومعزولة، ومقتّراً عليها بالاهتمام من قبل الحكومة! لم تكن الرقّة في «صيف مع العدوّ» خليجاً معزولاً، ليس كما فعل ماركيز في «مئة عام من العزلة»، فكلّ من العلاقات ضمن المكان وطريقة الحياة فيه، من وجهة نظري، لا يسمح بصناعة رواية فيها دراما عالية مثل «صيف مع العدوّ». لننتبه إلى أنّ ماركيز استخدم واقعيّة سحريّة لينجو بمكانه الصغير، في حين أنّني استخدمت الواقعيّة النقديّة، التي تتجلّى في المقارنات والحكايات والمفارقة والتحوّلات. لذلك وصلتها بمحطّات العالم المدهشة عبر تاريخ الشخصيّات وحركتها، فحضرت الرقّة هذه المدينة البسيطة إلى جانب دانزيغ التي كانت نقطة انطلاق الحرب العالميّة الثانية، والقسطنطينيّة، وبيت لحم، وكولونيا، وذلك لأتمكّن من تحريك الشخصيّات وإثرائها، ومن صناعة المفارقات ورفع حدّة الدراما.
هل لكل روائي «ماكوندو» التي عليه اختراعها، أو إعادة تخيّلها؟
- لا بدّ من وجودها. لا مكان وقائعيّاً في الرواية، كلّ مكان هو تصوّر أو انزياح، مبنيّ على علاقات معقّدة نفسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة... هذا ما يجعله متجدّداً ويمنعني من أن أكون رهينة له، حتّى لو امتلك اسماً ثابتاً، «الرقّة» مثلاً. مع ذلك فقد اشتغلت على جغرافيّات عدّة. في روايتي الأولى «عين الهرّ» 2006، بدأت بحلب، بحاراتها القديمة وأحيائها الجديدة، وبطبقاتها الاجتماعيّة الاقتصاديّة، وبحرفييها وصناعاتها، وتعدّداتها اللغويّة، وروح التصوّف فيها. حلب تستطيع أن تقوم على أكتافها رواية كبيرة، وأنا عشت فيها ربّما أكثر مما عشت في الرقّة، حتّى إنّها في الحقيقة مسقط رأسي. قد تكون «ماكوندو» التي تقصدها، هي «الرقّة» التي صنعتها واستغرقت فيها، في روايتي الثانية «سجّاد عجميّ». إذ كانت فضاء روائيّاً صافياً تقريباً، أي بلا جغرافيّات منازعة، استطاعت أن تكون عالماً قائماً بذاته، لكن لنلاحظ أنّها كانت مركزاً في تلك الحقبة التاريخيّة، أواخر القرن الثالث الهجريّ، بما يحمله المركز من تعدّد وعلاقات معقّدة، من غير أن نخالف فيه منطق التاريخ، إذ اشتغلت هناك على الواقعيّة التاريخيّة. أعتقد أنّ التحدّي الأكبر هو في تحويل الرقّة المدينة المهمّشة وقائعيّاً إلى مركز في النصّ. لا شكّ في أنّ الخيال يستطيع فعل ذلك، ولكن أيّ خيال سيجعلها تضارع القاهرة أو دمشق أو طوكيو مثلاً، وبشرط ألاّ يكون ذلك على طريقة ماركيز أيضاً! لم أرد رواية ريفيّة تموت بمحدوديّة المكان واللهجة والواحديّة، ولا رواية جاذبة عن طريق علاقات حبّ وشهوة على شاطئ نهر. الرواية بالنسبة لي تعدّد، وطبقات، وحياة، وصخب في مكان ليس بمتعدّد وليس فيه دراما طبقيّة بمعنى الفهم الواقعيّ، ويفتقد إلى الصخب. لا أعني بذلك أنّ الروائيّ لا يستطيع أن يكتب رواية في زنزانة، أو في غرفة، وعن علاقته بطاولة مثلاً أو مفتاح! هذا يحتاج إلى ظرف آخر لأكتب رواية أسمّيها مينماليّة، ولعلّها روايتي القادمة! أنا أحتاج إلى أن أكوّن هذا العالم الملحميّ الآن، فحين يغيب المكان، ويُدمّر البيت، والمدرسة، والمقبرة، ويقتل الناس الذين من لحمنا ودمنا، ويغيبون تحت الردم أو في السجون، ويحدث تحوّل مأساويّ في الهويّة، وفي مفاهيم رئيسة كالوطن، والدولة، والإنسانيّة... نحتاج إلى طروادة لا إلى ماكوندو. نحتاج إلى إلياذة، وفعلاً لم تفارقني صور هوميروس منذ 2012.
تقاربين تاريخ الرقة في كل رواياتك بتواريخ مختلفة، هل المكان الأول هو لعنة الروائي وغنيمته السردية الثمينة؟
- ما زلت أتعامل معه بوصفه غنيمة، ودائماً كنت أقول لا بدّ للروائيّ من رواية المكان الأوّل. لم يكن مخطّطاً أن أتابع في مسألة استحضار الرقّة بهذا الزخم لولا الظرف التاريخيّ الصعب الذي مرّ بنا، أو بي شخصيّاً، ولولا التحوّلات القاسية التي صنعت من الرقّة نقطة استقطاب، فالرواية تحبّ لحظات التحوّل. نعرف في تاريخ الأدب الكثير من الروائيين الذين ارتبطت أسماؤهم بالمكان الذي انتموا إليه: علاقة بلزاك بباريس، وعلاقة جاك لندن بأوكلاند، وشتاينبك بمونتراي، ومحمّد شكري بطنجة، وإبراهيم عبد المجيد بالإسكندريّة... حتّى الكتاب المهاجرون بقيت علاقتهم بمكانهم الأول مصدراً لفضاءات روائيّة: كافكا وكونديرا وبيكيت... لكن اعتقدت أنّني في «سجّاد عجميّ»، سأفرغ من المكان الأوّل الذي تكلّمت عليه، أو لنقل سأشفى من الولاء، بدأت بالكتابة المواظبة في 2010، ونشرت في 2012، وكانت الرواية إرهاصاً بما سيحدث للأسف. حدثت بعدها تلك التحوّلات القاسية، وصارت الرقة عاصمة الدولة الإسلاميّة، وصار الوصول إلى البيت ضرباً من المستحيل، فكانت «سماء قريبة من بيتنا». كأنّ حركة التاريخ تصنع لي تلك التعويذات المضادّة للعنة المكان الأوّل كما سمّيتَها. إذ تحقّقت لي المسافة الجماليّة، وهي ما أحتاجه دائماً للكتابة، والتي بوساطتها بدا المجهول والمغيّب من البيت الذي في الرقّة، وليس من المدينة، بإمكانيّات هائلة، وكان مستعدّاً بل محتاجاً ليكون مادّة للكتابة، حضرت في النصّ عناصر كثيرة من تلك التي حكى عنها باشلار: الجوارير، والأقبية، والأدراج، والعليّات، وحتّى بيوت الحلزون، فأعطى زخماً عوّض عن زخم مدينة عامرة، وصار رمزاً كنائيّاً للرقّة حتّى أنّ صحيفة الـ«غارديان» البريطانية عنونت مقالها عن نصوص القائمة القصيرة لـ «بوكر 2015» بـ«سماء قريبة من بيتنا تعيد الرقة إلى الحياة»، ووضعت صورة من السوق القديم في الشارع الموازي لبيتي، حيث ساعة المدينة، ودكاكين العطّارين، وعربات بائعي الخضار!
صارت الرقة عاصمة «الدولة الإسلاميّة»، وصار الوصول إلى البيت ضرباً من المستحيل، فكانت روايتي «سماء قريبة من بيتنا»
معك حقّ بالنسبة لموضوع لعنة المكان. خفت في مرحلة من المراحل من ذلك الفخّ، أي أن أستنفد الأمكنة، مع أنّني عشت في أماكن كثيرة، لكن طالما تعاملت مع كلّ مكان كتبت عنه بحريّة مطلقة، بل بذاتيّة، ذاتيّة روائيّة طبعاً، فعلت بالأمكنة ما أريد، استخرجت منها جماليّات جديدة، على مستوى الجميل والمشوّه والجليل والمقدّس. وبعد ما حدث، تحرّرت تماماً من قيود الحنين والولاء بالمعنى الشائع الذي يكابده الآخرون. حين أفكّر بما حدث فعليّاً لبيتي ولغرفتي ولمكتبتي وألبومات صوري وشهاداتي وألعابي... وبأولئك الأغراب الذين دخلوا بأسلحتهم، وعاشوا فيها، ولغّموها، لكنت جننت حقّاً. ثمّ أفكّر في الآخرين الذين لا أعرفهم، والذين لجؤوا إلى بيتي بعد خروج عائلتي منه، ليحموا أنفسهم من الموت، فأتساءل: لماذا نحتكر الأمكنة؟ لماذا ننفق عمرنا نبني البيوت، ونغلقها بالمفاتيح، ونتشاجر من أجل غرفة خاصّة أو سرير خاصّ، إذا كانت ستصير مباحة لآخرين! كتبت مشهداً في «صيف مع العدوّ» عن المبيت في بيوت غريبة نزح أهلها، وعن أمتعة وأملاك لأشخاص آخرين غائبين، ثمّ فضّلت حذفه، كان قاسياً بشكل ثقيل على الرواية.
هناك ما يمكن أن نسميه «احتجاجات مرنة» على ما أصاب الرقة من كوارث ونكبات وأوجاع، وتالياً، اللجوء إلى نوع من القدرية في معالجة هذا الجرح المفتوح. هذا ما نجده في «سماء قريبة من بيتنا» إلى حدّ ما.
- أعتقد أنّها عبارة مجحفة أن نسمّي التحولات القاسية التي عاشتها شخصيّات «سماء قريبة من بيتنا» باحتجاجات مرنة. لقد كانوا يعيشون في عالمهم الذي هو الرواية، وهي ليست مظاهرة، ولا اعتصاماً، ولا يجلس أفراده في مقهى في دمشق أو في براغ، ليراقبوا ما يحدث لهم على شاشة تلفزيون ويتناقشون حول مضاربات السياسة. أبطال «سماء قريبة من بيتنا» بشر متروكون في التيه، إذ لم يتمكّنوا من مواجهة القوم الجبّارين، وليس بإمكانهم سوى أن يقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: ادعُ لنا ربك... هذا هو الاستسلام المستفزّ الذي صوّرته الرواية، هي صورة أيقونيّة لمجتمع بتحولاته المتعدّدة منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى 2014، نتابعها عبر ما جرى لعائلة ممتدّة فيها المتناقضات الإيديولوجيّة الاجتماعيّة كلّها. كنّا بحاجة لتنكشف تحوّلات قرنين، إلى حدث مفصليّ كأن تصير الرقّة عاصمة للدولة الإسلاميّة، وأن تدمّر بوصف هذه العاصمة حقيقة واقعة، فيتمّ التعامل معها كأرض مشاع (No man’s land)، تنسحب الدولة، ويهزم الجيش، ويقصفها طيران التحالف، وتتنازعها داعش وقسد، وذلك كلّه في قلب دولة قائمة هي سوريا، وعليّ أن أحكمه بالشرط الروائيّ لا بالوقائعيّة!
ينظر الآخرون إلى الرقة على أنها حاضرة بدوية على ضفاف الفرات، فيما تنبشين في «صيف مع العدو» تاريخاً آخر مختلفاً، ما هي مرجعياتك عن هذه المدينة التي جعلها «تنظيم الدولة الإسلامية» عاصمة له، وما تأثير وجود هؤلاء البرابرة على سلوك شخصيات الرواية؟
- يمكن أن أقول إنّني منذ أن كوّنت وعياً نقديّاً عبر التجربة والدرس الأكاديميّ تحديداً، صرت أتعامل مع المكان ومع الظواهر والأفراد، بما فيهم أمي وأبي، بفرديّة، أي أعزلهم عنّي لأعيد اكتشافهم بوصفهم موضوعات. هذا يفيد كثيراً في التعامل بعدل، إذ لا نحمّل الأشياء أو الآخرين ما فوق طاقتهم، ويفيد كثيراً في الصنعة الروائيّة، إذ يمنح حريّة وموضوعيّة ويصنع رؤية ناقدة. في «صيف مع العدو»، ربطت الرقّة عبر حركة الشخصيات بأوروبا الشرقيّة في الثمانينيّات، وهذا تاريخ عشته بتفاصيله هناك. كان بإمكان المرء أن يسافر برّاً من الرقة إلى تركيا، وبلغاريا، ورومانيا، ويوغسلافيا، وتشيكوسلوفاكيا، وبولونيا، وهنكاريا. وهناك درس كثيرون أيام الانفتاح على المعسكر الاشتراكيّ. كنت دائماً منكبّة على تاريخ المكان، وعلى قراءة المراجع وكتب التاريخ والأدب. تأثّرت أيضاً بأبي، فهو معماريّ ومرمم للمدن الأثريّة، واشتغل على سور الرقّة القديم وباب بغداد. يقع متحف الرقّة الأثريّ في الحيّ الذي نسكن فيه، وكنت أذهب إليه ليس في زيارة سياحيّة، بل كما أذهب إلى بيت عمّي أو إلى بيت الجيران. لا بدّ من أن أذكر أنّ مقابل البيت أيضاً ثمّة متحف أثريّ وفنيّ فردي للأستاذ طه الطه، إحدى الشخصيّات الرقيّة التي كرّست حياتها للتعريف بالمدينة وتراثها، ويستضيف السيّاح والمهتمّين الذين جاؤوا من كلّ بقاع العالم، وربّما خرجوا من ذلك القبو وجلسوا إلى جواري على عتبة باب البيت، أو تناولوا قهوتهم معنا. أيضاً عاصرت في طفولتي بعثات التنقيب الأثريّة في الرقّة، وتابعت تحقيقاتها وأعمالها. اشتغلت في «صيف مع العدو» على البتّاني، ومدوّنته الفلكيّة، وكنت قبل ذلك أعرفه مثلما يعرف كلّ مواطن الشخصيّة التاريخيّة التي عرفت بها مدينته الأمّ. ولعلّ معرفة الطبائع وحركة البشر تأتي من الإنصات التاريخيّ لإيقاعات الثقافة غير العالمة: الحكايات والموسيقى والأمثال وردود الأفعال... لكن من أجل «صيف مع العدوّ»، درست صفاً في علم الفلك في مؤسّسة أكاديميّة في عمّان تجري فيها بحوث بالتعاون بين الجامعة الأردنيّة وجامعة «هارفارد». ولتحفيز الصورة أيضاً درست سنة في صفّ للنقد السينمائيّ في الهيئة الملكيّة الأردنيّة للأفلام. حين يقرّر الإنسان أن يبحث سيجد الدروب، عليه فقط أن يمشي فيها بهمّة! بالنسبة لمرحلة دخول تنظيم الدولة، أو دخول البرابرة كما سمّيتَه، فـ «صيف مع العدوّ»، لم تعالج من وجود التنظيم سوى مشهد رحيل آخر مجموعة من أهل الرقّة عنها، لحظة المواجهات الأخيرة لخروج داعش ودخول قسد، لنجد شخصيات من الرقّة أو ممّن عاش فيها، وقد وصلت إلى كولونيا الألمانيّة محمّلة بذكرياتها، لتحكي لنا لميس أو لولو، الناجية من المواجهات الأخيرة، الحكاية على طريقة هاملت وهوراشيو.
تعتنين في أعمالك بالمحكيات المحلية، أين ينتهي المحكي ومتى يبدأ السرد؟
- ليس كلّ محكيّ مناسباً ليكون عنصراً روائيّاً. المحكيّ أيضاً فخّ يقع فيه بعض الروائيين. أنا أبحث عن الخاص الذي يحمل روح العام، فالانتقاء من الموروث أو من الثقافة المحليّة مهم كي لا يكون هناك إغراق. تبدو هنا أيضاً قدرة الروائي على مكافحة أهوائه، فالأشياء الحميمة بالنسبة لك قد تكون مملّة أو مستهجنة من قبل الآخرين، كالكلمات والمواقف والحكايات... ما يضحكك أو يثير قرفك قد يكون غامضاً للآخرين، أو حياديّاً، أو لا يحمل الوقع ذاته الذي عليك. لعلّ مسألة الثقافة والخصوصيّة تكمن في استصلاح ما يحمل روح العام، فيضيف الشعريّة المطلوبة. الإطار الفنيّ أو خواصّ النوع تحكم كلّ شيء في الكتابة، نحن نكتب رواية، وليس كتاباً في المأثورات الشعبيّة، لكن هذه الرواية يجب أن تحمل روح العالم الذي تمثّله، وتتحدّث عنه، لا عالم الروائيّ بل عالم الرواية.
تذكرين في «سماء قريبة» العبارة التالية: «المدن الجميلة صارت لا مرئية»، هل إعادة تحرير الصورة محاولة لمواجهة الفقدان؟
- لعلّها حالة بحث عن عزاء وتأسٍّ، فحين يفقد الإنسان أمّه مثلاً يصير يستحضرها، يستحضر صوتها وتصرّفاتها، وحتّى الأشياء التي كان يحتجّ عليها. تحديداتنا للجماليّ تقدّمها علاقتنا به، وممارساتنا الاجتماعيّة، لذلك يكون الجميل نسبيّاً وثقافيّاً وطائفيّاً وقوميّاً... ما سمّيتَه بإعادة تحرير الصورة، هو سرد لعلاقتنا مع المكان والزمان، وتلك لا يمكن استعادتها حتّى لو كان المكان مصاناً، فما بالك بعلاقتك مع مكان ممحو، وزمان تفوح منه رائحة الجثث والإعدامات والصواريخ. أختي حكت لي حكاية صغيرة، كانت قد خرجت من الرقّة في 2017، قبل خروج تنظيم الدولة بأسابيع قليلة، مع اشتداد القصف والمواجهات، وقبل ذلك لم تخرج من البيت لشهر تقريباً. قالت لي إنّها حين خرجت من البيت وجدت المدينة تماماً غير تلك التي كانت قائمة حينما دخلت البيت، إلى درجة أنّها اعتقدت بأنّها في كابوس أو في الآخرة، وأنّها لوهلة لم تكن متأكدة من شيء! أنا أستطيع أن أعطي ذلك مصطلحاً فنيّاً هو الفانتازيا. قالت لي: أرجوكِ احفظي الرقة التي عرفناها من قبل! صدقني ليس سهلاً أن تكون من مدينة لم تعد موجودة فيزيائيّاً. ألا يستثير غضبك أحياناً تغيير مكان كتاب في مكتبتك، أو مفتاح على طاولتك، فتقيم الدنيا على من حولك! إذا غيّرت البلديّة طريقاً اعتدت عليها، ألا تشتمها؟ ماذا يمكنني أن أفعل اليوم سوى كتابة الروايات!
شخوص رواياتك منذورون للترحال، ذهاباً وإياباً، هل ما تكتبينه ينتمي إلى مفردات المنفى واللجوء والهجرة القسرية؟
- قبل 2012، كنت أكتب عن الترحال من موقع انتمائي إلى مكان غير مركزي، هامش. يضطرّك الهامش لمغادرته للدراسة، أو للعلاج، أو للتسوق على أقل تقدير. نادراً ما ترى شخصاً «رقيّاً»، لم يخرج من الرقة، لكن كثر أولئك الذين لم يخرجوا من دمشق مثلاً، إنّهم ليسوا بحاجة حيويّة لذلك. أبطالي يبحثون عن هويّتهم باستمرار، وهويّة المكان جزء مهم من هذا السؤال الذي لا يكون منطقيّاً إلا بالمقارنة مع مكان آخر، ومع هويّة أخرى، من هذين الموقعين: المركز والهامش، كانت «عين الهرّ» و«سجّاد عجمي». مع احتلال الرقّة، واحتلال البيت، وخروج العائلة، واستحالة العودة، وشتات السوريين بعامّة، ومعرفتي الوثيقة بمدينة عمّان، كانت «سماء قريبة من بيتنا»، وكانت رواية عن حركة البشر بسبب الحروب، منذ تفكّك الإمبراطوريّة العثمانيّة، وجزء منها عن الهجرة القسريّة للفلسطينيين، والسوريين، والصرب، والفييتناميين... أمّا في «صيف مع العدوّ» فالفضاء العامّ هو فكرة تحوّلات الهويّة بالحروب والهجرات، ولكن بدقائق نفسيّة يوميّة، مستمدّة من حياة أبطال من الرقّة ومن أوروبا الشرقيّة، ومن ألمانيا.
في «صيف مع العدوّ»، الفضاء العامّ هو فكرة تحوّلات الهويّة خلال الحروب والهجرات
لنفكّر معاً: تتغيّر الهويّة الفرديّة بالممارسة الاجتماعيّة كلّ يوم، إنّها تتغيّر بمجرّد انتقالنا من بيتنا لنسكن في بيت آخر مجاور، وتتغيّر هويّة المرأة بشكل أكثر حدّة من هويّة الرجل، وهذه التغييرات كلّها تنطوي على آلام، وهذه الآلام محور حكايات «صيف مع العدوّ». منذ فترة، التقيت بكاتبة بريطانيّة اسمها ليندا فرانس، قالت إنّ محرّك الكتابة لديها هو شعورها بالاغتراب عند تغيير مخارج حروفها حين انتقلت عائلتها في طفولتها من جنوب إنكلترا إلى شمالها! هي تحكي عن مخارج الحروف، ونحن ماذا سنكتب إذن، هل ستشفي غليلنا السير الشعبيّة والملاحم والتغريبات؟! ألا نجد الرواية الشكل الفنيّ الذي يستوعب هذه الإشكاليّة! إنّ المزاج العام للمرحلة لا يمكن استثناؤه في الكتابة الروائيّة، وهذا الذي سيصنع بعد قليل ما نسمّيه تاريخ الأدب.
ما الذي طرأ على لغتك، بعد سنوات الزلزال؟
- لعلّ اللغة من الأشياء القليلة التي بقيت لي، وأدركت أنّها ملك شخصيّ مثلها مثل المبادئ الأخلاقيّة، والمواقف السياسيّة، والجسد. أشياء خاصّة ونحن أحرار في التصرّف بها. أعتقد أنّه لم يكن لديّ مشكلة مع اللغة من قبل، ومع ذلك لاحظت أنّ لغتي تحرّرت من قيود التداول العرفيّ، أي التي حدّدته أعراف المدارس الفنيّة، أو أعمال الروّاد أو المكرّسين. هذا التحرّر في اللغة يعني تغيّراً في الأسلوب، فسنجد في كلّ من «سماء قريبة من بيتنا» و«صيف مع العدو» ذلك الدفق الذي يشبه تيّار الوعي، لكن ليس في الحديث عن الداخل فحسب، بل عن العالم الخارجيّ بأوصافه وأفراده وحركته، ومن وجهة نظر السارد الذي يسرد الذكريات، ومشاهد الحاضر على حدّ سواء، ويسرد الحوارات بين الشخصيّات. لم يكن يوقف دفق اللغة سوى لحظة وعي الإطار الفنّي المحدود بحدود النوع. وكلّما تقدّمت في السرد، كنت أشعر بشكل أعمق بأنّه لا مرجعيّة غيري لتحدد كيف أتعامل مع اللغة، التي جاءت بريئة، وسلسلة، ومتدفّقة، وشجاعة غير آبهة بشيء أو بأحد. أكتب مثلما أحبّ أن أستمع إلى حديث مع صديقة، ومثلما أحب أن أقرأ الروايات. لا أحبّ العنف اللغويّ ولا الصراخ، ولا الاستعارات البعيدة. إنّها ليست لغة الرواية أو لغة الحياة. في «صيف مع العدو»، كتبت مثل طالب في امتحان، يعرف كلّ شيء، لكنّه محدود بكلّ من إطار السؤال والوقت!
يستثنى اسمك من قوائم النقّاد غالباً، في قراءة الرواية النسوية السورية الجديدة، كأن الأمر يتعلّق بمديح الاسم من دون نصّه، ما تفسيرك لمثل هذا السهو؟
- في الواقع هناك كثير من الدراسات النقديّة عن نصوصي، بأقلام أعلام النقّاد، ويمكن أن نقول إنّها في حقل الرواية لا النسويّة بخاصّة. ما زال مفهوم النسويّة محدوداً في النقد العربيّ في قضايا الموجات الأقدم، التي عنيت بقضايا التحرّش، والطلاق، والأسرة، وليس من ضمنها رؤية العالم من وجهة نظر امرأة كما أفعل. هناك أيضاً رسائل ماجستير ودكتوراه قدّمت عن هذه الأعمال في جامعات عربيّة وعالميّة. عموماً حين يتّسع مفهوم النقد النسويّ ليصير جزءاً من الدرس الثقافيّ، ستقرأ نصوصي من هذا المنظار.
متى تتوارين كناقدة وأكاديمية عن نصك الروائي؟
- أستعمل المعارف النقديّة لا النظريّات. أعتقد أنّني استفدت كثيراً من النقد في الكتابة، استفدت من دراسة التيّارات الفنيّة والأساليب، والنمذجة، ومفاهيم علم الجمال، من غير أن تحكمني النظريّة. معرفة تاريخ الأشكال مهم جدّاً في الكتابة، وفي نهاية الأمر الرواية سرد ناقد لطريقة بناء العالم، وللعلاقات التي تحكمه، ولا بدّ للوصول إلى ذلك من معرفة قوانين البناء ونظمه، ومن امتلاك الأدوات. إن لم يكن ذلك متوافراً سيشعر المتلقّي لا بدّ بهشاشة ما يقرأ وبضحالته.



