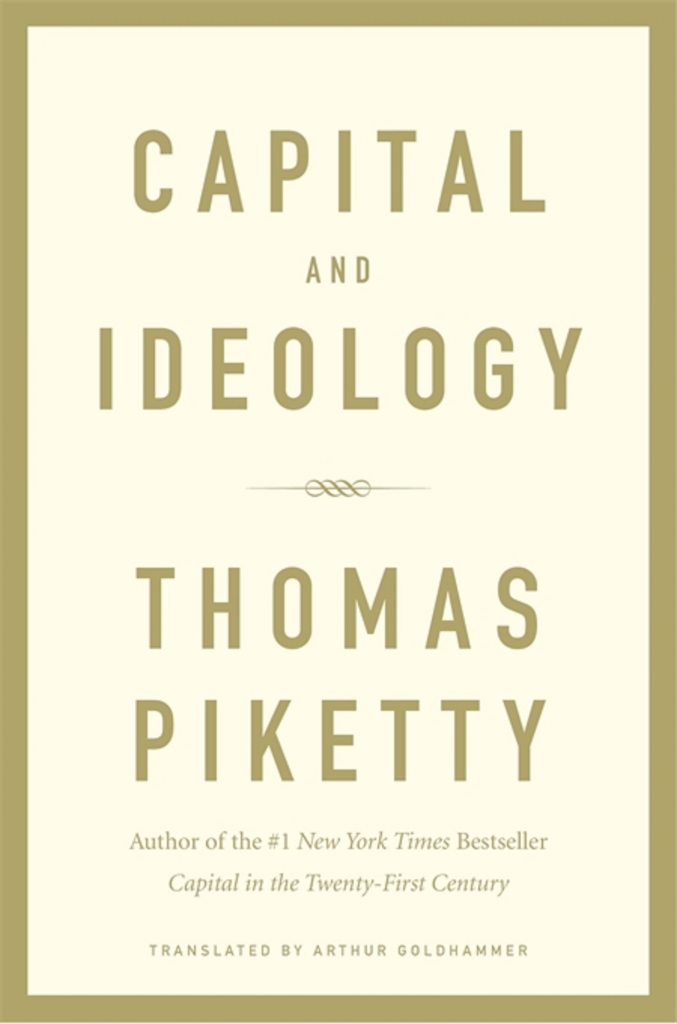
وللحقيقة فإن «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» حقق تلك الشعبيّة ليس فقط لمتانة المعطيات التي يطرحها في المرافعة ضد النيوليبراليّة، بل أيضاً لصياغته معادلة فنيّة بسيطة ــ ومثيرة للقلق أيضاً ــ تفسّر ازدياد الفجوة الاقتصادية بين القلّة والأكثريّة في اقتصادات دول البرّ الأوروبي خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي. وفق بيكتي، عندما تتجاوز نسبة العائد على رأس المال نسبة النموّ في الإنتاج والمدخول، فإنّ ذلك كفيل بمأسسة انعدام عدالة اقتصاديّة بين أصحاب رأس المال، والمستَأجرين. رغم انتقادات تقنيّة وجهت إليها بخاصة لناحية دور الريع العقاري في حساب العائد على رأس المال، بدت تلك المعادلة كحلّ سحري لتفسير اللحظات التاريخيّة لانعدام العدالة الاقتصادية المفرط كما كانت عليه الحال مثلاً في بريطانيا جين أوستن بدايات القرن التاسع عشر حيث النظام الطبقي المغلق، وكذلك للتنبؤ بالمُستقبل، الذي كان – وفق المعادلة وسياق الأحداث – لا يبشّر بالخير للغالبيّة العظمى من البشر. إذ أن فجوة العدالة (الاقتصادية دائماً) مستمرة بالاتساع، ووفق الخبرة التاريخيّة، لم يمكن كسر تلك الحلقة من التردّي سوى في أوضاع استثنائيّة اتخذت شكل حربين عالميتين في القرن العشرين.
على أنّه رغم صرامته العلميّة، يتمتّع بيكتي، بثقافة تاريخيّة وأدبيّة واسعة انعكست على أسلوبه في الكتابة أقلّه بالنسبة إلى القراء غير المتخصصين. إذ كسر حدّة النقاش الإحصائي الأكاديمي الطابع لموضوعة كتابه عبر ربطه باقتباسات ذكيّة من نصوص أدبية لروائيين سجلوا صورة العصور التي عاشوها ـ كما بلزاك وأوستن وغيرهما ـ ليُظهر كيف شكّل انعدام العدالة الاقتصادية طرائق العيش في العقود المتتابعة منذ ظهور النظام الرأسمالي بصورته الحديثة، وتماماً كما هو الحال اليوم. مثّل كتاب «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» نوعاً من صدمة للجمهور العادي في العالم الأنغلوفوني الذي كان يميل إلى اعتبار نقد اليسار للرأسماليّة المتأخرة نوعاً من ثرثرة مؤدلجة متأتية من تفاوت موقع النظر. لكنّه كان أيضاً صفعة قاسيّة لمنظومة علم الاقتصاد السياسي في الجامعات الغربيّة التي كانت وإلى وقت قريب تعتبر أن التركيز على محاولة التأثير على توزيع الدخل في المجتمع وصفةً للفشل الاقتصادي، وسمّاً زعافاً إن تجرّعته الاقتصادات المزدهرة (تعبير السمّ تحديداً استخدمه الشيكاغوي روبرت لوكاس الحائز نوبل في الاقتصاد 1995). بدا سريعاً أن بيكتي هزّ المؤسسة من جذورها، وتجرأ اقتصاديون عديدون بعده على مناهضة طروحات النظريّة النيوليبراليّة الساعية أبداً لتحقيق توازن اقتصادي من دون النظر في توزيع المداخيل، والمطالبة بسياسات ضريبيّة فاعلة متصاعدة على المدخول تكون عابرة للدول بحيث تمنع تهرّب الأثرياء من الدّفع، وتضمن حداً أدنى من العدالة في الدخل بين مختلف الفئات. ورأينا في السنوات الأخيرة جوائز نوبل تُمنح لاقتصاديين نظرّوا لقدرة السياسات العامة على تقليص فجوة المداخيل بين طبقات المجتمع وإنهاء حالة الفقر (أبيهجت بانيرجي وإيشتر دافلو)، أو للطرائق التي يتسبب فيها النموذج الرأسمالي للاقتصاد بتقصير أعمار البشر في الولايات المتحدة (آنجس دياتون)، إضافة إلى كتب وضعها اقتصاديون منشقّون بارزون تتهم علم الاقتصاد النظري بأنّه مدّعٍ يحاول الظهور بمظهر العالم من خلال استخدام بعض المعادلات، بينما فقد الاتصال نهائياً بالصورة الكليّة للمعرفة الإنسانيّة في المجالات الموازية (السوسيولوجيا والسياسة والثقافة)، أو الصلة بالهموم الأساسيّة للمجتمعات المعاصرة.
ورغم أنّ «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» بدا شكلاً ومن بعيد كأنّه تجديد معاصر للنقد الماركسي للمنظومة الرأسماليّة، إلا أن بيكتي باعد نفسه عن كتاب «رأس المال» لكارل ماركس، معتبراً أن «الكتاب المقّدس» لليسار ليس علمياً بما فيه الكفاية، ولا يعتمد على معلومات اقتصاديّة موثقة. ولذا، فإن الماركسيين عموماً تجنّبوا بيكتي، وكانوا سعداء بالانتقادات المنهجيّة التي أطلقها مثقفون وباحثون أنغلوفون ضد ما وصفه بعضهم بتعميمات ومنطلقات غير دقيقة في كتاب هذا الاقتصادي الطالع علينا من باريس. لكن بيكتي لم يتمكّن في النهاية من استكمال مشروعه في نقد الرأسماليّة من دون العودة إلى الفضاء الماركسي. في كتابه الجديد عن «رأس المال والأيديولوجيا» (منشورات جامعة هارفرد ــ 2020 ــ Capital and Ideology) يبدو كأنّه مؤرّخ أكثر منه اقتصاديّاً، يقرأ الحقب التاريخيّة المتعاقبة ويقارن تطور نظمها الاقتصادية قافزاً بشجاعة بالغة عن تلك الحدود الموهومة التي تفرضها الأكاديميا الأميركيّة بين الاقتصاد والعلوم الإنسانيّة الأخرى، لا سيّما التاريخ والسياسة. وللأمانة، فإن الرّجل كان قد أعلن سابقاً أنّه قرر ترك الجامعات الأميركيّة والعودة إلى البرّ الأوروبيّ نظراً إلى عدم قدرته على التعايش مع الاختلاف البنيوي بين المدارس الاقتصادية على جانبَي الأطلسي حول تلك النقطة بالذات. إذ أن الاقتصاديين الأوروبيين يبدون أكثر انفتاحاً في التعامل مع زملائهم في العلوم الأخرى بل يتعلمون منهم ويعملون معهم في مشاريع بحث مشتركة فيما ينعزل الاقتصاديون الأميركيون في شرنقاتهم الخاصّة. وهو شخصياً طالما اعتبر نفسه باحثاً عاماً في العلوم الإنسانيّة، لا مجرّد متخصّص في الاقتصاد البحت.
في «رأس المال والأيديولوجيا»، لا يتجاهل بيكتي الهفوات والانتقادات المحقّة التي تلقّاها كتاب «القرن الحادي والعشرين». ولذا فهو يجعل من هذا السفر الجديد المضاعف الحجم تصحيحاً على مستوى ما للتعريف المرسل لمفهوم العائد الاقتصادي (ع) كما في «القرن الحادي والعشرين»، مؤكداً أهميّة السياسات الاستراتيجية التي تتبنّاها المجتمعات (نخبها الحاكمة غالباً) في تحديد قيمة ذلك العائد. وهو في ذلك ينظر تاريخياً إلى الخيارات السياسية والمعايير الثقافية التي تحكم طريقة توزيع الثروة في المجتمع وتكوينه الطبقي والأسس العقائديّة والتقاليد والممارسات السائدة. يجمعها بيكتي هنا تحت مظلّة الأيديولوجيا التي «تعقلن» ثراء الأثرياء وفقر الفقراء كطبيعة للأشياء بدلاً من حقيقتها بصفتها نتاج هيمنة لطرف على الآخر، فكأنّ طموحه تقديم نظريّة معرفيّة شاملة لا تفسّر انعدام العدالة الاقتصادية فحسب بل كل التجربة الإنسانيّة في الاجتماع منذ فجر التاريخ. قراءة بيكتي للحقب المتعاقبة تخضع للمنهجيّة الصارمة ذاتها التي تعوّل على المعلومات والإحصاءات كأساس لبناء الاستنتاجات. في سرده لتاريخ النظام الفرنسي الملكي السابق على الثورة، يستند مثلاً لتحديد حجم الطبقة الأرستقراطية إلى قوائم قروسطيّة قديمة تسجّل أسماء الفرسان النبلاء الذين كان يمكن استدعاؤهم للمعارك الحربيّة وكذلك سجلات ملكية الأراضي في تلك الفترة. وفي وصفه اقتصاديات الإمبراطوريّات الاستعماريّة الكلاسيكيّة في العصر الجورجي (بريطانيا وكذلك فرنسا)، يحسب بالأرقام بأن الفائض الاقتصادي الذي تمتعت به تلك الإمبراطوريّات وكان يتحقق من «حلب» مستعمراتها الصغيرة عبر نظام العبوديّة، تم تعويضه لدى إلغاء العبوديّة لاحقاً في العصر الفيكتوري من خلال توسيع الرقعة الاستعماريّة ونهب ثروات الشعوب المهزومة. ومع ذلك، فإن بيكتي لا يسقط في فخ التّفصيل على حساب الفكرة الكليّة للكتاب، التي تبقى دائماً بسيطة ومحددة: الأفكار ـــ معبراً عنها بالأيديولوجيا ـــ تشكّل أقدار البشر الاقتصادية.
يبدو بيكتي في الكتاب الجديد كأنّه يستهلك أكثر من ألف صفحة ليعيدنا مجدداً إلى كارل ماركس، وإن أراده هنا واقفاً على رأسه، كما سبق أن أوقف ماركس هيغل على رأسه بشأن الديالكتيك. فالخلاصة «البيكتيّة» تقول بأن البنية الأيديولوجيّة للمجتمع تشكّل نظامه الاقتصادي، وأن من يقرر ثراء الأفراد من عدمهم هي طريقتهم «الجماعيّة» في التفكير بشأن العالم، وهي تماماً عكس النظريّة الماركسيّة التي تجعل من البنية الاقتصادية للمجتمع قاعدة تستند إليها البنية الفوقية الأيديولوجيّة فتتلوّن بها وتتشكل سماتها في نهاية المطاف في سياق طبيعة وتاريخ تطور تلك القاعدة.
الخلاصة «البيكتيّة» تقول بأن البنية الأيديولوجيّة للمجتمع تشكّل نظامه الاقتصادي
ولذلك، ربما لن يجد الكتاب الجديد ترحيباً كبيراً من الماركسيين التقليديين، وسيقصر حتى عن توقعات الماركسيين الغرامشيين الذين طرحوا دوراً ديالكتيكياً للثقافة ــ أو الأيديولوجيا إذا شئت ــ في تكوين طبيعة الخيارات الاستراتيجيّة للتعامل مع محددات القاعدة الاقتصادية، فيما اعتبر مثقفو اليمين ـ في «نيويورك تايمز» وغيرها ـ بأن بيكتي لم يضف في «الأيديولوجيا» الكثير، إنما يمنح سياقاً تاريخياً لمنهج آدم سميث الاقتصادي الذي كان تحدّث في «ثروة الأمم» عن يد خفيّة «تدفع بالاقتصاد باتجاه ما»، فيجعل – أي بيكتي - من تلك اليد نتاجاً اجتماعياً – فلنسمّه الأيديولوجيا إذن لأجل المسيو الفرنسي. ويسوق بول كروغمان مثلاً ليؤكد وجهة نظر بيكتي، وإن انتقده لإنفاقه هذا الجبل من الصّفحات للوصول إلى هذه النتيجة. فدخل سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة مثلاً تدنّى رغم انعدام البدائل العمليّة (لا شاحنات ذاتية القيادة إلى الآن) وغياب المنافسة المعولمة (سوق محليّ مغلق). ولذا فإن التفسير الوحيد لذلك هو السياسات والخيارات السياسية التي تدفع باتجاه تعظيم ربح أصحاب رأس المال على حساب مدخلات العمليّة الإنتاجية، بما فيها أجور سائقي الشاحنات.
هل سيفقد بيكتي هالته التي اكتسبها في «القرن الحادي والعشرين» بعدما تورّط في الانتقال من التنظير لانعدام العدالة الاقتصادية للبحث في «الأيديولوجيا» عن نظريّة شاملة تفسر كل التاريخ؟ هذا هو الأغلب الآن، بعدما حاول الانقلاب على ماركس من دون أن يحظى بتأييد حاسم من أكاديميي اليمين. مع ذلك، يستحق كتابه الجديد القراءة أسلوباً وعرضاً وافتراضات كأنّه تأريخ محدّث وعصري اللغة للعالم، وربّما كتأكيد جديد على أنّه بشأن تحليل المنظومة الرأسماليّة فالناس كلّهم عيال ماركس، ويبدو أنهم سيبقون كذلك في المدى المنظور.


