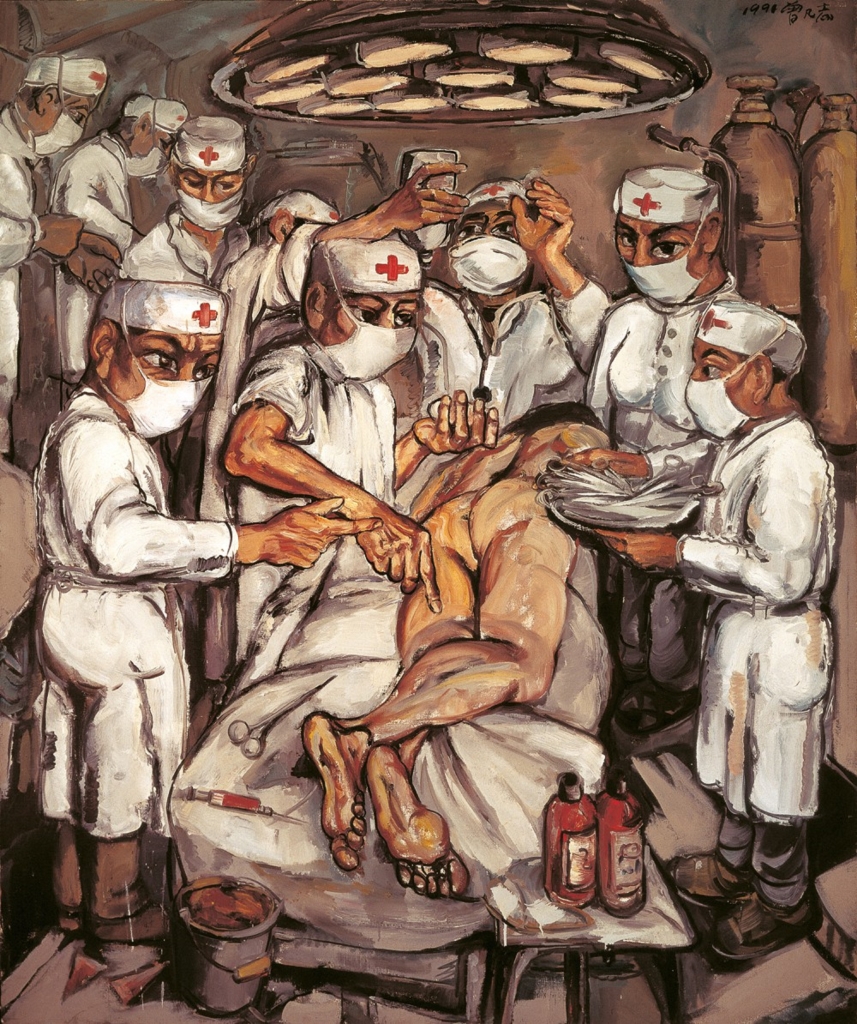
في التراث العربي والإسلامي
لم يخلُ التراث العربي والإسلامي من أخبار «البيمارستان»، والبيمارستان (بفتح الراء وسكون السين) كلمة فارسية مركبة من كلمتين «بيمار» بمعنى مريض أو عليل أو مصاب و«ستان» بمعنى مكان أو دار، فهي إذن دار المرضى، ثم اختصرت في الاستعمال، فصارت مارستان كما ذكرها الجوهري في صحاحه. وكانت البيمارستانات من أول عهدها إلى زمن طويل مستشفيات عامة، تعالج فيها جميع الأمراض والعلل من باطنية وجراحية ورمَدية وعقلية، إلى أن أصابتها الكوارث، ودار بها الزمن وحل بها البوار وهجرها المرضى، فأقفرت إلا من المجانين حيث لا مكان لهم سواها. هكذا، صارت كلمة مارستان إذا سمعت لا تنصرف إلا إلى مأوى المجانين. لم تخلُ كتب التراث من أخبار أدبية يمكن اعتبارها تأسيساً لأدب يدور حول «البيمارستان»، كالنص الذي نجده في الخطط المقريزية للمقريزي المتوفى سنة ٨٤٥ ﻫ والآخر الذي يستعرضه أحمد عيسى في كتابه المرجعي «تاريخ البيمارستانات في الإسلام» الصادر عام ١٩٣٨ والذي أعادت مؤسسة هنداوي طباعته عام ٢٠١١.
1- مقطع من «الخطط المقريزية»
وقال جامع السيرة الطولونية: وفي سنة ٢٦١ﻫ، بنى أحمد بن طولون المارستان، ولم يكن قبل ذلك في مصر مارستان. ولما فرغ منه، حبس عليه دار الديون ودوره في الأساكفة والقيسارية وسوق الرقيق، وشرط في المارستان ألا يعالج فيه جندي ولا مملوك، وعمل حمّامَين للمارستان أحدهما للرجال والآخر للنساء، حبسهما على المارستان وغيره. وشرط أنه إذا جيء بعليل، تُنزع عنه ثيابه ونفقته وتُحفظ عند أمين المارستان، ثم يُلبّس ثياباً ويُفرش له ويتغذى ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأ، فإذا أكل فروجاً ورغيفاً، أُمر بالانصراف وأعطي ماله وثيابه. وفي سنة ٢٦٢ﻫ/٨٧٥م، كان ما حبسه على المارستان والعين والمسجد في الجبل الذي يسمى تنور فرعون أعياناً كثيرة، وكان بلغ ما أنفق على المارستان ومستغله ستين ألف دينار، فكان يركب بنفسه في كل يوم جمعة ويتفقد خزائن المارستان وما فيها والأطباء، وينظر إلى المرضى وسائر المعلولين والمحبوسين من المجانين. دخل مرة حتى وقف عند المجانين، فناداه واحد منهم مغلول: «أيها الأمير اسمع كلامي ما أنا بمجنون، وإنما عملت علي حيلة، وفي نفسي شهوة رمانة عريشية أكبر ما يكون». فأمر له بها من ساعته، ففرح بها وهزها في يده ورازها ثم غافل أحمد بن طولون ورمى بها في صدره فنضحت على ثيابه، ولو تمكنت منه لأتت على صدره فأمرهم أن يحتفظوا به، ثم لم يعاود بعد ذلك النظر في البيمارستان.
وقال محمد بن داود في ذم أحمد بن طولون وبيمارستانه:
ألا أيها الأغفال إيها تأملوا/ وهل يوقظ الأذهان غير التأملِ
ألم تعلموا أن ابن طولون نقمة/ تسير من سفل إليكم ومن علِ
ولولا جنايات الذنوب لما علت/ عليكم يد العلج السخيف المجهلِ
يعالج مرضاكم ويرمي جريحكم/ حبيش … القلب أدهم أعزلِ
فيا ليت مارستانه نيط باسته/ وما فيه من علج عتلٍ مقللِ
فكم ضجة للناس من خلف ستره/ تضج إلى قلب عن الله مغفلِ
2- مقطع من «تاريخ البيمارستانات في الإسلام»
قال المسيو جومارا أحد العلماء الذين استقدمهم نابليون مع الحملة: أُنشئ في القاهرة منذ خمسة قرون أو ستة عدةُ مارستانات تضم الأعلاء والمرضى والمجانين، ولم يبقَ منها سوى مارستان واحد هو مارستان قلاوون، تجتمع فيه المجانين من الجنسين. ومارستان القاهرة هذا لا يزال أكثر شهرة من مارستان دمشق، وقد كان في الأصل مخصصاً للمجانين ثم جعل لقبول كل نوع من الأمراض، وصرف عليه سلاطين مصر مالاً وافراً، وأفرد فيه لكل مرض قاعة خاصة وطبيب خاص، وللذكور قسم فيه منعزل عن قسم الإناث. وكان يدخله كل المرضى فقراء وأغنياء بدون تمييز، وكان يجلب إليه الأطباء من مختلف جهات الشرق ويجزل لهم العطاء، وكانت له خزانة شراب «صيدلية» مجهزة بالأدوية والأدوات. ويقال إن كل مريض كانت نفقاته في كل يوم ديناراً، وكان له شخصان يقومان بخدمته. وكان المؤرقون من المرضى يُعزلون في قاعة منفردة يشنفون فيها آذانهم بسماع ألحان الموسيقى الشجية أو يتسلون باستماع القصص يلقيها عليهم القصاص، وكان المرضى الذين يستعيدون صحتهم يُعزلون عن باقي المرضى ويمتعون بمشاهدة الرقص، وكانت تمثل أمامهم الروايات المضحكة، وكان يُعطى لكل مريض حين خروجه من المارستان خمس قطع من الذهب، حتى لا يضطر إلى الالتجاء إلى العمل الشاق في الحال. وبنى السلطان قلاوون المدرسة التابعة للمارستان في المكان الذي هي فيه في الوقت الحاضر، وكان يدرس فيها الطب والفقه.
المشافي في الروايات العالمية والعربية
يَحجز «أدب المشافي» لنفسه مساحة أكبر على خريطة الروايات العالمية والعربية، ولن يكون مفاجئاً أن نعثر في «ريبيرتوار» الروائيين الكبار على عمل أو أكثر يتخذ من المشفى، أو المكان القلِق، إطاراً يفتح مدار الرؤية والسرد على مناطق قد لا نجدها في المساحات الآمنة. في ما يلي استعراض لبعض الروايات التي تدور في فلك «أدب المشافي»:
«رواق السرطان» ــ الكسندر سولجنتسين (١٩٥٥)
تدور أحداث الرواية عام ١٩٥٥ في الاتحاد السوفياتي، في حقبة نزع مظاهر «الستالينية»، في مدينة طشقند في أوزبكستان تحديداً. يضعنا سولجنتسين في قلب مشفى الأورام حيث عولج هو نفسه من مرض خبيث بعد خلاصه من الغولاغ. نستمع في «رواق السرطان» إلى وجهة نظر الأطباء، والممرضين والمرضى عبر تجربة المرض والمعاناة والموت. يتساءل كلّ من أبطال الرواية عن معنى الحياة، منطلقاً في سرديته حول الأشياء برمتها من ماضيه، وموقعه الاجتماعي ورأيه في النظام السوفياتي. لا تخلو رواية «رواق السرطان» من الضغط الايديولوجي، حيث يظهر الطبيب والمشفى كأدوات إضافية للتسلط على آخر فضاء «خصوصي» يمتلكه المرضى وهو الجسد، ليتداخل المرض الاجتماعي بالسقم الفيزيولوجي. عن هذه الرواية، يقول القاص العراقي محمد خضيّر: «رواية سولجنتسين «جناح السرطان»، مراقبةٌ بطيئة للكائنات التي تخفي أورامَها تحت ثيابها، عمداً أو دون دراية منها بمرضها الفتّاك. يخرج طبيب جناح السرطان إلى الشارع، فتسقط نظراته على السَّيل البشري الذي يصادفه، ويحزر مع نفسه موضعَ الأعضاء المخفية التي يتوقع نموَّ السرطان فيها ببطء وخبث وشراسة. إنّهم أحرار ما زالوا بأجسادهم التي لم يهاجمها المرض بعد، لكنّهم سرعان ما سيدخلون الأجنحة الرهيبة ويلتحقون بالمرضى المعزولين مع آلامهم وخوفهم من قدوم النهاية. كلُّ واحد من هؤلاء السائرين عكس اتجاه سير الطبيب، مرشّحٌ للموت».
«طيران فوق عش الوقواق» ـ كين كيسي (١٩٦٢)-ـ ترجمة صبحي حديدي
حين أصدر كين كيسي عام ١٩٦٢ عمله الروائي «طيران فوق عش الوقواق»، حجز الروائي الذي لم يبلغ حينها السابعة والعشرين من العمر مكاناً مرموقاً في ثقافة «الأنتي ـ-سيستم»، أو الثقافة المضادة التي يمثّلها «ماكمرفي» بطل الرواية الطيب، بالرغم من لغته الشوارعية وشتائمه التي تنهل من اللغة العامية الأميركية، مقابل الممرضة راتشيد التي لا تعرف الرحمة، بالقسوة المقنّعة بلكنتها البريطانية المهذبة وانضباطها العسكري الذي يمثل كل سطوة تمارسها مؤسسة ما أثناء تدجينها للأفراد الواقعين تحت شعاعها. في حبكة أشبه بأسلوب شتاينبك ولغة فولكنر التي تقفز من راوية إلى أخرى، نجح كيسي في أن يجعل من المشفى النفسي مرآة للمجتمع الأميركي، في تناقضاته الثقافية والاجتماعية. إذ تزج الممرضة الحاكمة بأمرها في المصح بالممرضين السود في وجه المرضى المتمردين، في لعب مكشوف على التناقضات بين التوق للمساواة والحرية والحقد العرقي والطبقي، وفي إبراز مدير المشفى على شكل هندي أحمر صامت، تصادر السيدة راتشيد صوته وقراره في إحالة إلى عمليات الإبادة التي قام بها الرجل الأبيض بحق السكان الأصليين. الرواية ذاعت شهرتها في الآفاق حين حوّلها ميلوس فورمان عام ١٩٧٥ إلى فيلم من بطولة جاك نيكولسون (ماكمرفي) إلى جانب لويز فلتشر (السيدة راتشيد)؟ كانت العمل الأدبي القمة لكيسي الذي قضى من بعدها سنوات في السجن لتعاطيه الماريجوانا: «أحدهم طار إلى اليسار، أحدهم طار إلى اليمين.. أحدهم طار فوق عش الوقواق»، تقول الأغنية الشعبية التي استوحى منها كيسي عنوان روايته الذي يأخذ فيها المشفى بعداً سياسياً بامتياز، حيث يكون كل ما يحيل إلى مؤسسة السلطة أشبه بالطائر المفترس الذي يكسر البيض في أعشاش الطيور الصغيرة.
«غرفة مثالية لرجل مريض» ـــ ليوكو أوغاوا (٢٠٠٥)
«كان بياضه ناصعاً كأن كل خلية من خلايا بشرته تشف حتى يرى من خلالها. وكانت حزينة وقلقة لمجرد الظن بأن تلك الشفافية ستواصل انتشارها وتكسو جسمه كله حتى يموت جسمه فعلاً وكأنه ينتحر»، تقول الأخت-الراوية التي تلازم أخاها المصاب بمرض عضال ويحتضر في أحد المشافي. يبرز المشفى في هذا العمل الروائي كفضاء للرعب ومسرح للقسوة، رغم الديكور اللطيف والرومانسي من الحجرة البيضاء شديدة النظافة التي «تتألق مثل فردوس»، والشتاء الياباني الأشبه بالموسيقى التصويرية عبر النافذة. تحمل الأخت مع أقدامها في الممر الخاوي كل الانكسارات: خيانة زوجها، روح أخيها التي يشدها الموت إليه، الذكريات التي تبدو كإناء من البورسلين المنكسر، هشاشة أخيها التي تختصرها أوغاوا في جملة روائية بديعة: «سوف أموت جاهلاً أموراً شتى، لن أقدر حتى أن أخوض تجربة الزواج، وقتي لن يتسع لذلك، من كان ليحسب أنني سأموت قبل اختبار علاقة مع امرأة».
تلعب أوغاوا في «غرفة مثالية لرجل مريض» التي ترجمها الشاعر اللبناني الراحل بسام حجار لعبة التفاصيل والتناقضات بلغة شعرية رقيقة ومتقنة تطرز الفناء الذي يحف بروحها هي أيضاً، وحين تتحدث عن الطبيب الذي واعدته «لم يكن في نظري عشيقاً، لم يكن زوجاً مجرداً أو رفيق صبا، فلا وجود لماض بيننا، ولا مستقبل، فقط كنت أحتاج لقوة جسده لأقاوم به فناء أخي». إنها رواية الانتقال من الحضور إلى الغياب حيث غرفة المريض أشبه بحاضنة الأطفال التي يكتمل بها نمو العواطف قبل أن تنقش كالوشم في الذاكرة.
«أوسكار والسيدة الوردية» ـــ إريك إيمانويل شميت (٢٠٠٨) ترجمة آنا عكاش
«تهت في صحراء الجزائر ذات مرة، فاستلقيت على ظهري في ظلام الليل، في انتظار الموت، فأتاني بدلاً منه الإيمان». كانت تلك كلمات إريك إيمانويل شميت رداً على سؤال نجيب محفوظ عن سر تلك النزعة الصوفية في رواياته. كلمات تشبه تماماً كلمات أوسكار بطل رواية «أوسكار والسيدة الوردية» حين رأى ربه يزوره بعد إتمامه التسعين عاماً في اليوم التاسع من أحداث الرواية. يضعنا الروائي الفرنسي في روايته الجميلة أمام رسائل يوجهها الطفل المريض أوسكار إلى الله، هذه الرسائل التي سيكتبها من وحي علاقة الصداقة مع «السيدة الوردية» التي تأتي لزيارته في مشفى أمراض الأطفال المستعصية والتي سيخطّها في الأيام الاثني عشر الأخيرة من حياته، والممتلئة بالأماني التي تضيء الجزء المتبقي والمكثف من حياته القصيرة. يبدو المشفى في رواية شميت مثل الزاوية التي تحتضن تجربة صوفية حية، بحيث نرى الأنقياء، أو من يملكون نظرة صافية للوجود مثل الأطفال أو التائهين في الصحراء، يستشرفون العالم الأكبر في أنفسهم: الروحانية والنور الذي يغمر القلب. في هذه الرواية، نوع من الصوفية «الدنيوية»، حيث يرفع الروائي عن أكتافنا ثقل الموت، وما يدور حوله من سوء تفاهم كبير مع العالم، والأحقاد تجاه العالم والبشر. في «أوسكار والسيدة الوردية»، يُمنح الغفران في النهاية للجميع، للأهل والمرضى والولد المريض، وحتى لمن يظن أنّ الموت ضريبة مستحقة. حين يقف الطبيب عاجزاً في آخر العمل الذي تحول هو الآخر عام ٢٠٠٩ إلى فيلم من بطولة ميشيل لاروك (روز) وأمير بنعبد المؤمن (أوسكار)، يقنعنا شميت أن الحب هو الذي يكمل الطريق.
«على ضفاف الأنهار التي تجري» ـ أنتونيو لوبو أنتونيش (٢٠١٥)
رواية ذاتية للكاتب البرتغالي العملاق أنتونيو لوبو أنتونيش تدور أحداثها في مشفى لشبونة حيث يخضع الكاتب لعلاج من مرض خبيث لمدة أسبوعين. يأخذنا أنتونيش كما في «أست يهوذا» في سرد يشبه الشعر متفلت من العقدة والحل والقالب الروائي التقليدي، بحيث نشعر كأننا في قلب غابة كثيفة من الانفعالات والتأملات والذكريات، أو نهر عظيم من الكلمات يتدفق شعرياً ويصب في محيط تمثله الرواية. يأخذنا أنتونيش باختصار في رحلة إلى عقل المريض القابع في قسم الأورام السرطانية، ومن المقطع الأول، يكشف لنا عن «وجود مطلَق» للمريض يتجاوز جدران غرفة المشفى، وروحه الحرة التي تتجاوز الزمن والمكان. لن يرضى السيد أنتونيش بدوره في سريره كمريض، بل أول ما تلقي به الذاكرة في الريف البرتغالي، طفلاً يزور جدّته العجوز. تتبدى أروقة المشفى مثل شوارع القرية الضيقة، وتلقي الممرضة بنظرها على الغرفة كما العين الساهرة للأم على الأطفال، وتتداخل كل الأشياء: الوجوه التي تعاقبت على الذاكرة التي تطحن كل شيء، حيث لا ماض ولا مستقبل، بل كل شيء في الزمن الحاضر، رواية الاحتضار التي تتحول إلى رواية الحياة. التجربة الجراحية، الألم، القلق، الأحاديث مع الأطباء تقطع الحبل الطويل لهذا التذكار للأشياء على تخوم الوعي. يحضر التشخيص الطبي في رواية انتونيش على شكل جمل تشق طريقها وسط غابة من الأصوات، والروائح والأشباح التي يراها وحده، ووسط الأنهار الأسطورية وأنهار البرتغال، أنهار الانفعالات والمشاعر، أنهار الذاكرة والزمن. «إنه يهذي» يقول الممرض، يجد القارئ نفسه مستمتعاً بشرب هذا الهذيان.
شهران لرلى ـــ عباس بيضون (٢٠١٨)
«لا أعرف كم مضى من الوقت وأنا في هذا السرير، بذلوا جهداً ليفهموني أنني في المستشفى... وصلت إلى المستشفى وقد نزفت حصة كبيرة من دمي وضغطي خمسة، كان الذين صدموني حملوني إليها في سيارة إسعاف بعد أن قذفتني السيارة إلى واجهتها، وفوجئوا بهذا الطائر الكبير مشبوحاً على الزجاج... أجروا لي أربع عمليات اثنتان منها في رجلي وكنت لذلك أشعر كلما حرّكتها بأن جلدي ضيّق عليّ، وبأني شبه مخيّط في نصفي الأسفل. كانوا يحمدون شجاعتي وكنت لا أفهم أي شجاعة أبديتها خفية عني، وكيف أبدت كليتاي وقلبي مقاومة دون علمي. وكانوا يهنئنونني لأني نجوت من موت كان بهذا القرب. لكنني استيقظت مرعوباً من فكرة أنه لا يزال أمامي».
لا تخلو رواية «رواق السرطان» من الضغط الايديولوجي، حيث يظهر الطبيب والمشفى كأدوات إضافية للتسلط على آخر فضاء «خصوصي» وهو الجسد
من فوق سرير المستشفى وعن تجربته فيها إثر إصابته بحادث دهس، يبدأ عباس بيضون روايته في فصل أول، مستحضراً الموت وجهاً لوجه والتجربة التي تتشارك فيها الغيبوبة والألم، حيث تتيح التجربة السريرية للكتابة أن تبلغ مكاناً لم يكن ممكناً أن تصل إليه في حالة السلامة والأمان. كتابة في المنطقة الهشة بين الوجود والفناء. سرعان ما يهرب عباس بيضون من هذه المنطقة «السريرية» الشخصية إلى ما حولها، لينتقل لرواية الشهرين الأخيرين في حياة صديقته رلى أ. التي أمهلها الأطباء هذه الفترة القصيرة للعيش إثر إصابتها بمرض عضال. النقلة السردية التي ترمي بكرة الكتابة حول الموت، الذي لا يبدو قابلاً للشخصنة، من الذات نحو الآخر، سمحت لعباس بيضون الخروج بروايته من فضاء أدب المشافي بحيث يبدو المرض في نهاية فصلها الأول ضبابياً وغائماً، نحو نوع من السيرة الروائية التي تشمل أركاناً ثلاثة في حياة صاحبها: ركن السياسة، وركن الحب وركن الحياة والموت: من فوق السرير نفسه، تبدو الكتابة عند بيضون نوعاً من «الحياة المعلقة»، ونوعاً من الهروب إلى الأمام حين يستحيل التفكير بالموت مرضاً، كما تقول دوراس.
«التانكي» ـــ عالية ممدوح-(٢٠١٩)
في العمل الروائي الكبير لعالية ممدوح، نرافق البطلة عفاف أيوب الشخصية المركزية في رواية الخسرانين المتلعثمين في لسانهم الأصلي وعبر ألسنتهم الهروبية أيضاً، حيث يبدو المشفى الباريسي الذي تحتضر فيه أشبه بسجل لتدوين الاعترافات حول تاريخ الأوطان المثابرة على إهانة أبنائها، وجعلهم يبدون على اختلاف الأعمار والثقافات، كأنهم يتحركون ما بين الهشاشة والتدجين، بين أنواع الأمراض ونكرانها. «ضربة المعلّم» في رواية ممدوح تكمن في الرسائل التي توجهها معظم الشخصيات التي عرفت عفاف قبل سفرها إلى الدكتور كارل فالينو، الذي خبر عفاف عن قرب في شغفها للحياة والفن، وفي انفصامها بين العقل والجنون. الدكتور فالينو هو أقرب إلى الغرب وحضارته وعمقه المعرفي من مستشرقيه إلى متاحفه وجامعاته، الطبيب الذي يمثل المنفى، وكرسي الاعتراف والمشرحة التي نبسط فوقها الحنين والحسرة. تموت عفاف في المشفى في قلب العلاقة المحتدمة بين الشرق والغرب، بعد أن تبثنا اعترافاتها حول اليأس من الوطن وقسوة حبيبها الفرنسي غيّوم، وتستذكر في رقادها حالها وهي تمشي في شوارع باريس بين الغفلة والبراءة وهي تحتضن الشيء الوحيد الذي بقي في حوزتها: الأرجل. «نُمر الأحذية تتسع وقياس القدم يتغير كلما اتسع الأفق. وهكذا وفي أحد الأيام رفعت قدميها عالياً في وجه العالم وصمتت».


