منذ سنوات الطفولة الأولى، يشعر ديدييه بلوند بالحرج من اسمه «نظل طيلة حياتنا ندور حول أسمائنا إما أن نواجهها أو نتفاداها، نطالب بها أو نجهد لإخفائها» لكنّ الاسم سيكون أيضاً مصدر إلهام بالنسبة إليه، وهو يعيد التفكير في مسألة الهوية وطرق إخفائها، منجذباً إلى سحر الأفلام الصامتة «حيث لا تحمل الشخصيات أي أسماء على الإطلاق».
في المقابلات القليلة التي يظهر فيها، يبدو متحفّظاً، يكرّر الجمل على نحو مثير للارتياب قبل أن يستدرك: «أكرر هذا كي أقنع نفسي به». ولو بحثنا جيداً سنسمعه يتحدث عن علاقته الوعرة باللغة: «لفترة طويلة، عانيت من صعوبة في التحدث، ثمة دائماً شيء ما يخونني في الحوار وبسرعة شيطانية. زد على ذلك الخجل». في رواياته، نلاحظ أن شخصية الأب حاضرة دائماً، يعطيها بلوند أحياناً مساحة صغيرة لكن ضرورية، وقد كان والده يعاني من الصمم، ما جعل لغة التواصل بينهما مشفّرة تمرّ عبر النظرات والجمل المتقطّعة. يقول: «بدأنا نتحدث فعلياً وبكثرة بعد وفاته، هذه ليست صيغة بلاغية أو استعارة، فأنا أواصل الحوار معه بالفعل، وعلى عكس ما يعتقده الجميع، نحن لا نُملي على الموتى ما نحب سماعه».
صاحب «رجل بمئة وجه» (1993) غير معنيّ بعقلنة علاقته بالواقع، ذهنه منجرف نحو عالم الأموات وغالباً ما يجد طريقة ليجعلهم يتحدثون إليه. يمارس فن استحضار الأرواح على شخصيات ينتقيها من الأدب أو السينما «هم من يأتون إليّ من تلقاء أنفسهم، دوبلير، كومبارس، مجهولون...». وليس من قبيل المصادفة أن يختار لنشر أربعة من كتبه دار l’un et l’autre التي يديرها الناشر ج.ب بونتاليس، وهو محلل نفسي يقدم للقراء مجموعة من الكتب التي تفكك مفهوم الهوية، وتؤكد بأن الشخص الواحد يقوم بأفعال كثيرة مختلفة تجعله متعدداً في الماضي والحاضر معاً، فالهوية في كينونتها تخضع للتطور والتحول والتراكم المُفضي إلى التجدّد... وهكذا عبر «وجوه منسية، أسماء متفسّخة، بروفيلات مفقودة» يشترك ديدييه بلوند ومحرّره في فكرة أن الهوية هي عبارة عن خريطة طوبوغرافية لا بدّ من استكشاف متاهاتها، خاصة حين تُقدّم نفسها كحقيقة مُطلقة.
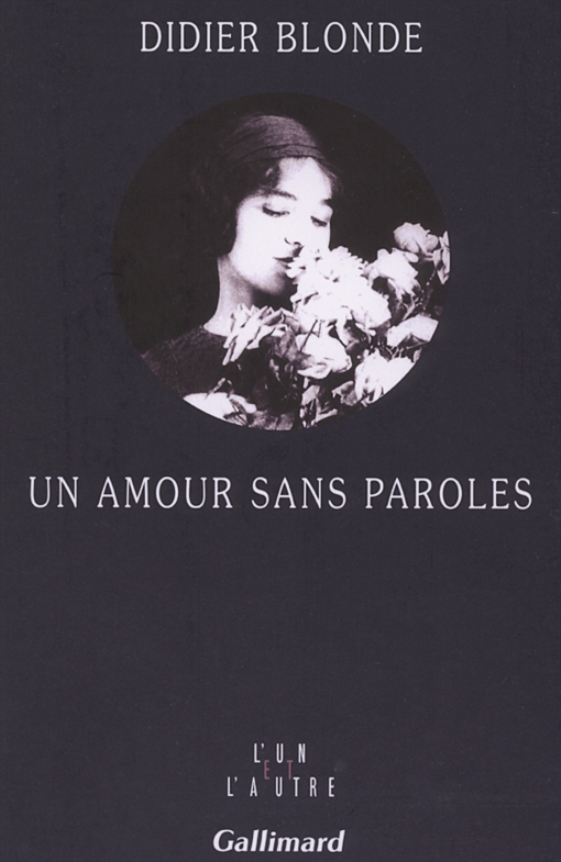
لصوص الوجوه
بتوق شديد، تتجه خطوات مؤلف «الكومبارس» (غاليمارـ 2018) نحو دُور السينما المختفية وبيوت الممثلين والممثلات المنسيين وأبطال طفولته، وخصوصاً المقنّعين منهم مثل فانتوماس وآرسين لوبين... يبحث عن السينما خارج الشاشة. يقول: «فتحت عينيَّ على كلاسيكيات الثقافة الشعبية وأستطيع أن أقول إنني مدين بكل شيء لآرسين لوبين». وكانت صحيفة Je sais tout الفرنسية قد طلبت من موريس لوبلان كتابة قصة، وأرسل إليها «اعتقال آرسين لوبين» التي لاقت نجاحاً مدوياً فكتب أخرى «آرسين لوبين في السجن» وتواصلت السلسلة ليعيش الجمهور الفرنسي مع هذا اللص الجنتلمان على امتداد 17 رواية و39 قصة قصيرة، استوحت منها نتفليكس أخيراً مسلسل lupin الذي تابعته نحو سبعين مليون أسرة حول العالم ليصبح أحد المسلسلات الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة.
يعوّل على التوثيق أو التاريخ أو الحكاية الشعبية المتداولة كمكوّن رئيسي للعمل
ما سحر بلوند أن البطل المقنّع باريسي في الأساس، عالمه مألوف ويمكن تعقّبه، ولا بد من أنه يعاني من مشاكل وجودية وتصدّعات لكثرة ما يخفي هويته ويستبدلها. وحول موضوع الهويات المتعددة بالذات، يدور كتاب بلوند «لصوص الوجوه» (1992) وهو إحدى الثيمات الأساسية للرواية الشعبية. أما هوسه بالسينما الصامتة، فيُرجعه إلى فيلم لويس فوياد «مصّاصو الدماء» حين لمح في أحد المشاهد نافذة شقة جده. يقول «أحاول التعرف إلى كل الشوارع في أفلام فوياد، وفي معظم الأوقات أستطيع تحديدها بدقة». وقد أُطلقت تسمية السينما الروائية [CINÉMA NOVEL] في أوروبا على طائفة من السلاسل البوليسية التي اكتسبت شعبية كبيرة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، وكانت تمجّد المغامرات العجيبة لأبطال المجلات المصوّرة وأشرارها. المخرج الأكثر شهرة لهذه النوعية من الأفلام هو السينمائيّ الفرنسي لويس فوياد الذي اشتغل مع ليون غومون لمدة عشرين عاماً وأخرج ما بين 500 إلى 700 فيلم، أكثرها نجاحاً فيلم «مصّاصو الدماء» وهي قصة عصابة يقودها زعيم يستمدّ إلهامه بشهوانية من معشوقته التي أدّت دورها ببراعة الممثّلة موسيدورال. وما يميّز هذا الفيلم أن دور البطولة يرجع للمَشاهد المدينية بدون منازع، إذ اضطر فوياد للتصوير في أحياء باريس الهامشية المعتمة بعد الذي عرفته استوديوهات المدينة من دمار بسبب الحرب. نرى الدروب الرمادية المملوءة بالحصى، البنايات المتداعية، الأركان المقفرة، العابرين المهرولين، السيّارات المعدودة التي تمرّ بين الحين والآخر... كل شيء يسبح في رعب رمادي. وحيث تعيش الممثلة الرئيسية موزيدورا... في خلفية أحد المشاهد، استطاع ديدييه بلوند أن يتعرّف إلى شقة جده. يقول: «تم تصوير الفيلم في عام 1915 وولد والدي عام 1912، لذا أحلم، أقول لنفسي إن والدي هناك، موجود خلف ذلك الجدار، وعمره لا يتجاوز بضع سنوات».
الذاكرة تعمل كنُزهة
على غرار السينما، الأدب هو التعويذة التي يستخدمها بلوند لإنعاش الموتى والتحدث إليهم. قادته المصادفة إلى مقبرة بيار لاشيز حيث تلمّس أشياء تتصل بواقع جديد والتقى بليلى ماهي أو بالأحرى التقى بصورتها المحفورة في المربع 5011 والتي تجمع بين الغموض والغواية كأنها مُقتَطعة من فيلم. لم يستطع أن يمنع نفسه من التفكير بها، ليبدأ تحقيق طويل لإحياء هذا الوجه وبناء فرضيات حول الحياة المحتملة لليلى. ممثلة منسيّة؟ خبيرة في الرجال؟ يتتبع بلوند الأدلة ويصل أحياناً إلى طرق مسدودة، لكنه يتلمّس طريق العودة مثل إيزيس التي تسعى لإعادة تكوين جسد أوزوريس المقطوع. يبحث في السجلات المدنية وأرشيف المكتبات، ويلاحظ بشيء من الغيرة والسخط أن بعض المدونات تتحدث بالفعل عن بطلة حياته، وأنه ليس الوحيد الذي استجاب للنداء الخفي للأحرف الأولى السحرية من اسمها L.M. بلُغة معاندة، سريعة، بصرية وعاطفية أيضاً، يرافق بلوند بطلته في وحشة أمكنة كثيرة نهلت منها حياتها. هذا التقارب بين أسلوبٍ للعمل، هو في طبيعته حكواتي أو سردي مشوّق، وبين مضمون مرتكزٍ إلى حد كبير إلى سيرة ذاتية، مكّنهُ من الحصول على «جائزة رونودو» لعام 2015 ليكتب معلّقاً: «لم أصادف في حياتي ما هو أكثر إثارة للمشاعر من شاهدة قبر».
ويبدو أن كل شيء يحدث كما لو أن ديدييه بلوند قد تبنّى وصية لوتريامون، التي اقتبسها كافتتاحية لأكثر من كتاب: «اذهب وانظر بنفسك إذا كنت لا تصدقني»، ولعل هذا هو السبب في تحوله إلى رسّام يفوق خرائط غوغل دقةً، يتتبع مسار بودلير من منزله الأخير حتى مسقط رأسه، أو يضع دليلاً لعناوين الشخصيات الأدبية بترتيب أبجدي أو فانتازي في «دليل العناوين الباريسية لبعض الشخصيات الخيالية في الأدب» (2020). ولا يكتفي بذلك، بل يضيف فهرساً حسب المنطقة وآخر حسب الشارع ويشرح في مقدمة من خمسين صفحة كيف أصبح حبيس عالَمين: عالم الخيال المطلق وسجل العقارات الرسمية. العنوان هو أوّل ما يستوقف ديدييه بلوند سواء ظهر في فيلم أو كتاب، وقد يبدو مجازياً لوهلة، أو يُقدّم تحريضاً على تساؤل وكأنه أحجية. يحاول الكاتب أن يتحقق من دقته في الواقع، وقد ينتظر لساعات مثل عاشق مخمور تحت نوافذ شارع دو شوازول أن تُطل ماري أرنو، بطلة فلوبير في كتاب «التربية العاطفية».
يشعر بلوند بالحماية التي توفرها له هذه المطاردات المجنونة، هذا النظام الذي يعيد التشكيل المدني للأمكنة، هو بمثابة التعويض النوستالجي الذي يسلط الضوء على الفجوة بين باريس التي سقطت في غياهب النسيان وباريس اليوم، ويحّول الجغرافيا إلى بُعد طيفي، لتصبح الرحلة التاريخية بديلاً عن الرحلة المكانية.

السينما الصامتة واختراع الأيقونة
التاريخ يشكل دعامةً لسقف الواقعية التي يشتغل تحتها ديدييه بلوند من خلال أرشفة المادة البصرية ـ السمعية، بالكتابة. لكنه يأخذ في الاعتبار ضرورة تغليف كل عمل فني بالقيمة الجمالية، بعيداً عن القيمة التاريخية. فالتاريخ لا يجوز استنساخه أو نقله كما هو ولصقه بخلفية شخصية ليتحول إلى فن. ذلك ممكن فقط حينما يحضر الفني والجمالي لعناصر تأليف الرواية والشخصيات وتعميق العلاقة بين الشخصية والمكان. بعد كتب عدة خصّصها للسينما الصامتة، يسترجع كتابه «حب دون كلمات» حياة الممثلة سوزان غراندي، التي توفيت في حادث وحشي وهي في كامل مجدها. ويقود الكاتب هذا التحقيق من خلال تتبع خطى عاشق مجهول هو جون د. الذي كان مؤهلاً لأن يصير قسيساً لو لم يغرم بها وقد أعلن لها عن هذا الحب في رسالة لم يرسلها، عثر عليها ديدييه بلوند بمحض المصادفة. هنا يتفرع السرد إلى مستويين: بين محقق اليوم وعشيق الأمس، وكأن للكتابة مهمة مزدوجة: لملمة شظايا حياة سوزان المُجزّأة وتحقيق الحب المستحيل.
قد ينتظر لساعات مثل عاشق مخمور تحت نوافذ شارع دو شوازول كي تُطل ماري أرنو، بطلة فلوبير في كتاب «التربية العاطفية»
وكانت سوزان غراندي قد ظهرت في أوائل الأفلام السينمائية الفرنسية التي يسكنها العديد من الكائنات الخارقة، هي «المرأة القصيدة» أو «المشعوذة» التي تقترن شخصيتها بـ «انحراف طفيف»، تتواصل حياتها بعد اختفائها عبر عشّاق سريين أثارت فيهم شغفاً متعصباً وصامتاً مثل جون د الذي يكتب: «مرت أشهر عدة من دون أن أكون قادراً على إبعاد ذكرى سوزان من ذهني». الراوي أيضاً لا ينجو من هذه الغواية، يُعيد مشاهدة أفلامها مراراً حتى يتمكن من قراءة جميع الحوارات على شفتَيها.
تمثل غراندي الذاكرة أو الأرشيف الحي. وهي تشكل بالإضافة إلى الوثائق التي يعتمدها الكاتب، كمّاشة للقبض على تاريخ السينما الصامتة قبل أن يمحوها «أبوكاليبس الحوار» وتصبح الممثلة بعد ذلك أيقونة هذا التحول المأساوي التي ينتهي بموتها عصر كامل. لكنّ هذا الموت الغامض يغذي أسطورة النجمة التي تظل دائماً بعيدة المنال، لا تترك لنا سوى انطباعات واهية: «وجه، صورة ظليّة، ابتسامة، نبرة صوت متخيلة» هي الشقراء الحقيقية والسمراء الحقيقية، تبدو مرغوبة بقدر ما لا يمكن تحديد هويتها وبقدر ما لا يمكن الوصول إليها. تتداخل شخصيتها في الشاشة مع شخصيتها الحقيقية المزاجية التي تلغي في الخامسة مساءً مواعيد السهرات والحفلات التي خطّطت لها صباحاً ويتبعها جون د في الشارع كما في السينما، من دون أن يجرؤ على النطق باسمها «سوزان» لأنه الاسم الذي تحمله أيضاً في معظم أفلامها، كأنه القناع الذي يجعل كل شيء واضحاً وشفّافاً... وكي لا ننسى السينما التي جلبت التسلية والمغامرات والهروب وجعلتنا نصدق كل ما لم تقله.

الأرشيف واقع موازٍ
صحيح أن ديدييه بلوند يعتمد التلاعب بالزمن وتنظيمه، من خلال سلطة الحدث نفسه، ما يخدم المخيلة، لكنه يعوّل على التوثيق أو التاريخ أو الحكاية الشعبية المتداولة كمكوّن رئيسي للعمل ويكشف لنا دائماً مسارات التحقيق ومراحل البحث عن الأدلة والشهود. ندخل معه إلى أماكن الأرشيف المُحكَمة والمؤطرة التي تفوح منها رائحة المستنقعات النائية، مثل أرشيف Gaumont المعروف بممراته العنيدة ومكاتبه المتداعية وظلاله غير المريحة. وحيث ما ذهبنا، ستلاحقنا النظرات المتفحّصة الباردة لبورتريه ليون غومون. أما «معهد ناشيونال جيوغرافيك» فهو عبارة عن متاهة حقيقية يحتاج كل مدخل فيها إلى تصريح رسمي وبروتوكولات شبيهة ببروتوكولات الدخول إلى المناطق العسكرية المحاطة بالحراسة المشددة. هذا الجو يدفع ديدييه بلوند إلى شفير اليأس في بعض الأحيان: «ما هي الأعذار التي أسوقها لنفسي كي آتي إلى هنا لمشاهدة هذه الأفلام القديمة؟ ما السر المفقود الذي أعتقد أنه لا يزال بإمكاني قراءته على هذه الوجوه؟ غياب والديّ جعل مني اختصاصياً في السينما الصامتة. في هذا المكان أتعرف إليهم من جديد، من خلال هؤلاء العابرين أجعلهم يتحدثون إليّ».
هذه المواقع التذكارية، سواء أكانت رسمية كالأرشيف أم شخصية كشواهد القبور، تقف في مواجهة النسيان، ولذلك يشبه الذهاب إليها التحول من الزمن الواقعي إلى آخر مجهول موازِ. يقول الكاتب: «حبست نفسي لأيام في أرشيف «سانت وان» ونسيت تدوين الملاحظات، لم أكن أعرف بالضبط ما كنت أبحث عنه. ابتعدتُ بضعة كيلومترات فقط عن باريس، لكنني لا أستعيد ذلك اليوم إلا كذكرى من منام. قمت بالرحلة بمفردي في مقطورة أشباح أخذتني إلى نهاية العالم لتوصلني إلى الماضي».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا



