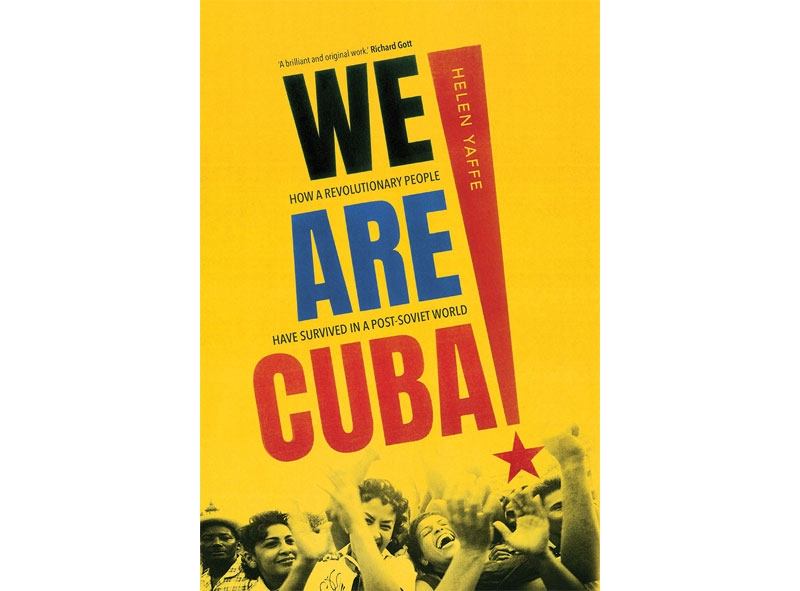
لقد أربك طول عمر الثورة الكوبيّة الأميركيين الذين اعتبروا دائماً أن أميركا اللاتينية حديقة خلفيّة لنفوذها الإمبراطوري، وطالما نجحت خططهم في إسقاط وحصار الحكومات التي يقودها اليسار على امتداد القارة، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك الحكومات قد وصلت إلى السلطة بالانتخابات الديمقراطيّة أو بالبندقيّة. وطوال أكثر من 60 عاماً، لم تألُ الولايات المتحدة جهداً في محاولات إخضاع الجزيرة، واستهداف قادتها، وخنق شعبها في واحد من أطول الحصارات في التاريخ. حصار كلّف كوبا أكثر من 750 مليار دولار من فرص التجارة مع العالم. ولم يتوقف كثيرون ـــ مراقبون غربيّون وتلامذتهم العرب ـــ يوماً عن الحديث عن نهاية قريبة للتجربة الثوريّة الكوبيّة بوصفها من مخلفات مرحلة الحرب الباردة التي طويت صفحاتها ونُقلت إلى الأرشيف. لكن كوبا خالفت توقعاتهم دائماً، إذ استمر نموذج الحكم الاشتراكي في كوبا فترة أطول بعد الحرب الباردة من تلك التي عاشها قبل سقوط الاتحاد السوفياتي (1991). مع ذلك، فإن صورة كوبا في أذهان أغلب الناس بقيت ـــ بفعل البروباغندا الأميركية ـــ كجزيرة عالقة في نوستالجيا تاريخ مضى بعيداً عن حقيقة مجتمع حيّ، شجاع، ملهم، دائم التطوّر والتكيّف، ومتمسّك بعناد باستقلال كسبه بالإرادة والنّضال رغم العداء الأميركي الشرس.
هيلين يافي، بروفسيورة جامعية بريطانيّة (من جذور كوبيّة) تقدّم في كتابها «نحن كوبا» (We are Cuba ـــــ منشوات جامعة ييل ـــ 2020) فرصة نادرة للإطلالة على الحالة الكوبيّة من دون الوقوع في فخ الاستقطاب الأيديولوجي والانحراف المصطلحي في وصف ما يرتبط بها، وبالتالي محاولة تفكيك طلاسم صمودها خارج الشعارات والتنميطات الجاهلة، إذ أن كل تحليل حول كوبا يمكن أن يبدو للبعض نقيض الواقع، اعتماداً على التموضع الأيديولوجي للمتلقّي. ويروي الكتاب ـــ بالإفادة من شهادات وقصص حياة مجموعة متنوعة من الناس في كوبا ـــ استجابة مجتمعهم لكارثة توقّف الدعم السوفياتي عند إطلاق بيريسترويكا غورباتشوف وانهيار الكتلة الشيوعيّة في أوروبا بداية التسعينيات من القرن الماضي. وفق يافي، فإن كوبا ليست حكومة وأهالي، أو دولة وشعباً. فالمواطنون يشاركون بشكل مباشر في نظام الحكم، ويساعدونها على التحدي والتكيّف في وجه الضغوط الخارجية. وحيث يقدّم الغرب كوبا راكدة وشعباً يائساً يحكمه مستبدون، ترى يافي انخراطاً شعبياً في المواجهة وتجديداً جماعياً مستمراً في طرائق السعي لتحقيق النمو جنباً إلى جنب مع العدالة الاجتماعية، وكيفية تحقيق التوازن بين التخطيط الاقتصادي وقوى السوق، واختبار أشكال الملكية المتوافقة مع الاقتصاد الاشتراكي. تظهر الدولة هنا كمؤسسة بحث تعمل بلا كلل على إيجاد حلول مختلفة لهذه القضايا مع مرور الوقت، بينما تستجيب للتحولات في الظروف الاقتصادية العالمية والجغرافيا السياسية.
كانت موسكو لسنوات طويلة المصدر الرئيس لدخل كوبا: فقد دفع السوفيات ثلاثة أضعاف سعر السوق مقابل السكر الذي مثّل في وقت ما 80 في المئة من صادرات الجزيرة. وقد استغلت الولايات المتحدة مرحلة توقف الدّعم السوفياتيّ لتشديد الخناق السياسي والاقتصادي على هافانا، وعززت الحصار عليها من خلال قوانين جديدة (الديمقراطية الكوبية لعام 1992 وقانون هيلمز بيرتون لعام 1996). وقد تسبب تلاقي الضغطين في نقص حاد في إمدادات الوقود أجبر الدّولة على فرض تقنين قاسٍ، واختفت الأدوية من الصيدليات، وانتشر الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35 في المئة في غضون ثلاث سنوات، وهي مستويات ترتبط عادة بالحرب أو الكوارث الطبيعية. وقد ردت الحكومة وقتها بخفض الإنفاق العسكري إلى النصف مع زيادة الإنفاق الصحي والمعاشات التقاعدية الحكومية، وتم تحديد أسعار السلع الأساسية لمساعدة الناس على الحصول عليها. ولكن بما أنه كان لا بدّ من دفع ثمن الواردات بالعملة الصعبة، فقد تدهورت مالية الدولة على نحو غير مسبوق. وعلى المستوى الفرديّ بالنسبة إلى معظم الكوبيين، كانت التسعينيات بالفعل عقداً كارثياً. فبين عامي 1989 و1993، انخفضت الأجور الحقيقية بمقدار النصف وتقلّص استهلاك الأسر المعيشية بمقدار الثلث، ودفع اليأس الآلاف إلى محاولة الفرار إلى فلوريدا القريبة على متن القوارب (يحصل الكوبيون الفارّون من بلادهم على الإقامة في الولايات المتحدة بسهولة). كما شهدت هافانا في آب (أغسطس) 1994، أول تظاهرة مناهضة للحكومة منذ الثورة. ومع ذلك، فقد تفادت كوبا التضخم المفرط والبطالة التي صاحبت سقوط أنظمة الحكم الشيوعيّة في أوروبا الشرقية، وشرع الاقتصاد الكوبي بالتعافي تدريجاً في العقد التالي: ففي الفترة بين عامي 2002 و2007، بلغ متوسّط نمو الناتج المحلي الإجمالي 7 في المئة، أي ضعف مستوى أميركا اللاتينية ككل تقريباً. ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى دعم فنزويلا من خلال النفط، لكن بشكل أساسي فقد أُعيد تشكيل بنية الاقتصاد لتقليل الاعتماد على صادرات السكّر، وتمكّنت كوبا من إيجاد مصادر أخرى للدخل بفضل التخطيط الاقتصادي والاستثمارات طويلة المدى التي قامت بها قبل فترة طويلة من غياب الدعم السوفياتي.
التزمت الحكومة الثورية منذ وقت باكر بالاستثمار بكثافة في الطب
ومع ذلك، لم تكن جميع مصادر الدّخل الجديدة في كوبا مفيدة للجميع بشكل متساوٍ، إذ أنشأت السلطات، وحدة نقد بيزو كوبي موازياً للعملة المحليّة وقابلاً للتحويل للوقوف في وجه الدولار الأميركي كوسيلة للسحب بالعملة الأجنبية. وقد نجح ذلك بشكل عام، ولكنه تسبب في انقسام الاقتصاد فعلياً إلى قسمين: بينما تدفع القطاعات العامّة الرواتب والمعاشات التقاعدية بالبيزو المحلي، يكسب العاملون في القطاع الخاص ـــ لا سيّما في القطاع السياحي ـــ بالبيزو القابل للتحويل، ما خلق تفاوتات مهمة.
الديناميكيّة الكوبيّة لم تكتفِ بالسياحة كمصدر دخل وحيد، إذ التزمت الحكومة الثورية منذ وقت باكر بالاستثمار بكثافة في الطب. يتوافر في كوبا الآن نظام رعاية صحية شامل يضم ثمانية أطباء لكل ألف شخص ـــ أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف كثافة الأطباء في المملكة المتحدة ـــ وكليات تدريب طبي تجذب الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة مجاناً. والكوادر الطبيّة الكوبيّة مصدر دخل وأصول ديبلوماسية في آن واحد: فقد تم نشرهم في العام الماضي في أكثر من أربعين بلداً من البلدان المنكوبة بكوفيد 19 (بما فيها عدّة دول أوروبيّة)، وتوازيهم صناعة التكنولوجيا الحيوية المتقدّمة التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للدخل في البلاد بعد صادرات النيكل. وابتكر العلماء الكوبيون لقاحات لالتهاب السحايا والتهاب الكبد، فضلاً عن لقاحات واعدة لبعض أشكال السرطان. وكوبا هي البلد الوحيد في الأميركيتين ـــ إلى جانب الولايات المتحدة ـــ الذي طوّر لقاحات مضادة لكوفيد 19، وتجري الحكومة محادثات مع عدة بلدان في الجنوب بشأن تزويدها بكميّات ضخمة منها تعوّض النقص في اللقاحات الغربيّة التي يتم توزيعها وفق أولويات سياسيّة واقتصادية محضة.
وفي عام 2017، أعلنت كوبا عن خطة مدتها مئة عام لمعالجة أثر تغير المناخ على الجزيرة. وقد تولى عشرات الآلاف من الكوبيين استبدال أكثر من تسعة ملايين مصباح متوهج من جميع أنحاء الجزيرة بمصابيح موفرة للطاقة في غضون ستة أشهر. وهذا يعكس النهج الكوبي التقدّمي: مزيج من الأهداف الطموحة، والتعبئة الجماهيرية والنتائج الممتازة.
لكن حقيقة أن النظام الاشتراكي الكوبي (11 مليوناً من البشر) يسبح في بحر من الاقتصاد الرأسمالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، عنت أنّ معضلات التعامل مع السوق الدولي بقيت قائمة، لا سيّما في ظل الحصار الأميركي المتصاعد والمتذاكي. كما كان هناك في الخلفيّة دائماً قلق من كيفية انتقال القيادة بين جيل المحاربين القدامى وأولئك الذين ولدوا في الحريّة، وهو أمر طالما شغل بال الزعيم المؤسس فيديل كاسترو. وقد نجح المجتمع الكوبي في عبور الأسوأ. فقد تولى راؤول كاسترو إدارة الأمور لفترة انتقاليّة بعد مرض فيديل ووفاته، قبل تسليمه الأمور كليّة للجيل الجديد، بداية من منصب رئاسة الدولة وانتهاء بمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي. تلك التجربة السلسة في الانتقال السياسي، رافقتها سلسلة من الإصلاحات والتجارب الاقتصاديّة والاجتماعيّة بعد عملية تشاور شارك فيها ملايين المواطنين وشكلت مرحلة جديدة في تطور النموذج الكوبي في 300 مساحة: التعاونيات الزراعية، والتجارة الخارجية، وميزانيات التعليم، وترخيص المطاعم، والمرتبات الحكوميّة، والمبيعات الخاصة للشقق والسيارات وغيرها، في تحول واقعيّ من اقتصاد تديره الدولة بأغلبية ساحقة إلى اقتصاد هجين تتعايش فيه القطاعات الحكومية والخاصة، والتخطيط الاقتصادي وقوى السوق مع إعطاء الأولوية دائماً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وليس للنمو السرطاني لمجرّد الربح.
جلب انتخاب دونالد ترامب رئيساً من 2017 شؤماً على الجزيرة، إذ تبنّت إدارته موقفاً أكثر عدائية وتصلباً: فقد صعّد البيت الأبيض خلال السنوات الأخيرة إجراءات الحصار الاقتصادي، وأعاد فرض القيود على السفر ومُنعت التحويلات المالية (رغم استثناء الكنائس والمنظمات الإنجيليّة التي تحصل على دعم أميركيّ سخيّ من ذلك لإبقاء الرجعيّة حيّة بين السكان). ولكن الصدمة الأقسى كانت مترتبات وباء كوفيد 19. إذ تراجعت السّياحة بأكثر من 94 في المئة، وتوسع الفارق بين البيزو القابل للتحويل (المعادل للدولار الأميركي) والبيزو المحلي لأكثر من 25 ضعفاً، في حين ظل القطاع العام عموماً عالقاً في فخ الدّخل المنخفض. وفي الوقت نفسه، يترتب على الحكومة أن تدفع أسعار السوق العالمية للسلع المستوردة بما في ذلك المواد الغذائيّة والتي بدون دعم حكوميّ لا يمكن لأحد يتلقى راتباً بالعملة الوطنية أن يتحمل تكاليفها الحقيقيّة. لقد شكل كل هذا ضغطاً شديداً على اقتصاد الدّولة وتسبب في تراجع الناتج المحلي خلال 2020 بـ 11 في المئة، وتوسعت دائرة الفقر مجدداً. ومما زاد الطين بلة، في وقت باكر من هذا العام أن بدأت حالات كوفيد 19 في الارتفاع وإن كانت لا تقارن ببقية دول العالم (الوفيّات في المملكة المتحدة عشرين ضعف معدل كوبا).
لا تحجم يافي عن التحدّث عن المصاعب التي سيتعيّن أن تستمر معاناة الكوبيين منها في المستقبل القريب والمتوسط، وأيضاً جشع بعض الأفراد الأنانيين الذين لا يريدون الالتزام بتكلفة النضال الشخصيّ لأجل المجموع ويفضلون حلولاً فرديّة سحريّة من خلال الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. لكن هذا الشعب الصغير الجميل، بأغلبيته، قد حسم خياره منذ بعض الوقت: فهو لا يريد الرأسماليّة، وسيقاتل من أجل حريته واستقلاله. ولفترة طويلة، ستستمر كوبا في تحدي توقعات الصحافيين المرتزقة والبلهاء، والتصدي للعداء الأميركي، وإطلاق العنان لإمكانات ناسها وإبداعاتهم من دون سقوف، ولن يكفّ الاستثناء الكوبيّ على أن يكون استثناء في أيّ وقت قريب.


