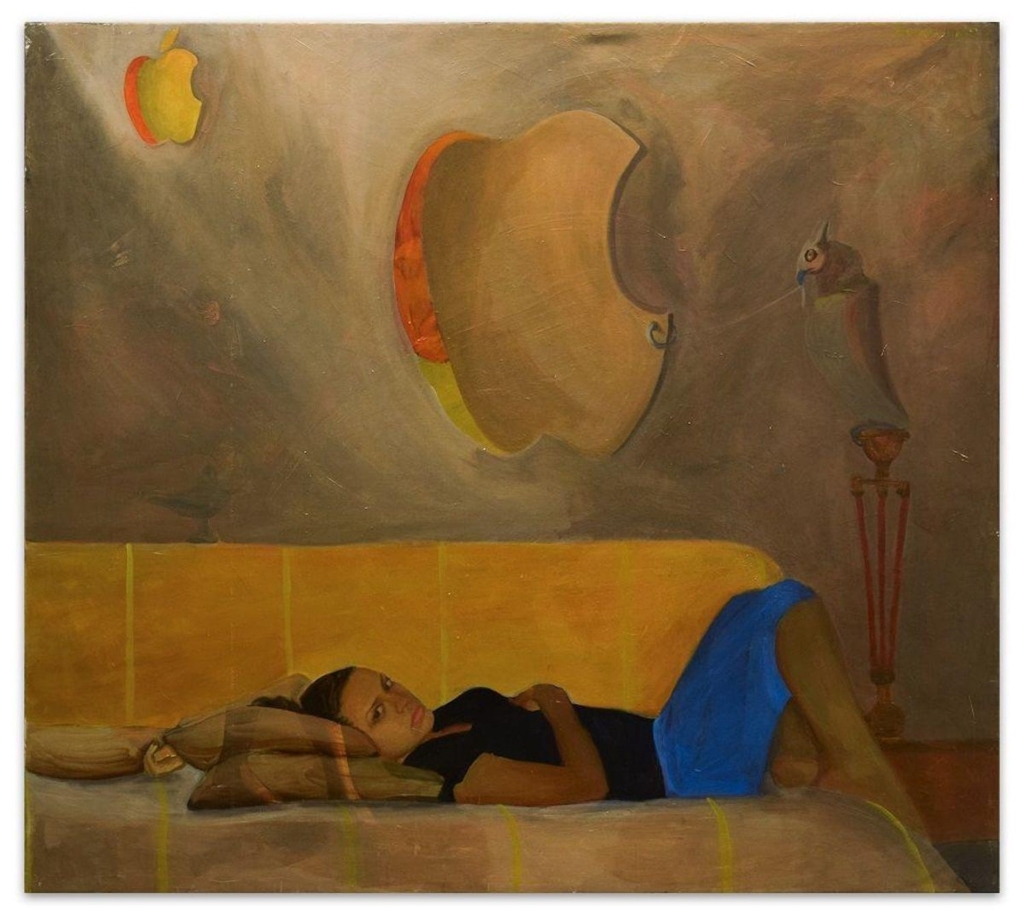
يسعى مؤسّس المجلة إلى إشعاع يتجاوز حدود تونس. ففي مستهلّها، نجد تعريف المجلة على النحو التالي «مجلة ثقافية تونسية الهوى، عروبية التوجه». كما أنها مفتوحة لكلّ الأقلام، في توجه يعكس ربما الرغبة في الانفتاح وتوسيع دائرة القراء وتنويع المواضيع، لكنه يعرّي أيضاً هاجس المصاعب المالية التي قد تحول دون انتداب أقلام صحافية في المجلة إلى جانب الكتابات الطوعية.
كل فقرات المجلة بمقالاتها، جمعها صاحبها لينشرها على موقع منشأ على word press، وهنا أيضاً تتّضح أزمة إمكانيات مادية حالت دون اعتماد موقع مهني يكون له وجود فعلي ديناميكي على محركات البحث.
في حقيقة الأمر، فإنّ هذه الأزمة الاقتصادية ما فتئت تفتك بالصحافة المكتوبة وتخنق الصحف والمجلات حتى تحول دون استمرارية بعضها أو الاكتفاء على أقصى تقدير بنسخة الكترونية في ظلّ غياب الدعم والإعلان العمومي وعزوف القارئ عن اقتناء الورقي أمام استبداله بالتكنولوجيا والنسخ الرقمية. لكنّ الصحافة الإلكترونية أيضاً ليست في منأى عن هذه الأزمة. رغم سهولة وصول الرسالة من خلالها، إلّا أنّها تتطلّب مصاريف من قبيل سعة الإنترنت وأجور الصحافيين ومصممي المواقع والمدقّقين اللغويين وغيرهم.
ولعلّ امتناع الدولة عن مساعدة الجرائد والمجلات الورقية والإلكترونية، ينمّ أيضاً عن رغبة في قمع صحافة الجودة، باعتبارها على حدّ تعبير هابرماس مورداً أساسياً من موارد المجال العمومي الديمقراطي، ولأن الحراك الفكري يمثّل المنبع الأول للثورة والحراك الاجتماعي.
ويتمثّل الشق الثاني من الأزمة في اكتفاء الصحافة الثقافية في أغلب الأحيان بالإخبار والوصف المفعم شاعريةً إلى حدّ التماهي مع الأعمال الفنية من دون الخوض في تعبيراتها ومدارسها، إضافة إلى غياب عنصر النقد الفني عنها. وهنا يجب أن نشير إلى أن النقد الفني أحد أعمدة الصحافة الثقافية. فهو يمكّن المتلقي من الفهم وفك شفرات الرسائل إذا ما استعصت عليه، ووضع العمل الفني في سياقه التاريخي وبسط التيارات الفكرية والأيديولوجيات المعاضدة والمخالفة له، والربط بين مختلف المدارس. وبالتالي، فإنّ غيابه قد ينفي عن الصحافة الثقافية صفة الاختصاص. ويجد القارئ نفسه إزاء مبدأ الثالث المرفوع، فإمّا أن تحمل المقالات هجاء كقصائد ابن الرومي، أو مدحاً يشابه قصائد المتنبي، وليس عملاً صحافياً قوامه الموضوعية والدقة والوضوح في الكتابة، وهذا لا ينسحب طبعاً على كلّ الإنتاجات الصحافية ولكنّه يشمل معظمها للأسف.
ثم إنّ الصحافة الثقافية تشكو ضبابية في تمثل بعض المفاهيم على غرار مفهوم المثقف الذي عرّفه إدوارد سعيد بمزاوجة بين تعريفَي «المثقف البطل» و«المثقف المثالي». أوّل التعريفين لأنطونيو غرامشي بفكرة المثقف العضوي الذي يعتبر أن وظيفة المثقف أو المفكر في المجتمع لا يقوم بها كل الناس، وثانيهما لجوليان بيندا الذي يرى أن المثقفين الحقيقيين هم من يشكلون طبقة العلماء والمتعلمين النادرين.
واستناداً إلى هذا التعريف يضطلع المثقف بوظيفة توعوية ومراكمة معرفية ضمن سياق اجتماعي وسياسي واقتصادي معين ليؤدّي إلى طفرة فكرية. ومن أجل ذلك، يطلق على المثقفين لفظ «طبقة» استناداً إلى تحليل ماركسي يقرّ باشتراك هذه الفئة في ظروف الإنتاج إن صح التعبير.
ضبابية في المفاهيم على غرار مفهوم المثقف الذي عرّفه إدوارد سعيد بمزاوجة بين تعريفَي «المثقف البطل» و«المثقف المثالي»
وإذا سلّمنا بالفكرة السابقة فإنّه ليس بإمكان كلّ محرّر ثقافي الإلمام بالثقافة والمعرفة الكافية، وهنا تبرز حاجة الصحافة الثقافية للمحرر المثقف أيضاً أكثر من حاجتها لمالكي قواعد النقل والأخبار أحياناً. أضف إلى ذلك المغالاة في قذف المصطلحات والمفاهيم المجردة والمبهمة على جسد المقالات حتى تتوه المعاني عن القارئ. تعقيد مردّه الاعتقاد السائد بأن وجود المجلات الثقافية كان من أجل القراء المثقفين دون سواهم، وهي لا تلقى إقبالاً إلّا لدى هذه الفئة. ويبدو أن الصحافيين المتخصّصين في المجال أنفسهم صاروا يتبنّون هذه الفكرة.
وإن تراجع دور «الأراذل» كما كان أنور السادات يسمّي المثقفين حنقاً أو كما يقول جوزيف غوبلز - وزير الدعاية النازية - عنهم «كلّما سمعت كلمة مثقف تحسّست مسدسي» نحو الالتصاق بالسياسة والسياسيين أحياناً، كان عاملاً آخر من عوامل تراجع مكانة الصحافة الثقافية، حيث لم يعد المثقف مساهماً في الارتقاء بالوعي الجمعي لمقاومة سلطة رأس المال أو حتى ليكون سداً منيعاً أمام رسائل إعلام المجاري و«شعبوية» ما تروّج له مواقع التواصل الاجتماعي.
لقد أشاحت الثقافة بوجهها عن المثقفين وأفسحت المجال نحو انكشاف أزمة معرفية عميقة وعجز عن التطوير والتطور والتأثير والتأثر. فلا تتوقف تمظهرات ما ذكرنا عند إبداء الآراء في المنابر الإعلامية، إنما تتجاوزه نحو الكتب والمقالات السخيفة والمأجورة في بعض الأحيان. كما أنهم لم يكوّنوا رؤية مغايرة للقضايا المطروحة اليوم. في حين كان المثقف في ما مضى يوجه ويشكل الرأي العام ويرفع درجات الوعي ليكون في الصفوف الأمامية دفاعاً عن قضايا مجتمعه، فإنّنا اليوم إزاء تبعية المثقفين للسلطة وتعليل تقصيرهم الدائم بضآلة دعم وزارة الثقافة.
* athagafia.blogspot.com


