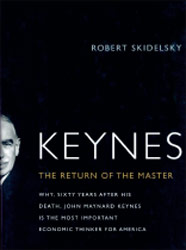جوزيف ستيغلتز *
أُشاطر روبرت سكايدلسكي وجهة نظر مفادها أن معظم اللوم في الأزمة يجب أن يُلقى على الذين لم يجيدوا العمل بتاتاً في كلٍّ من تخصيص رأس المال وإدارة المخاطر في الأسواق المالية (وهما مسؤوليتاهما الأساسيّتان). ولكنّ قدراً كبيراً من اللوم يقع أيضاً على خبراء الشؤون الاقتصادية. فالفكرة التي تقدّم بها الاقتصاديون ـــــ بأنّ الأسواق فعّالة وتكيّف نفسها بنفسها ـــــ أراحت المكلّفين بمهمة الضبط أمثال ألان غرينسبان، الذي لم يكن يؤمن بها في البداية. فدعموا حركة إلغاء الضوابط التي حقّقت أسس الاستقرار المالي في العقود التي تلت الكساد الكبير؛ وأعطوا الحق لأولئك الذين عارضوا القيام بأيّ إجراء حيال المشتقّات المالية حتى بعدما كُشفت المخاطر في الأزمة المتعلقة بإدارة رأس المال على المدى الطويل عام 1989، أمثال لاري سامرز وروبرت روبن، وهما وزيرا الخزانة الأميركيان في عهد بيل كلينتون.
يجب أن نكون واضحين في هذا الصدد: فالنظرية الاقتصادية لم توفّر يوماً دعماً كبيراً لوجهات النظر تلك، القائلة بالسوق الحرة. فالنظريات المتعلقة بالمعلومات غير الكاملة وغير المتساوقة في الأسواق قوّضت كل عقيدة من عقائد «السوق الفعالة»، حتى قبل أن تصبح رائجة في حقبة ريغان ـــــ تاتشر. كنّا، بروس غرنواد وأنا، قد شرحنا أن يد آدم سميث لم تكن في الواقع غير مرئية. وكنّا، سانفورد غروسمان وأنا، قد شرحنا أنه لو كانت الأسواق فعّالة في نقل المعلومات بقدر ما يزعم مؤيدو السوق الحرة، لما كان أحد قد امتلك أيّ دافع لجمعها ومعالجتها. فمؤيدو السوق الحرة والمصالح الخاصة التي أفادت من عقائدهم، لم يولوا تلك الحقائق المزعجة الاهتمام الكافي.
فيما كان الاقتصاديون، الذين انتقدوا نموذج السوق الحرة السائد، لا يزالون يستخدمون، في معظم الأحيان، نماذج بسيطة من التوقعات «العاقلة» (أي افترضوا أن الأفراد يستخدمون «بطريقة عاقلة» كل المعلومات التي تتوافر لديهم) لأنّ ذلك يلائمهم، ابتعدوا عن النموذج السائد بافتراضهم أن الأفراد المختلفين يحصلون على معلومات مختلفة. فقد كان هدفهم أن يُظهروا أن النموذج القياسي ليس صالحاً عندما يحدث هذا القدر من التغيير الذي يبدو صغيراً للغاية ومنطقياً بوضوح. فقد أظهروا مثلاً أن الأسواق غير المقيّدة لم تكن فعالة، ويمكن أن تتميز ببطالة مستمرة. ولكن إذا كان أداء الاقتصاد على هذه الدرجة من السوء عندما تُدخَل مثل هذه التغيّرات الصغيرة الواقعية في النموذج، فما الذي يمكن أن نتوقعه إذا زدنا عناصر واقعية إضافية، مثل نوبات من التفاؤل والتشاؤم غير العاقلين، و«حالات الذعر والهوس» التي تتفجر بطريقة متكرّرة في الأسواق عبر العالم أجمع؟
حتماً لم يضطر المرء إلى الاعتماد على التفاصيل النظرية الدقيقة لانتقاد الإيمان بالأسواق غير المقيدة. فقد مثّلت الأزمات الاقتصادية والمالية سمة دورية في اقتصاديات رأس المال؛ ولم تخلُ منها تماماً إلاّ الحقبة التي شهدت ضبطاً مالياً قوياً بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن مع إبعاد الضوابط عن السوق المالية، أصبحت الأزمات أكثر شيوعاً: فقد مررنا بأكثر من 100 أزمة في غضون الـ30 سنة الماضية.
يجب أن تدفن الأزمة الحالية أيّ اعتقاد بوجود أسواق «عاقلة». فالتصرفات غير العاقلة الواضحة في أسواق الرهن العقاري، وفي التسنيد، وفي المشتقات وفي العمليات المصرفية، تذهل العقل؛ ساحرونا الماليّون المزعومون قد اعتمدوا سلوكاً بدا «غبياًً» حتى في تلك الحقبة. إن شئنا تصميم سياسات تمنع الأزمات أو تعالجها لدى وقوعها، فمن الضروري أن نفهم العيوب الكبيرة في النموذج المعياري. هنا تحديداً يخطئ سكايدلسكي.
يولي سكايدلسكي اهتماماً بالغاً للتمييز بين المخاطرة والريبة. فالمخاطرة (Risk) تشير إلى حالات نملك فيها بيانات إحصائية جيدة، فنستطيع أن نتكلم بوضوح عن احتمال وقوع حدث معين، مثل احتمال موت رجل يبلغ 70 عاماً من العمر في خلال السنة المقبلة. أمّا الريبة (Uncertainty)، فتشير إلى الحالات التي لا نملك فيها أي قاعدة إحصائية نستطيع الانطلاق منها. من الواضح أن المصارف الاستثمارية ووكالات التصنيف اعتمدت اعتماداً مفرطاً على نماذج إحصائية خاطئة، كما فعل المتحكّمون بالضبط (Regulators). وجعلتهم هذه النماذج يثقون بأنّ خطر حدوث مشكلة حقيقية يكاد لا يُذكر، فهو أمر قد يحدث مرة كل مليون سنة.
ولكنّ قدراً كبيراً من السلوك الذي قاد إلى الأزمة (الإقراض غير العاقل والنهّاب أحياناً، والإفراط في استخدام الرافعات المالية وغيرها من أشكال المجازفات) لم يرتبط بهذا التمييز. فالأهم مثلاً كان الحوافز التي شجعت المصارف على المجازفة بقوة، وحثّتها على عدم التفكير بالعمق في نماذجها الإحصائية. الحوافز الخاطئة، والضبط غير الملائم، وغياب الأخلاقيات كلها عناصر ساعدت أيضاً على تفسير ممارسات الإقراض الفاسدة التي أدت دوراً كبيراً للغاية في الأزمة.
لاستعراض الأزمة، علينا أن نشرح الفقّاعة والسبب الذي جعل الاقتصاد يشهد كساداً عميقاً بعدما انفجرت هذه الفقّاعة، كما علينا أن نشرح عملية تخصيص رأس المال (Allocation of Capital) غير الفعّالة بتاتاً، والمستوى العالي من التطاير واستمرار البطالة. ولسوء الحظ أن التمييز بين المخاطرة والريبة لا يمكّننا كثيراً من تفسير حالات الفشل في سوق العمل: فلماذا قوانين العرض والطلب المعيارية، التي يجب أن تثمر عمالة كاملة، لم تكن فعّالة؟
مع إبعاد الضوابط، أصبحت الأزمات أكثر شيوعاً: 100 أزمة في الـ30 سنة الماضية
ينبغي أن يكون واضحاً أن فشل الأسواق المالية هو في محور الأزمة، ولكن كما يشير سكايدلسكي، كينز نفسه لم يتكلم كثيراً على الأسواق المالية وإدارتها وضبطها. وأحد الانتقادات التي توجَّه إلى النظرية العامة هو تناولها المبسّط لأسواق رأس المال (أُحرز بعض التقدّم في تصحيح ذلك على امتداد الـ75 سنة الماضية). وبالتالي، يمكن القول إنّ وجهات النظر التي قدمها كينز كانت أهميتها محدودة في هذه الأزمة، من دون الكلام على شكوكه عموماً في قدرة الأسواق على إصلاح نفسها بنفسها. إلّا أن وجهة نظر كينز تلك خاطئة لأن هذه الأزمة هي اقتصادية بقدر ما هي مالية: فهناك عدم كفاية في الطلب العالمي الإجمالي. وشرحُ سبب ذلك أصعب مما يبدو أن سكايدلسكي يقترحه؛ فليست المسألة مسألة صفة الريبة المتأصلة في المستقبل. وفق النظرية الاقتصادية المعيارية ـــــ نظرية العرض والطلب التي تُدرَّس في المعاهد حول العالم ـــــ إذا كانت الأسعار (بما فيها ثمن اليد العاملة أو الأجور، وثمن رأس المال أو معدّل الفائدة) تتمتع بمرونة كاملة والأسواق تعمل كما يجب، فحتى في مثل هذه الحالة من الريبة، يجب أن تتوافر عمالة كاملة. قد لا تكون الأجور أو معدلات الفوائد هي نفسها كما في حال انتفاء الريبة هذه، ولكن مع ذلك ستستمر الأسواق في توفير عمالة كاملة على الأرجح. لكن الأسواق في الأنظمة الرأسمالية لا تعمل بهذه الطريقة، والسؤال هو لماذا؟ لا يقدم سكايدلسكي توضيحات كثيرة في هذا الشأن، ولا يذكر حتى ما كان يمكن لكينز أن يقوله بهذا الخصوص. أولئك الذين يعدّون أنفسهم اليوم من أتباع تقليد كينز ـــــ ولا سيما في تأييد وجهة نظره القائلة إنّ تدخّل الحكومة لازم للمساعدة على القضاء على البطالة ـــــ يُشار إليهم بتسمية الكينزيّين الجدد. وحسب أحد التيارات المنحرفة عن الكينزية (الجديدة)، فإنّ البطالة تستمر لأن الأسعار والأجور متصلّبة، ولا يصعب على المرء أن يفهم سبب انجذاب اقتصاديين كثر إلى هذه النظرية. ففي نموذج العرض والطلب المعياري، إذا توافر عرض مفرط من اليد العاملة (أي بطالة)، فلا بدّ من أن يكمن السبب في أن الأجور (الحقيقية) مرتفعة للغاية. وقد لا تسيء هذه النظرية تفسير كينز وحسب، بل قد تكون خطيرة أيضاً بسبب تبعاتها السياسية الواضحة. فإذا أتت البطالة نتيجة ارتفاع مفرط في الأجور الحقيقية، يكمن علاجها البديهي في خفض الأجور. ومن هنا الدعوة التي يطلقها عادةً الاقتصاديون المحافظون إلى مزيد من «المرونة في سوق العمل»، مؤكدين أن أجور العمال ـــــ التي عرفت حالة ركود لمدة ربع قرن من الزمن في الولايات المتحدة ـــــ سوف تتراجع أكثر بعد. ولكنّ الاقتصاديين الكينزيين التقليديين يقولون إن المهم هو الطلب الإجمالي، وإنّ أجوراً أدنى تخفص الطلب الإجمالي. وتظهر الأزمة الحالية ما الذي يمكن أن يحدث: الدول التي تتمتع بأنظمة حماية اجتماعية أقوى، ومقدار أقل من مرونة سوق العمل، كان أداؤها أفضل من سواها.
معالجة سكايدلسكي لمختلف التفسيرات التي توصّل إليها الاقتصاديون، في ما يخص تصلب الأجور والأسعار من جهة، والسبب الذي يمنع الاقتصاد من التكيّف بسرعة لبلوغ «التوازن» من جهة ثانية، كانت في المطلق وأتت غير متبصرة إلى حد بعيد. فهناك مثلاً نظرية سخيفة تقول إن الأسعار متصلّبة بسبب تكاليف تغيير قوائم الأسعار (يمكن اعتبار كلفة طبع لوائح طعام جديدة في المطاعم مثالاً على ذلك)؛ ولكن هذه التكاليف تبدو ضئيلة للغاية مقارنةً بتكاليف استخدام العمال وطردهم أو زيادة الإنتاج أو خفضه. ولم يولِ سكايدلسكي اهتماماً كبيراً لنظريات أخرى أصبحت مقبولة بشكل أوسع منذ رحيل كينز. فنظرية فعالية الأجر، التي تقول إن الأجر يؤثر في الإنتاجية، وإن الشركات بالتالي لا تفيد من دفع أجور متدنية، لم يؤتَ حتى على ذكرها.
وثمة وجهة نظر بديلة (تُصنَّف أيضاً بأنها كينزية جديدة) تتعلق بالسبب الذي يؤدي إلى وقوع اقتصاد ما مدة طويلة جداً في شرك استخدام الموارد أدنى من الحد المطلوب: نظرية انكماش الدَّين التي أطلقها أولاً الأميركي المعاصر لكينز، إيرفينغ فيشر، وطوّرناها غرينوولد وأنا في ما بعد. فهي ترى أن حالات فشل السوق الأساسية لا تكمن في سوق العمل فحسب، ولكن أيضاً في الأسواق المالية. لأن العقود ليست مفهرسة بالشكل المناسب (أي إنّ المدفوعات غير مكيّفة مع الظروف الاقتصادية المتغيّرة)، فيمكن التغيّرات في الظروف الاقتصادية أن تسبّب سلسلة متلاحقة من حالات الإفلاس، والخوف من الإفلاس يسهم في تجميد أسواق القروض. ويؤثر الخلل الاقتصادي الناجم عن ذلك في الطلب الإجمالي والعرض الإجمالي معاً، وليس من السهل التعافي من هذه الحالة ـــــ وهذا أحد الأسباب التي تجعل توقعاتي للاقتصاد على المدى القصير سوداوية إلى هذا الحد.
لقد ركز كينز، كما قلت، على المشاكل التي يسببها عدم كفاية الطلب الإجمالي: ما الذي يحدث عندما يريد الناس أن يشتروا أقل مما يستطيع الاقتصاد إنتاجه. حتى منذ 75 سنة، نظر إلى المسألة من منظور شامل. فقد كان يهتم مثلاً بتأثير دول الفائض ـــــ تلك التي تنتج أكثر مما تستهلك ـــــ في الطلب العام. اليوم نتكلم على اختلال توازنات عالمية. فاختلالات التوازن المتزايدة في السنوات العشر الأخيرة تُرَدّ جزئياً لما حدث في أزمة شرق آسيا التي وقعت ما بين 1997 ـــــ 1998. فالدول التي لم تملك احتياطيات مناسبة خسرت سيادتها الاقتصادية عندما أسرعت الخزينة الأميركية وصندوق النقد الدولي إلى «إنقاذها» (أو بكلام أدق أسرعا إلى إنقاذ مصارفهما الخاصة ـــــ تلك المصارف نفسها التي كانت قد سبّبت مثل هذا الخراب لأنظمتها الاقتصادية الخاصة). فقد فرضت سياسات نقدية ومالية متناقضة ـــــ معدلات فوائد أعلى، خفوضات في الإنفاق ـــــ على تلك الدول، وهي عكس السياسات التي اعتمدتها الولايات المتحدة في الأزمة الحالية. ولا يفاجَأ المرء بأن هذه السياسات المتناقضة قادت إلى حالات انهيار وكساد. فقامت الدول النامية حول العالم بمراكمة احتياطيات هائلة لتقليص احتمال اضطرارها إلى الاستنجاد مجدداً بصندوق النقد الدولي والغرب. ولكن فيما يمكن أن تكون هذه المدخرات الوقائية قد وفّرت لها نوعاً من الأمان، فإن المال المدّخر ليس مالاً منفقاً: فهو يسهم في نقص الطلب الإجمالي، كما أن عوامل أخرى تسهم في بناء الاحتياطيات، فمعدّلات الصرف المنخفضة يمكن أن تساعد على تعزيز الصادرات. وعلم مصدّرو النفط أن الاحتمال كبير بألّا تبقى الأسعار في المستوى المرتفع الذي بلغته، فاقتضى الخيار الحذر ادّخار قسم كبير من المال الذي كانت تكسبه. وفي النهاية، انخفض حتماً الطلب الإجمالي بسبب تفاقم اللامساواة بشكل هائل، وأعاد توزيع المال عملياً فأخذه من الذين يمكن أن ينفقوه ليضعه بين أيدي الذين لم ينفقوه، أو على الأقل لم ينفقوا قدراً كبيراً منه.
تسمح هذه العوامل بتفسير معدلات الادخار العالية. ولكن مشكلة عدم كفاية الطلب هي فعلاً مسألة توازن بين مدخرات واستثمار. وتوصف المشكلة أحياناً بأنها «تخمة في المدّخرات»، ولكن يمكن أن توصف أيضاً بأنها «ندرة في الاستثمارات». والسؤال المطروح هو لماذا بدا أن الاستثمار الوحيد الذي أمكن توليده، حتى مع معدلات فائدة منخفضة، تمثّل ببناء مساكن للأميركيين الفقراء الذين لا يستطيعون دفع تكاليفها؟ ثمة تقليد يسود منذ أمد طويل في الاقتصاد واتّبعه كينز، وهو التركيز على تدني فرص الاستثمار. والعمل الرائد الذي قدمه شومبيتر، أحد معاصري كينز كذلك، شدّد على دور الابتكار. فالعالم يواجه اليوم تحديات جدية تقدم أيضاً فرص استثمار: تجهيز الاقتصاد العالمي لكي يواجه تحديات الاحترار العالمي، أو توظيف القدر الكافي من الاستثمارات لخفض مستوى الفقر العالمي. لا نقص في فرص الاستثمارات ذات المردودات الاجتماعية العالية. في هذا المجال، سُجلت حالات الفشل في السوق وفي السياسة: مثلاً فشل الحكومات في جعل انبعاثات الكربون مكلفة ما فيه الكفاية لكي يتوافر حافز للاستثمار في خفضها، أو فشل الأسواق المالية في ابتكار أدوات أفضل لنقل المخاطر من أسواق الدول الأقل نمواً إلى أسواق تلك الأكثر تقدماً التي تستطيع امتصاصها بشكل أفضل.
الرسالة المحورية المرتبطة بالسياسة في الاقتصاديات الكينزية هي أنه يُرجَّح ألّا تكون السياسة النقدية فعالة في حالات الكساد العميق، والمطلوب هو تحفيز مالي. ويعود السبب في ذلك حسب الحجة ذاتها، إلى أن السلطات النقدية تجد صعوبة متزايدة في خفض معدلات الفائدة الحقيقية (حتى لو كانت معدلات الفائدة الاسمية تساوي صفراً، يمكن أن يعني الانكماش أن هناك معدل فائدة حقيقياً إيجابياً)؛ وحتى وفق معدلات فائدة منخفضة، قد لا يُحفَّز الاستثمار كثيراً. فالعملية غير متساوقة. عندما خُفضت معدلات الفائدة بعد انفجار فقاعة التكنولوجيا، تركّز الأثر خصوصاً على استثمار جنوني في العقارات. ولكن منذ عهد كينز، ازداد فهمنا لمحدوديات السياسة النقدية. فحتى لو نجحت المصارف المركزية في جعل معدلات سندات الخزينة تقارب الصفر مثلاً، تبقى معدلات الفائدة التي تستطيع المصارف أن تقرض وفقها مرتفعةً؛ ويُعتَرَف الآن بأن توافُر القروض لا يقل أهمية عن معدلات الفائدة، ولا سيما بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على قدرة المصارف على الإقراض واستعدادها لذلك. وهذا أحد أسباب هذا التركيز الشديد على تغيير هيكلة رؤوس أموال المصارف، وأحد الأسباب التي تدفع سياسة بوش/ أوباما إلى منح المال للمصارف، لكن السماح لها بدفعه على شكل أرباح وعلاوات لم ينعش الإقراض كما كان موعوداً. اليوم، قلة تنظر إلى السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد. وقد أتت مصارفنا المركزية بإنجاز أكثر تواضعاً: فبما أنها أوصلت الاقتصاد العالمي إلى حافة الكارثة، تمكّنت من تجنب انهيار كامل من خلال ضخ ما يكفي من المال في النظام المالي.
نجحت السياسة المالية، ليس في الحؤول دون حدوث ركود كبير، بل في منع الركود الكبير من التحول إلى كساد كبير آخر. إلّا أن الأعمال نفسها التي أنقذت اقتصادات العالم أثارت الآن مشكلة جديدة بالنسبة إلى السياسة المالية مع طرح تساؤلات عن قدرة الحكومات على تمويل حالات العجز التي تشكو منها. فثمة هجمات مضاربة ضد الدول الأضعف، التي تجد نفسها عالقة بين المطرقة والسندان. فهي تخشى أن تقود حالات العجز إلى معدلات فائدة أعلى، ليس لأن (كما يُقال عادةً) الإنفاق العام سوف يكون له أثر استبعاد الإنفاق الخاص، بل بسبب «علاوات المخاطر» المتزايدة. ولكن الأثر هو نفسه إلى حد بعيد: فزيادة الإنفاق الحكومي سوف تفرض خفوضات في الإنفاق الخاص، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية واضحة على الاقتصاد. إن الأسواق المالية التي سببت الأزمة ـــــ التي بدورها سببت حالات العجز ـــــ التزمت الصمت عندما كان المال يُنفَق على كفالات الإنقاذ؛ ولكنها تقول للحكومات الآن إنه يجب عليها تقليص الإنفاق العام. يجب خفض الأجور، حتى لو وجب إبقاء العلاوات المصرفية. الهوفريون ـــــ مناصرو السياسات ما قبل الكينزية التي وفقها يجب مواجهة حالات الانكماش بتقشف ـــــ يثأرون. ففي العديد من المواقع، بدا الكينزيون أنهم يتخلّون عن مشروعهم، بعدما استمتعوا بلحظة مجد نعموا بها منذ سنة لا أكثر.
لو كانت الأسواق عاقلة، لتوافر رد سياسي سهل. فالإنفاق على الاستثمارات التي أنتجت عائدات حقيقية معتدلة حتى (أي نسبتها من 5 إلى 6 بالمئة) كان ليخفض مستويات الدين الطويل الأمد؛ ومثل هذا الإنفاق يزيد الإنتاج على المدى القصير، وبذلك يكسب المزيد من عائدات الضرائب، وعائدات المستقبل تولّد المزيد من عائدات الضرائب. إذا كان بالإمكان إقناع الأسواق مثلاً بأن الحكومات الأوروبية سوف تفي بالتزامات دينها، ستتراجع معدلات الفائدة، وحتى الدول التي تمتلك أعلى مستويات من الدين سوف تجد أن الوفاء بالتزاماتها أمر سهل. ولكن الأسواق ليست عاقلة بالضرورة، وحتى عندما تكون عاقلة، ليست حسنة النيّة دائماً. فهدف هجمة المضاربة هو توليد أرباح للمضاربين، بغض النظر عن الكلفة التي يرتبها ذلك على سائر المجتمع. يمكنهم أن يحققوا الأرباح من خلال إحداث حالة ذعر، وبذلك يشعرون بالرضا عن «تبصّرهم»: فقلقهم كان مبرّراً، ولكن فقط بسبب الردود التي نتجت من أعمالهم.
المساهمة الأهم التي قدّمها كينز أنه أنقذ الرأسمالية من الرأسماليّين
منذ زمن كينز، ازدادت ازدياداً هائلاً قدرة الأسواق على إعداد مثل هجمات المضاربة هذه. ولكن الحكومات ليست عاجزة عن التخفيف من حدّتها، وتستطيع في بعض الحالات أن تقوم بهجمات مضادة، كما فعلت هونغ كونغ عندما أحبطت «لعبة هونغ كونغ المزدوجة»، لمّا قام المضاربون ببيع مكشوف في أسواق العملات والبورصة في الوقت عينه. عرف المضاربون أن الحكومات تردّ تقليدياً على الهجمات على الأسواق المالية من خلال رفع معدلات الفوائد، ما يخفض أسعار الاحتياطيات. فإذا فشلت هونغ كونغ في رفع معدلات الفائدة، فسوف يجنون المال من عمليات بيع مكشوف في أسواق العملات. وإذا رفعتها هونغ كونغ لإنقاذ عملتها، سوف يجني المضاربون الأرباح من خلال بيع مكشوف في البورصة. فاقتهم هونغ كونغ دهاءً برفع معدلات الفائدة ودعم البورصة بشراء أسهم في الوقت عينه. إن الضرائب على أرباح رأس المال على المدى القصير، والضوابط على أدوات المضاربة الأقوى من أي وقت مضى (مثل مقايضات التقصير الائتماني)، وفرض قيود على الحركة المتفلّتة من كل قيد للرساميل القصيرة المدى التي تعبر الحدود ـــــ ولا سيما بالنسبة إلى الدول النامية ـــــ كلها إجراءت يمكن أن تقلّص مجال هذا النوع من التصرف ونتائجه. أنشأ كينز الاقتصاد الكلي الحديث؛ وكما أشرت، لم يولِ اهتماماً للأسواق المالية. وبالتالي يمكننا فقط أن نخمّن ما كان يمكن أن يفكر فيه بالنسبة إلى واحدة من أهم مشاكل عصرنا: كيفية ضبط القطاع المالي بطرق تجعل تكرار الأزمة الحالية مسألة محتملة بدرجة أقل، وتزيد من احتمال قيام القطاع المالي بما يفترض به القيام به: إدارة المخاطر، وتخصيص رأس المال، وإدارة آلية المدفوعات، وكل ذلك بكلفة متدنية. في هذا السياق، تُعدّ وجهات نظر سكايدلسكي (الغارق تماماً في تعاليم كينز) أقل من مقنعة وبعيدة عن الاكتمال. فهو مثلاً يرتاب في عمليات الضبط التي تحاول أن تمنع الإقراض المفرط الذي يعرف رواجاً (ما يُدعى الإطار الضابط بدافع الحذر في الاقتصاد الكلي).
في ختام الكتاب تقريباً، يقول سكايدلسكي إن حجته الرئيسة «أنه في أساس التتالي المتصاعد للأزمات المالية التي شهدناها أخيراً هو فشل الاقتصاد في حمل الريبة على محمل الجد». وفي الختام، لا يتمكن من إثبات وجهة نظره. فالثقة المفرطة في النماذج الرياضية الخاطئة التي استخدمتها وكالات التصنيف والمصارف الاستثمارية كانت مسؤولة عن الكثير من الأخطاء لهذه الأزمة، ولا سيما في الولايات المتحدة. ولكن هذه النماذج أدت دوراً صغيراً ضمن المجموعة المتنوعة من الفقاعات والطفرات والانهيارات التي وسمت ربع القرن الماضي. فقد احتاجت المصارف الغربية مراراً إلى كفالات إنقاذ بسبب قرارات الإقراض السيئة التي اتخذتها.
لا يمكن أن نقرّ قوانين تضمن أن الناس لن يتحملوا تبعات التفاؤل أو التشاؤم غير العاقلين. ولا نستطيع حتى أن نتأكد من أن المصارف سوف تتخذ قرارات إقراض حكيمة. ولكن ما نقدر على القيام به هو أن نحرص على تحمّل الذين يخطئون عواقب قراراتهم بشكل أكبر ـــــ والآخرين بشكل أقل. يمكننا أن نحرص على ألّا يستخدم أولئك المؤتمنون على أموال الناس المالَ للمقامرة. ويصح هذا سواء كانت تلك القرارات تستند إلى نماذج مخاطر خاطئة أو إدراك غير عاقل للريبة. فقد عانى دافعو الضرائب والعمال والمتقاعدون وأصحاب المنازل في كل أنحاء العالم أخطاء الأسواق المالية الأميركية. هذا غير مقبول، ويمكن تجنّبه.
المساهمة الأهم التي قدّمها كينز أنه أنقذ الرأسمالية من الرأسماليين: فلو تصرفوا على هواهم، لكانوا قد فرضوا سياسات أضعفت الاقتصاد وقوّضت أسس الدعم السياسي للرأسمالية. لقد كانت الضوابط والإصلاح اللذان اعتُمدا في الحقبة التي تلت الكساد الكبير فعالين. فاتخذت الرأسمالية وجهاً أكثر إنسانية، وازداد استقرار اقتصاديات السوق. ولكن هذه الدروس نُسيت، فقد انطلقت تاتشر وريغان في حقبة جديدة اتسمت بانعدام الضوابط، وتفاقم اللامساواة وإضعاف الحماية الاجتماعية. ونرى الآن النتائج، وهي لا تقتصر فقط على حالة انعدام استقرار أعظم من ذي قبل. نحن بحاجة إلى أفكار كينز الآن إذا أردنا إنقاذ الرأسمالية من الرأسماليين مرة أخرى.
(عن نيويورك ريفيو أوف بوكس ـــــ ترجمة جورجيت فرشخ فرنجية)
* حائز جائزة نوبل في الاقتصاد