حسام تمامثمّ جاء الثاني (إضراب 4 أيار / مايو) بمثابة إهانة رمزية مقصودة للنظام باختيار يوم ميلاد الرئيس يوماً لإعلان الحداد وارتداء السواد!
أبرز ما في المشهد الجديد الاضطراب الكبير الذي وسم موقف قوى المعارضة التقليدية وجعلها تبدو عاجزة عن فهم هذه الحركات الاجتماعية الجديدة واحتجاجاتها المطلبية، ومن ثمّ التعاطي معها. وكان موقف الحركات الإسلامية التقليدية، إذا ما اتفقنا على كونها الأكثر جماهيرية، واضحاً في بيان المأزق الذي تعانيه في نظرتها للقوى الجديدة التي بدت كأنها أخذت منها زمام المبادرة والجرأة على الفعل في الفضاء العام، الذي كان قد استقرّ الأمر على تقاسمه بين النظام وبعض القوى التقليدية وعلى رأسها الإخوان المسلمون.
لن نتوقّف كثيراً عند ما أثارته بعض الهيئات الدينية شبه الرسمية أو بعض التيارات الصوفية أو حتى بعض رموز التيار السلفي ضد الحركات الاجتماعية الجديدة، التي وصلت إلى إصدار فتاوى دينية ضدّها إلى حدّ وصف قادتها بـ«الخوارج» و«رؤوس الفتنة»!
ولكن ما يستحقّ التوقف عنده هو موقف جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعات الإسلام السياسي، والقوة المعارضة الأولى في البلاد، الذي كان ــ أقل ما يوصف به ــ في غاية الالتباس والقلق، يتردّد ما بين رفض وتحفظ وتأييد خجول في أفضل الأحوال (كما في الإضراب الأول)، ثمّ تردّد وتأييد ما زال في نظر الكثيرين تعبيراً عن سياسة ردّة الفعل والانتهازيّة السياسية أقرب منه إلى إشارة لفهم الجماعة لهذه القوى الجديدة ورغبتها في التعاون معها. قبل محاولة فهم أسباب موقف الإخوان الملتبس من الحركات الاجتماعية الجديدة، من المهم التأكيد على أنه عرف عن الإخوان المسلمين تقليدياً عدم قدرتهم على التعاطي مع العمل الجبهوي أو الدخول في تحالفات حقيقية، وذلك بسبب طبيعة التربية والتكوين داخل تنظيم مغلق يقدّم فكرة السمع والطاعة للقيادة، واعتاد العمل والتحرّك في بيئة متجانسة بل وخالصة أيديولوجيّاً وتنظيميّاً. ومن ثمّ فقد إلى حدّ كبير القدرة على التوازن بين جماعية العمل والالتقاء مع التيّار العام في المعارضة.
ويزيد من ضعف قدرة الإخوان على التجسير مع القوى الأخرى ــ أي قوى ــ حالة الإحساس الزائد بالذات، بعدما ترسّخت جماعتهم كأقوى جماعة سياسية في مقابل الضعف الظاهر والمتفق عليه للقوى والأحزاب السياسية الأخرى. لقد كان هذا الشعور مسؤولاً عن روح التعالي على المجتمع واستدعاء المآثر والأمجاد في غير موضعها، مثل التصريحات المتوالية من قادتها بأن الإخوان هم أكثر القوى السياسية دفعاً لضريبة المعارضة السياسية للنظام، أو أنّ أكثر ضحايا النظام هم أبناء الجماعة ومؤسّساتها، وهذا صحيح إلى حدّ كبير، لكنه يعمّق الفجوة بينهم وبين القوى الأخرى ويشعر الشارع بحالة من الاستعلاء الإخواني.
ثمّ أخيراً روح الطائفة التي تتلبّس الجماعة، فتجعلها أقرب إلى طائفة كبيرة منها إلى تيار عام يمكن أن يستوعب الشارع والجماهير، وتخلق حالة التحفّز التي تتملّك كثيراً من قادتهم وقواعدهم عند التعامل مع الآخر وعدم القدرة على تجاوز حساسيّات تاريخية وأيديولوجية.
رغم هذه العيوب البنيوية التي تحكم مسار العلاقة بين الإخوان وغيرهم من القوى السياسيّة، إلا أنّ الأمر يبدو مختلفاً في موقفهم من الحركات الاجتماعية الجديدة. فهناك أسباب غير تقليدية هذه المرّة، وهي اختلاف طبيعة رؤية الإخوان (كنموذج للقوى الإسلامية والتقليدية) لقضية الإصلاح. ففيما تتبنّى الحركات الاجتماعية الجديدة الأجندة المطلبية التي تشتغل على مجرد مطالب فئوية تتعلق بالغلاء أو الأجور أو تحسين شروط العمل، ما زالت الجماعة تنتمي إلى نمط تقليدي للفعل السياسي يتمسّك بمنطق وأولوية العمل من أجل إقرار أجندة إصلاح سياسي شامل للبلاد. ويبدو أن هناك خلافاً داخل الجماعة لم يحسم بعد يتمايز فيه تيّاران، أحدهما تقليدي غالب لا يري التحرك إلا وفق مطلب إصلاح سياسي شامل يتّضح فيه موقع الجماعة وأفق مستقبلها (مثل منحها الشرعية القانونية)، وآخر أكثر انفتاحاً يرى ضرورة الاستفادة من موجة الاحتجاجات والإضرابات التي اجتاحت مصر بل وركوب هذه الموجة باعتبارها الأكثر قدرة على الفعل والأكثر جاذبية لدى الجماهير وتأثيراً فيها.
ويتّصل بما سبق ما يمكن أن نسمّيه عدم نظر الإخوان للحركات الاجتماعية والاحتجاجات المطلبية بتقدير أو احترام، وهو ما يرجع في جزء منه إلى اختلاف منطق كل منهما في تصوّره للفعل السياسي، إذ يتمسّك الإخوان بالسياسة بمفهومها الكلاسيكي (كما يدرّس في الجامعات ويلقّن في المؤسّسات السياسية) فيما ينظرون إلى السياسة الجديدة نظرة دونية باعتبارها أقرب إلى الضغط من أجل حقوق خاصة وفئوية! وهي في أفضل الأحوال ردّ على غياب الفعل الحقيقي الذي هو السياسة بالطريقة «العيادية»، حيث يصبح العمل السياسي وفق وصفات سابقة التحضير.
هذا إضافةً إلى ميراث تاريخي يجعل الإخوان لا يقدّرون هذا النوع من الحركات لكونه ولد أو تأثر بالثقافة اليسارية: «شغل شيوعيّين» بالتعبير الشائع!
نلحظ أيضاً أنّ ثمّة عدم وعي من جانب الإخوان لعمليّات التغيير الجديدة في المجتمع المصري ومكامن القوة فيه، وكيف أنها لا تخضع لحسابات القوى التقليدية نفسها أو منطقها بل هي متجاوزة لها أصلاً، وهو ما يظهر بوضوح من تعبير لأحد كبار قادة الجماعة (أمينها العام محمود عزت) يعلّل فيه رفض المشاركة في إضراب 6 نيسان / أبريل: لم يستشرنا أحد ولم نتّفق مع أحد! يبدو الرجل أسير السياسة بالمعنى التقليدي وما يتعلق بها من تحالفات وترتيبات يتوقع أن تكون كما يحدث تقليدياً بين الأحزاب والقوى السياسية. فهو لا يعرف أن الحركات الاجتماعية الجديدة بلا رأس ولا قيادة واحدة يمكن أن تنسّق وترتب ويتفاوض معها، وأنها في حركتها أقرب للشارع منها إلى القوى المنظمة.
وأخيراً لا يمكن أن نغفل قلق الإخوان التقليدي من القفز في المجهول والتحليق في أفق غير واضح ودفع ثمن غير مقدّر أو محسوب. فليس من عادة الإخوان دخول اللعبة إلا بعد معرفة قواعدها والاتفاق عليها بدقّة وتوقّع كل ما يخصّهم، ونصيبهم فيها، وليس من طبيعتهم المغامرة غير المحسوبة، وهو ما ينكشف في كل محطّة تاريخية فاصلة. حدث ذلك والنظام الملكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويتكرّر الآن والنظام الحالي يلتقط الأنفاس بصعوبة!
نعم يمكن الإخوان أن يتحمّلوا الكلفة السياسية، ولو كانت كبيرة (وهو ما حدث فعلاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مثلاً)، ولكن لا بدّ أن تكون هذه الكلفة معروفة أو متوقعة مسبّقاً أياً كان حجمها. فقلق الإخوان من المجهول بالغ التأثير في حركتهم، وليس هناك في نظر الإخوان مجهول أكبر من أن يدخل الشارع المصري (ويدخلوا به) في إضراب عام بدعوة ليس لها صاحب، وباحتمالات مفتوحة، بدءاً من تحوّل الإضراب إلى عصيان مدني يشلّ البلاد أو انفلاته إلى حالة عنف يصعب إنهاؤها أو السيطرة عليها... وحين تلوح نُذر الفوضى والعنف، يظهر ميراث القوى الدينية التقليدية كأوضح ما يكون، فـ«سلطة باطشة» نعرفها خير من مجهول لا يمكن التنبّؤ به، و«سبعون عاماً بسلطان جائر خير من يوم بلا سلطان»!
* باحث في شؤون الحركات الإسلاميّة
الإسلاميّون ومأزق الحركات الاجتماعيّة الجديدة
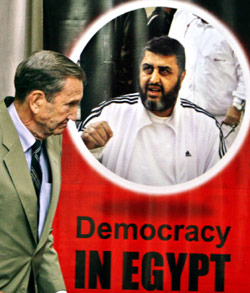
رمزي كلارك يمرّ بالقرب من ملصق يدعو إلى تحرير القيادي في «إخوان» مصر خيرت الشاطر(عمرو نبيل ـــ أ ب)


