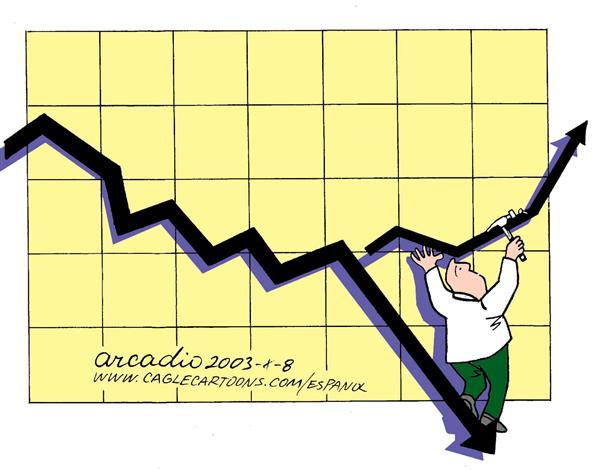إن تكبير العيّنة فوق نسبة معقولة لا يزيد بالضرورة من دقّة الاستطلاعلكن الاستطلاع السنوي لـ"المؤشّر العربي" الصادر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في قطر بات من أشمل الاستطلاعات المنشورة عن العالم العربي وتحليله نقديّاً قد يفيد في إعادة النظر في (أو مراجعة) تحليل استطلاعات الرأي العربي، غرباً وشرقاً (يقع التقرير الجديد في نحو ٤٠٠ صفحة). لنتحدّث أوّلاً في المنهجيّة. اعتمد الاستطلاع على عيّنة من ١٨٣١١ مستجيباً (ومستجيبة، أفترض؟) (ص. ٦ من التقرير). لكن لماذا هذه العيّنة الكبيرة؟ إن الاستطلاع يعتمد (أو يجب أن يعتمد) على عيّنة مُمَثّلة. والعيّنة المُمَثّلة، حسب علم الإحصاء (وهو علم أكثر علميّةً مثلاً من (لا) علم السياسة أو الاقتصاد) لا يجب ان تكبر من دون سبب أو ان تتضخّم. إن تكبير العيّنة فوق نسبة معقولة (بحسب تعداد السكّان) لا يزيد بالضرورة من دقّة الاستطلاع بل هو يُكرّر في النتائج ولا يُقلّص بالضرورة من هامش الخطأ فيه. إن استطلاع الرأي العام الأميركي (وعدد السكّان في أميركا يقارب الـ ٣١٨ مليون، لكن عدد البالغين يقلّ عن ذلك طبعاً) لا يتطلّب أكثر من عيّنة ٨٠٠ إلى ألف من السكّان على أن تكون مُمَثِّلة وعشوائيّة. والاستطلاعات الرصينة هنا لا تزيد على الـ١٢٠٠ في أكبر الحالات لأن ليس من ضرورة لزيادة العدد. لكن عيّنة "المؤشّر العربي" بلغت هذه السنة أقل من عشرين ألف بقليل. لماذا؟ إن اختيار عيّنة مُمَثِّلة وعشوائيّة كان يمكن ان يستعين بما لا يزيد على ألف مستجيب ومستجيبة فقط. ليس هناك من ضرورة لأكثر من ذلك. وتقليص العيّنة إلى عدد أصغر بكثير لا يقلّص من هامش الخطأ الذي بلغ بين ٢ و٣٪. إن عيّنة الف شخص تعني ان النتائج ستقارب توجّهات ٩٥٪ من السكّان وهي نسبة الاحتماليّة نفسها لعيّنة من عشرة الاف شخص على ان تكون العيّنة مُمَثِّلة وعشوائيّة. لكن اختيار العيّنة وفق معايير علم الإحصاء لا يضمن في حدّ ذاته دقّة النتائج لأن هناك عوامل أخرى يمكن ان تقلّص من دقّة النتائج (مثل صياغة السؤال أو ظروف إجراء الاستطلاع، ولنا عودة لذلك). كما ان هامش الخطأ لا يجب ان يؤدّي إلى اعتبار أية نتيجة في الاستطلاع تقارب نسبة هامش الخطأ، خلافاً لما ورد من تحليلات في التقرير أكثر من مرّة. إن نتيجة استطلاع تقارب ٣ أو أقل في المئة لا قيمة لها لأنها تدخل في حيّز هامش الخطأ.
ويقول التقرير في المقدّمة المنهجيّة إن اختيار العيّنة أخذ في عين الإاعتبار مستويات "الحضر والريف والتقسيمات الإداريّة الرئيسة في كل بلد" (ص.٧) لكن هذا لا يكفي. ماذا عن مستويات الجندرة والطبقة والعرق والعمر (خصوصاً أن الديموغرافيا العربيّة أكثر شبابيّة من معظم سكّان دول العالم) والطائفة. والتقسيم الطائفي ضروري خصوصاً واننا نعيش في عصر التأجيج والتحريض الطائفي (بعض الاستطلاعات في التقرير اخذت في عين الاعتبار العامل الطائفي لأن بعض النتائج قُسِمت على نطاق طائفي). واختار التقرير عيّنات مُستقاة من دول عربيّة عدّة من دون شرح مستفيض عن أسباب اختيار دول عربيّة دون أخرى. والتقرير يقول إنه لم "يؤخَذ بالوزن النسبي لكلّ دولة بحسب عدد سكّانها"، أي ان وزن عيّنة لبنان تساوت مع عيّنة مصر، وفي هذا إخلال بشروط المتطلّبات الإحصائيّة لاختيار العيّنة. فاستطلاعات الرأي في أميركا لا تعطي ولاية "أيوا" نفس وزن ولاية كاليفورنيا ذات الوزن السكّاني الكبير. إن الكليّة الانتخابيّة (وهي الطريقة المُعقّدة التي نسجها الآباء المؤسّسون للجمهوريّة الأميركيّة لانتخاب الرئيس بطريقة غير مباشرة لأنهم احتقروا الشعب وأرادوا النخبة ان تنتقي الرئيس بين مجموعة مرشّحين) لا توازي بين الولايات لأنها ذات حجم سكّاني مختلف، ولهذا فيه تحتسب في تقرير "الأصوات الاقتراعيّة" عدد اعضاء مجلس النوّاب (وهو خاضع للتغيير بناء على التغييرات الديموغرافيّة في كل ولاية حسب نتائج الإحصاء الشامل مرّة كل عشر سنوات) زائد عدد أعضاء مجلس الشيوخ (أي عضويْن لكل ولاية بصرف النظر عن الحجم الديمغرافي لكل ولاية). لكن المؤشّر في مساواته بين الدول العربيّة أخل بشروط إجراء استطلاع للرأي العام العربي، كعرب وليس كأعضاء في بلدان عربيّة مختلفة.
ولأن التقرير أُجريَ في أكثر من بلد عربي فقد استعان بشركات مُختلفة في كل دولة عربيّة. فهو اعتمد على شركة "ستاتيستكس ليبانون" في لبنان ومركز الدراسات الاستراتجيّة في الأردن وشركات أخرى في دول أخرى. لكن تعدّد شركات الاستطلاع يعطّل ضوابط توحيد المعايير والمنهجيّة، ويخلّ بشروط علميّة الاستطلاع. كيف يمكن ان يكون الاستطلاع الشامل مركوناً فيما هو لم يعتمد نفس الأسلوب والمنهجيّة بين الدول؟ وهل خضع أعضاء فرق إجراء المسح الميداني لتدريب مركزي بغية توحيد المعايير في ما بين الشركات المُتعدّدة؟ وشركات استطلاع الرأي في العالم العربي تعاني من مشاكل سياسيّة جمّة وهي ترتبط أحياناً بالحكومات ولا تخلّ بمصلحة الحكومات في نشر تقاريرها. نستطيع أن نفصّل من خلال مثال شركة "ستاتسكس ليبانون" اللبنانيّة. إن كل شركات الاستطلاع اللبنانيّة مرتبطة سياسيّاً بهذه الجهة (١٤ آذار) أو تلك (٨ آذار)، وإن كان معظمها يدور في فلك ١٤ آذار. لكن الشركة هذه (أي "ستاتكس ليبانون" المملوكة من ناشط سياسي في حركة ١٤ آذار) تفتقر إلى المصداقيّة ليس فقط لأن نتائج استطلاعاتها تتوافق دوماً مع توجّهات ١٤ آذار، بل لأنها فقدت كل مصداقيّتها في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام ٢٠١٤ عندما أجرت لحساب "القوّات اللبنانيّة" استطلاع رأي في منطقة المتن. الخبر ليس في أن الاستطلاع جاء لصالح "القوّات اللبنانيّة" التي استعانت بها، بل في ان الشركة نشرت نتائج الاستطلاع على أساس عدد الأصوات التي سينالها كل مرشّح، وهذا امر غير مسبوق في تاريخ الاستطلاعات. ما مِن شركة استطلاع رصينة تتوقّع عدد الأصوات (بالعدد وليس بالنسب المئويّة التي ينالها كل مرشّح). وإذا كان هذا أسلوب شركة واحدة، فما بالك بالشركات الأخرى التي استعان بها المؤشّر في البلدان العربيّة الأخرى. ومركز الدراسات الاستراتجيّة في الأردن، مثلاً، ليس بعيداً عن النظام ومصالحه. اما الشركات الأخرى فلا أعلم عن أمرها لكن حالة شركة واحدة لا تبشّر بالخير أبداً. إن تلافي المغالطات والأخطاء في استطلاع في دول عدّة غير ممكن بغياب شركة واحدة تقوم هي بالاستطلاع وفق معايير مضبوطة ومحدّدة. ثم ما هي المنهجيّة التي اتبعتها هذه الشركات في اقتناء العيّنات؟
وقد اعتمد الاستطلاع الميداني على إجراء مقابلات وجاهيّة، وفي هذا أحياناً إفاضة وتوسّع يفيد في ضمان دقّة الأجوبة. لكن هذا الأسلوب قد يفيد في بلاد ولا يفيد في بلاد أخرى. إن المقابلات الوجاهيّة تزيد في الدول القمعيّة (مثل السعوديّة ومصر وغيرها) من رغبة المُستجيب في إعطاء إجابات تتطابق مع سياسات الدولة الي يعيش في ظلّها، وتحت وطأتها. إن هذا مثلاً يُفسّر كيف ان إجابات المُستجيبين في السعوديّة (في الردّ على مختلف الأسئلة في التقرير المُستفيض) تطابقت في معظم الحالات مع أهواء وتطلّعات ومصالح النظام الحاكم. إن المقابلات الوجاهيّة تزيد من أجواء الضغط على المُستُطلَع كي يعطي الإجابات الملائمة لأنه لا يعلم عن علاقات وارتباطات الفريق المُستطلِع: وهو لا يُلام إذا كان ارتاب في تسرّب رجال الأمن إلى صف الفريق المُستطلِع. وما هي الشركة المُستقلّة التي تستطيع ان تستطلع بحريّة واستقلاليّة في بلد مثل مملكة قطع الرؤوس السعوديّة حيث تُطبّق عقوبة الإعدام على مَن يعبّر عن وهن في ولائه للعائلة الحاكمة؟
هذا لا يعني أن استطلاع الهاتف يمكن ان يؤدّي الغرض بصورة أفضل لأن حالة الخوف تعتري المواطن في الإجابة عن أسئلة وجهاً لوجه أو عبر الهاتف. ومن المعروف ان الإجابات الهاتفيّة في الدول الغربيّة لا تكون صادقة في كثير من الأحيان (في حالة التعاطف الإيديولوجي بين الشباب في بريطانيا مثلاً عندما لم يجاهر الشباب في حقيقة تعاطفهم مع مارغريت تاتشر في الثمانينيات وأثبتت نتائج الانتخابات ان استطلاعات الرأي قلّلت من حقيقة هذا التعاطف، أو في حالة التكاذب في آراء البيض في أميركا نحو المرشّحين السود حيث تثبت نتائج الإنتخابات ان البيض يبالغون في حقيقة تعاطفهم مع المُرشّحين السود في الاستطلاعات مقارنة مع نتائج الاقتراع السرّي). الحلّ ليس بسيطاً في العالم العربي لأن المُستجيب يمكن أن يخشى المصارحة في حديث هاتفي مع مجهول قد يرتاب في أمره وفي مقاصده، وهو حتماً سيخشى المصارحة في حديث مع فريق مجهولين لا يعلم حقيقة مقاصدهم وتوجّهاتهم في بلاد لم تترسّخ فيها تقاليد استطلاعات الرأي. كما ان ندرة شركة الاستطلاعات في البلدان العربيّة تقلّص من إمكانيّة نمو وتطوّر علم الاستطلاع بناء على أخطاء وتجارب سابقة. صحيح ان الاستطلاعات العربيّة يمكن ان تكون أفضل من الاستطلاعات الغربيّة (مثل "بيو" أو "غالوب") التي تعتمد الصياغة الإنكليزيّة للأسئلة، والتي تستحيل ترجمة معاني بعضها في العربيّة. لكن الصياغة العربيّة لبعض الأسئلة في استطلاع "المؤشّر" لم تستقل للأسف عن الاستطلاعات الغربيّة من حيث نقل نفس التصنيف في الإجابات عن الحالات الغربيّة.
كما ان جون زار، عالم السياسة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، أفادنا الكثير عن شكوكه حول علم الاستطلاع في كتابه الكلاسيكي "طبيعة وأصول رأي الجمهور". فهو لم يربط فقط بين التعبير عن أهواء الأفراد وبين خطاب النُخب المنقول، بل شكّك في وجود رأي عام للفرد في قضيّة يُسأل عنها: أي أن لا وجود للرأي المُستطلَع قبل وجود المُستطلِع وسؤاله للمستجيب في تلك اللحظة من الاستطلاع. والوضع في العالم العربي أكثر إشكاليّة لأن النخب لا تتمتّع باستقلاليّة عن الأنظمة السائدة في أكثر من دولة عربيّة. إن سطوة الحكم السعودي تمتدّ من حدود المملكة نحو كل الدول العربيّة (وبعض الدول الإسلاميّة) وليس بالاقتناع والقوّة الناعمة وإنما بالمال والسلاح والسيطرة على المؤسّسات الدينيّة والسياسيّة والإعلاميّة السائدة. أي ان نقاش وخطاب النُخب العربيّة على الشاشات العربيّة المسموح بها من قبل أنظمة الخليج لا تخرج عن سياق خطاب ومصلحة الأنظمة العربيّة السائدة. وليس سهلاً على المرء الخروج عن خط الحكم الإقليمي السائد. وفورة التوتّر المذهبي فجأة في أوساط الرأي العام دليل آخر على قدرة النظام السعودي على قولبة الرأي العام عبر التأجيج والإثارة والتحريض المذهبي المُستمرّ. لماذا لم يكن الرأي العام العربي يعبّر قبل أوان معيّن ومحدّد في عام ٢٠٠٣ (عندما قرّر آل سعود وآل ثاني وأتباعهم) شحن المنطقة بالعصبيّة الطائفيّة والمذهبيّة؟
وهناك إشكاليّة أخرى في التقرير بصورة عامّة: إذا كان عامل الخوف وضعف المنهجيّة يؤثّران على نتائج الاستطلاعات الجارية فإن توافق معظم الأسئلة (والأجوبة حكماً) مع توجّهات الأنظمة الخليجيّة يضفي على نتائج الاستطلاع شكوكاً إضافيّة. لم يتضمّن التقرير مثلاً أسئلة عن مشروعيّة تلك الأنظمة فيما تضمّنت أسئلة عن مشروعيّة أو حول صوابيّة بقاء نظام عربي وحيد تعمل دول الخليج على إسقاطه.
والأمر الآخر حول المنهجية يكمن في نقل درجات التوافق والتعارض على طريقة أسئلة الاستطلاع الأميركيّة حيث هناك الحكم مثلاً على "مستوى الأمان" بدرجة "سيّئ" أو "سيّئ جدّاً" (ص. ١٢)، لكن ما الفارق بين هذه الدرجات وكيف تُقاس بين أفراد غير مرتبطين ومرتبطات بالطريقة نفسها؟ هناك إمكانيّة لتوحيد التصنيفات في الإجابة وفق معايير محدّدة ومضبوطة في حال كان الاستطلاع على طريقة "مجموعة التركيز" (المنتقاة بعناية) لكن هذا يصعب في عيّنة تقارب العشرين ألف شخص. وفي نفس الفصل عن مستوى الأمان يضمّن التقرير في النتائج نسباً لا يُعوّل عليها بسبب اقترابها من هامش الخطأ، لكن السؤال عن تقييم الوضع الاقتصادي مفيد لأن الأمر لا يحظى بتغطية إلا ان الأسئلة خلت من إجابات يمكن ان تقرّر مستوى أو درجة مسؤوليّة النظام وأسلوب نفقاته في زيادة الأعباء الماليّة. ماذا لو سُئل المُستجيب عن الترابط بين تراجع الوضع الاقتصادي للفرد وبين زيادة مطردة في نسبة الإنفاق على التسلّح مثلاً؟ أما في التقرير فيبدو تقرير الوضع الاقتصادي على انه لا يختلف عن تقرير المناخ في المواسم.
ما المعني بـ"الوضع السياسي"؟ المصطلح غامض عن قصد وبطريقة ليست بنّاءة
اما في تقييم المواطنين لـ"الوضع السياسي" فهنا تظهر الإشكاليّة بوضوع أكثر. لكن ما المعني بـ"الوضع السياسي"؟ المصطلح غامض عن قصد وبطريقة ليست بنّاءة لكنّها تتستّر على إمكانية التعبير عن مستوى الرضى على النظام القائم. إلا أن ضعف القدرة على التعويل على مصداقيّة الإجابة تظهر في المقارنة بين الإجابات من السعوديّين حيث عبّر نحو ٨٣٪ من المُستجيبين عن رضاهم عن "الوضع السياسي" وتقييمه على أنه إما "جيّد" أو "جيّد جدّاً"، فهذا لا يمكن ان يصرّح عن حقيقة المشاعر لأن لبنان، حيث يتقدّم النظام السياسي على علاّته وحيث هناك حريّات لا تتوفّر بالحدّ الأدنى في السعوديّة، أظهر نتائج تفيد أن ١٪ في المئة فقط راض عن "الوضع السياسي"، وفي تونس كانت النسبة (بين "سيّئ" و"سيّئ جدّاً") نحو ٧٧٪. هنا مفارقة تقلّل من مصداقيّة الأرقام: هل يُعقل ان الرأي العام في البلدان المنفتحة وذات الخواص الديمقراطي أقل رضى عن "الوضع السياسي" من الرأي العام في بلدان متخلّفة سياسيّة بكل المعاني، مثل السعوديّة والأردن؟ أم ان صياغة السؤال أتت بإجابات متعلّقة بتقييم الوضع الأمني أكثر من "الوضع السياسي"؟
ونرى نفس النسب في السؤال عن "جديّة بلدانه في العمل على حلّ المشكلات" (ص. ٣٧). لكن لماذا استعمال كلمة "بلدان" بدلاً من حكومات أو أنظمة؟ لأن بلدان تعني ما يتعدّى الحكومة أو النظام، مع ان حل المشكلات ليس بيد البلدان بصورة مجرّدة. وفي هذا القسم من التقرير تتفوّق الأنظمة القعميّة مثل السعوديّة ومصر على لبنان والمغرب، والأخيران أقل تسلّطاً. أي ان نرى إيجابيّة في الإجابات عن الأنظمة المُتسلّطة. والرغبة في الهجرة تقلّ في صف الأنظمة القمعيّة (ص.٤٠) عنها في صف الأنظمة الأكثر انفتاحاً. يخرج المرء بانطباع ان العرب أكثر سعادة في ظلّ الأنظمة الأكثر قمعيّة، وأنهم أكثر بؤساً في الأنظمة المنفتحة نسبيّاً. طبعاً، يدخل في الحسبان هنا ليس فقط التصنيف الإقتصادي بين البلدان بل أيضاً قدرة الرأي العام في البلدان الأكثر انفتاحاً على التعبير الحرّ منها في ظل الأنظمة المنغلقة والمُتسلّطة.
أما الجدول ٤ (الفصل نفسه، ص. ٣٥) فهو يظهر مرّة أخرى مشكلة الصياغة وتوفير خيارات الأجابة. كما ان الخفر في تحديد المشاكل السياسيّة هو الذي يزيد من رفع المشاكل الاقتصاديّة في سلّم الأولويّات. فهل يعقل مثلاً ان نسبة 1٪ فقط من الشعب الفلسطيني شكت من "التدخّل الخارجي"؟ أو نسبة 7.41% فقط من الشعب الفلسطيني شكت من سياسات الاحتلال وحصار غزّة؟ هناك مشكلة هنا. هل فهم المستجيبون السؤال ام انه كان هناك إلتباس في الإجابة نتيجة الصياغة؟ وماذا تعني مثلاً عبارة "الحكم وسياسته"؟ أو "الإصلاح السياسي" في أنظمة تعصى على الإصلاح؟ هناك جهد في الصياغة لتلافي الإحراج السياسي او لتجنّب إغضاب الأنظمة الراعية لبعض الشركات التي أجرت هذه الاستطلاعات. وما المعني بـ"المشكلات الاجتماعيّة"؟ هذا عنوان عريض ولا يختصر. لهذا فإن الإجابات على هذه الأسئلة في هذا القسم المهم من الاستطلاع ضاعت بين الالتباس وسوء الفهم وتلافي الإحراج السياسي. والمواضيع الاقتصاديّة مُشتّتة: فهناك جواب عن "الفقر" وجواب آخر عن "سوء الأوضاع الاقتصاديّة" وآخر عن "البطالة" وآخر عن "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة". لكن عدم الارتباك السياسي للمجيبين يظهر من ارتفاع نسبة الذين رفضوا الإجابة، وقد بلغت ٩,٧ في السعوديّة و٩,٩ في الجزائر و٨,٤ في مصر. هذه النسب المرتفعة تدل على تفاوت فرص الإجابة الحرّة للمستجيبين وتظهر صعوبة إجراء استطلاعات رأي موحّدة (وعبر شركات متعدّدة) في الدول العربيّة.
يتبع...
* كاتب عربي (موقعه على الإنترنت:
angryarab.blogspot.com)