محمد مظلوم *
(أهل مكة أدرى بشعابها) هذا المثل الذي يمتد إلى عمق الثقافة العربية من شفاهياتها إلى مدوّناتها، وجد له في ثقافتنا السياسية المعاصرة مكاناً بارزاً بوصفه تعبيراً عن ملامح التشبّث بالهويات الضيقة وحجب المشاركة في الحوارات «الوطنية» عن كلِّ من لم يسكنْ مكة ولم يعرفْ شعابها.
ولنقرّ أنَّ هذا المَثَل / الشعار ستجري استعارته لتأصيل شعار الاستقلال والمصير الذي لا يصنعه إلا أهلُ الدار! لكنَّ الدارَ في زمن العولمة لم تعد داراً، وإنما أضحت أفقاً مفتوحاً وغالباً مباحاً للجميع.
ومكة، على سبيل المجاز، لم تعد كما كانت قبل قرون، والشعابُ لم تعد ضيقةً والأهلُ صاروا شتاتاً، وقد أخذت الشعابُ جناسَها من هذا الشتات أيضاً فأضحتْ شُعوباً لا أحدَ يدري ما مآلُ طريقها، وثمَّة خريطة جديدة ليست بين الشعاب والشعوب فحسب، بل بين الماضي والمستقبل عموماً، بين ثقافة قديمة وأخرى جديدة، بين نمطين من التفكير خلخلا في انفصالهما المكان فاتسع وكثّفا الزمان فاتصل.
قد يكون من المناسب هنا أن نترك تلك الشعاب الضيقة لأهلها ليخلقوا هذه الحواجز القديمة من أجل التنافس على الطريق الواضح نحو الفضاء المتسع على خراب هائل من بغداد إلى بيروت ومن غزة إلى جغرافيا قلقة حائرة وجريحة لم تستقر يوماً على نهضة وهي تكبو على جراحها، كما يحدث هذه الأيام!
لا شعاب مكة ولا آبار بيروت القديمة، لا نخيل العراق ولا زيتون فلسطين تخفي الوقائع الفصيحة وإن تعددت مجازاتها، إنها ساحاتٌ وملاعبُ وحقولُ تجارب.
ساحات لأنَّ جورج بوش كرَّر هذا الوصف في حالات أفغانستان والعراق ولبنان.
وحقول تجارب لأن فكرة «العراق الجديد» المستدركة بفكرة الفوضى الخلّاقة، انكفأت إلى فكرة الشرق الأوسط الجديد، في تطور عكسي بالعودة إلى فكرة شمعون بيريز في كتابه الذي أصدره عقب حرب عاصفة الصحراء، في نظام «اقترح» فيه أن تكون إسرائيل مهيمنة تحت غطاء فكرة الاندماج والتعايش.
لكن ألم يحقق الفرز الواضح والتباين في المواقف في المنطقة ملامح الصورة التي رسمها بيريز للشرق الأوسط البديل عن فكرة الجامعة العربية التي أصبحت، في نظره الثاقب، من الماضي قبل نحو ثلاث عشرة سنة؟
وهي ملاعبُ لأنَّ الأمرَ برمّته بدا في يوميات الشارع العربي أكثر شبهاً بحمّى المونديال حقاً، ليس لقرب المسافة بين الحدثين، أو في تلك الأعلام المرتفعة لا من شرفات المنازل فحسب هذه المرة، بل وعلى الباصات المحمّلة بقوافل النازحين والعائدين سريعاً في حمى المونديال، وتلك التي تنقل الفقراء في شوارع المدن العربية من بغداد إلى دمشق. أليس لافتاً حقاً، أن ترتفع أعلام حزب الله في بغداد لتطغى، ربما للمرة الأولى، على رايات الملل والنحل وبيارق الطوائف والأحزاب التي مزجتْ كل الألوان المتاحة لكنها لم تصل إلى مزج روح الشعب ولا الأمة بخميرة كما فعلته المقاومة تحت علم واحد؟ أليس لافتاً أن نجد تلك المنازل التي رفعت أعلام فرنسا وإيطاليا وألمانيا والأرجنتين وإنكلترا والبرازيل خلال شهر المونديال لتنكِّسها بالتدريج كلما خرج فريقٌ في دور من أدوار البطولة، نجدها تتوحد خلال الشهر الذي أعقب المونديال وهي ترفع العلم مرفرفاً لشهر ولا يزال حتى اليوموإذا كان الأصفر هو اللون الطاغي على علم البرازيل خلال المونديال فإن خروج منتخب النجوم الخلاسية من كأس العالم قد لا يعدله إلا بقاء الأصفر اللبناني مرفرفاً.
لا يسيء اللبنانيين إنْ غدا علمُ حزبٍ توأماً لعلم دولة أو حتى أكثرَ شهرةً منه! فهو أضحى لوناً عابراً للوطنية والإقليمية والقومية تماماً مثل علم البرازيل الذي تحرَّك آلافَ الأميال ليستقر على شرفات المنازل في كل مكان.
لكن علم لبنان في الواقع، كان بأرزته الخضراء توأماً للأصفر في شوارع المدن العربية الكبرى، صورة تتحدى انسحاب منتخب لبنان من التصفيات الآسيوية لكرة القدم، وتعذّر إقامة بطولة غرب آسيا في بيروت بسبب الحرب.
ذكّرني انكباب الناس خلال الأسابيع الأخيرة على اقتناء اللون الأصفر ورسم شعار حزب الله عليه، بتلك القصة التي يرويها صاحب الأغاني عن مناسبة قصيدة مسكين الدارمي «قل للمليحة في الخمار الأسود»، إذ يُروى أن اللون الأسود كان كاسداً لدى أحد تجار الكوفة حتى جاءت قصيدة الدارمي تلك، فأضحى الأسود هو اللون الفاتن والمشع على رغم عتمة لونه. لا شك في أن الأمر لا يتعلق هنا بتجارة أو بفوز تحققه لعبة كرة قدم، بل بهذا الكساد الروحي المتمرس في الصدور حدّ الكآبة ليأتي زمن يفيض فيه ويطفو على راهن متعطش لفكرة أخرى سوى ما حملناه من ميراث الهزيمة.
بعد هذا لن نمضي بعيداً لتفسير كيف أضحى الأصفر مشعَّاً ومخضرَّاً ذهباً، وعشباً في صحراء الفرد العربي المختنق بفكرة العلم الذي لا يُرفع إلا في منافسات الأشقاء وفوزهم على بعضهم خلال المباريات!
إنه مونديال آخر يمتد هذه المرة من أندونيسيا إلى فنزويلا، مروراً بأرض العرب والأعراب التي لم تستطع أن تعربَ النصرَ في جملة مركبة أبعد من مبتدأ وخبر، وأعقد من فعل وفاعل، وأكبر من نعوتٍ وأحوال.
إنه مونديال في تموز العراقي اللبناني الأميركي الفرنسي الإسرائيلي السوري الإيراني، تموز الكوني بتراثه المتشعب والفاصل بين ما قبل وما بعد.
فيه تجاوز عدد القتلى العراقيين أعلى رقم بلغه أي شهر آخر منذ الاحتلال الأميركي للبلاد وهو 3438 عراقياً أزهقت أرواحهم في الشهر الساخن، وظل الرقم مغفلاً عن الفضائيات ومطوياً في دوائر الصحة ومستشفى الطب العدلي، لكن حرب طوائف ما بعد الاحتلال ليست وحدها من حصد كلَّ هذه الأرواح، وسيكون لافتاً إذا ما قرأنا بشكل دقيق إحصائيات أخرى تتعلق الأولى بتصريح مصدر أمني لإحدى الوكالات المحلية بأن نسبة عمليات القتل الغامض والاغتيالات على الهوية الطائفية انخفضت خلال شهر تموز نفسه بنسبة 62% مقارنةً بشهر حزيران، وسيغدو «هذا اللافت» ذا دلالة إذا ربطناه بما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن «مسؤول بارز» في (البنتاغون) أن «التمرد ازداد سوءاً بجميع المعايير تقريباً، إذ ارتفع معدل هجمات المتمردين في الفترة الماضية». وأكد مسؤولون أميركيون ما نشرته الصحيفة، التي أشارت إلى أن إحصاءات الجيش الأميركي في العراق تظهر أن مجموع عمليات زرع العبوات، ارتفع من 1454 في كانون الثاني الماضي إلى 2625 بين منتصف تموز ومنتصف آب، وتشير إحصاءات الجيش الأميركي إلى أن 70 في المئة من تلك العبوات استهدفت قوات الاحتلال، فيما استهدف 20 في المئة القوات العراقية، و10 في المئة المدنيين. فيما ارتفع عدد الإصابات الأميركية من 287 إلى 518 جندياً.
ستنعكس حرب الصيف التي حلّت في موسم الحروب الكلامية والنزوح والتهجير بديلاً من السياحة ليس في لبنان وحده بل كذلك في دمشق وبغداد وعمان، وستلقي بظلال جديدة على الوضع العراقي، على فكرة المقاومة تحديداً وطبيعة هويتها ونمط فاعليتها وتوجّهها.
لا بمجرد تلك الأفلام التي بدأت تصوّرها مجموعات شيعية وتبثّها على شبكات الإنترنت تحت تسميات «عصائب أهل الحق» أو «صرخة أهل الحق» وهي تطلق الكاتيوشا على القوات البريطانية في الجنوب والأميركية في المنطقة الخضراء تناغماً مع كاتيوشا حزب الله على الشمال الإسرائيلي وصواريخه على حيفا، وإنما حتى باضطرار مسؤولين بارزين في «العراق المحتل» إلى تصدّر مسيرات مؤيدة للمقاومة اللبنانية، وحضور فعاليات تتصدّرها أعلام حزب الله في بغداد.
إذن لن يكون التاريخ بعد هذا الوقت إلا زمناً فاصلاً بين ثقافتين.
ذلك أن المقاومة ثقافة أكثر من كونها مجرد قتل وقتال، وهي حرية أكثر من كونها طلباً لها أو دفاعاً عنها وهي تتحول اليوم إلى ممارسة لتلك الحرية في زمن الاستعباد والاستبداد العربي، حيث النظام الرسمي الميت الذي يستحق التندّر والتفكّه أكثر من مطولات المرثيات القديمة والندب الذي لا يقلق الموتى في سباتهم الأبدي.
وإذا ما كانت حرب حزيران قد أورثتنا ثقافة الهزيمة أفلا يمكننا أن نتحدَّث بعد تموز عن «ثقافة مقاومة» على الأقلّ للخلاص من هذا الفولكلور الكلاسيكي في حياتنا، ذلك الذي جعلنا نحيّي المستبدين من أمثال صدام كأنهم رموزها؟ أما آن لنا أن نقتلَ الرموز القديمة في الخارج ونحياها في نفوسنا نحن؟ نعم لقد اشتدَّ سعير المقاومة في العراق بعد أن اعتُقل صدام، سقط الرمز الاستبدادي الذي كانت ترتفع صوره، تجلّياً زائفاً لرمز التحرر، ومع سقوط النظام الرسمي العربي، أو بالأحرى انكشاف سقوطه مرأى العيان سقطت ثقافة تعويم الهزيمة لتبدو على سطح الخطاب العربي الزائف كأنها ثقافة صمود، أضحت المسافات أوضح بين ثقافة ملفّقة ومطمئنة إلى هزيمتها، وأخرى حية ومبنية بمشاركة متعددة الطبقات، مسافة لا تقاس لا بالبعد القطري ولا الطائفي ولا حتى القومي، إنها جغرافيا إنسانية خلاسية يصهرها حس العدالة ورفض الهيمنة ومجابهة التسلط والقوة الغاشمة أنّى كان مصدرها.
لقد ضخّمنا الهزيمة بتراثٍ لا يُستهان به من الأدبيات، حتى أضحت كأنها متن طبيعي في سياق تجربتنا وتاريخنا، ربما لهذا سيبدو أي انتصار كأنه هامش غير مرغوب في دخوله هذا المتن وتغييره أو على الأقل تنقيحه بنكهة أخرى، لماذا لا نعيد صياغة المتن برمّته على أساس أن الهزيمة لا تمكث في جهة واحدة، مرة واحدة وإلى الأبد، وكذلك الانتصار، ربما ثمة من سيقول إنها الحرب ثمن فادح لتعديل مسيرة ذلك المتن الآمن والعاقل والراكن إلى عزلته وكهوفيته، لكن بالمقابل أليست فكرة الاطمئنان إلى العيش في كهوف الهزيمة ثمناً أكثر فداحة؟
ربما كانت إسرائيل أكثر تأنيقاً للهزيمة، فهي اكتفت بالقول إنها لم تنتصر في لبنان، ولم تذهب إلى التصريح بأنها انهزمت أو هُزمت، أما الخطاب العربي الذي أصرَّ يوماً على اللهج بالانتصار وترديد عبارات النصر وهو يلوك مرارة الهزيمة فهو لا يستطيع اليوم أن يتيقّن تماماً من طعم النصر في فمه ولا يطرِّي لسانه المتخشّب من خمره.
ليس الأمر بهذا الحسم بين الهزيمة والانتصار، هذا صحيح تماماً، ولكن الأصحَّ أن تموز يختلف عن حزيران تماماً فلماذا لا يرصد خطابنا الثقافي هذا الاختلاف البيِّن!
كيف يستشهدون ضاحكين في الأحراش والأودية والمنازل وما زال صوتُنا في الفضاء أجشَّ منذ تلك الهزيمة الحزيرانية!
وعلى غير ما يستغرقهُ الأمر في سجالاتنا التي حافظت على مواصلة لغتها القديمة في التفسير والتأويل والحسابات، يأخذ الأمرُ شكلَ التفاعل المؤسساتي في إسرائيل بين الجيش والحكومة، فالحكمة السياسية هناك قلّلت من قوة اندفاع القوات الإسرائيلية، على الأقل هذا أحد التبريرات لتفسير حكاية ضياع نصر موروث.
وحده الكاتب الإسرائيلي دافيد غروسمان الذي لم تنفع دعواته لوقف الحرب، عبّأ صوته الشخصي بمرثية لابنه أوري المقتول في دبابته في الساعات الأخيرة من الحرب، فصرّح «لقد خسرنا الحرب، الخسارة الشخصية هنا أبعد من المرثية، لتحاسب دولة إسرائيل نفسها الآن، هذا هو ما يجعل الشخصي قاسياً، وأوري تقبّل بشرى وقف الحرب ببالغ السعادة!».
بعد هذا كله لن تبدو ثقافة المقاومة ملتصقة بالقتال ومضادة للاحتلال وصنو الجيوش والبنادق، ليست ثقافة موت أو عنف أو توحّش، إنها نهضة ضدَّ الاستعباد والاستبداد وهي ليست تمرّد تعويذات وإنشاد صرخات بدائية، لكنها سلوك إنساني يستشعر حس العدالة قبل كل شيء.
قد يتجسّد الانتصار في راية رمزاً ليس أكثر.
لكن من العار أن تجري طوطمة هذا الرمز كأنَّهُ معادلٌ لهيمنة ظلال راية أو فكرة، فيجري رفضه أو تشويهه برايات أخرى تتزاحم فقط لتقول يجب أن يكون النصر أخضرَ أو أحمرَ أو أسودَ، إنه هكذا لون للجميع وليس لحزب أو طائفة أو قومية، إنه تعبيرٌ إنساني أبعد مما قد تتصور طائفة من اللبنانيين أو جماعة من العرب أو فئة من المسلمين.
نصرّ أن نبني، بكل تأويلات البناء، قبل أن نحارب، ونصرّ أن نكتب بريشة طائر الفينيق الذهبي لا بالخناجر التي تُغمس في دم الطائر، ونصرّ أن ندافع عمّا بنيناه قبل أن نبكي على الأطلال، إنها ثقافة جديدة حقاً.
هل تتذكّرون ثقافة البكاء على الأطلال؟
* كاتب عراقي مقيم في سوريا
مونديال المقاومة وثقافة الهزيمة
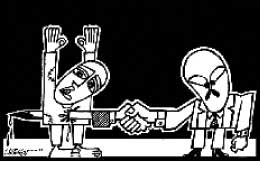
كفاح محمود - العراق


