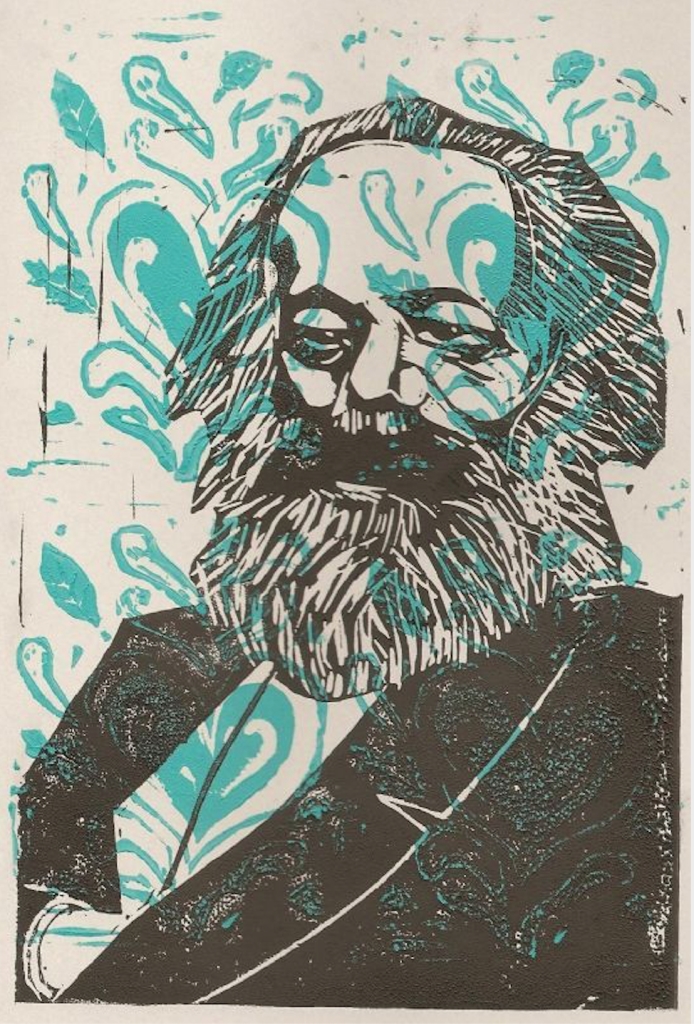
لكنّ تلك «العودة» إلى ماركس، وبالتالي إلى «الماركسية»، تختلف بحسب منطلقات وأهداف كلّ جهة، فهناك من يعود إليهما بوصف الأول «نبيّاً»، و«الماركسية» «تعليمات سرمدية غير قابلة للخطأ» متماسكة مثل كتلة صخريّة لا يمكن فصل بعضها عن بعض إلّا بتكسيرها، ويتعامل مع نتاجهما كنصوص أقرب إلى التقديس، سواء للاقتباس أو الاستنساخ أو التقليد أو محاكاة زمان مضى، وأحياناً للمحاججة على ظروف الحاضر، لا سيّما إذا تمّ تعليق كلّ شيء على «الماركسية» التي تُستعمل كشمّاعة أو استخدام اسم ماركس واجهةً لجماعات حزبية، في حين أنّ هناك من يعود إلى ماركس و«الماركسية» لا بصفتهما أيقونات أو وصايا مقدسة، بل بوصف «الماركسية» وضعية نقدية ومنهجاً ديالكتيكياً يفترض التطوّر والتغيير تبعاً للتطوّر في واقع العلوم والتكنولوجيا والمجتمعات وحاجات الناس ودرجة تقدّم الأمم والشعوب وقوانينها ومتطلّباتها الحياتية والاجتماعية والكيانية.
منهج لا تعليمات
بهذا المعنى، سيكون استخدام ماركس و«الماركسية» نوعاً من قراءة منهجية جدلية، لا كتعليمات أو وصايا لم يعد قسمها الأكبر صالحاً للاستعمال في زمن مختلف عن زمن ماركس، حيث لم يكن ماركس سوى الحلقة الذهبية الأولى في التمركس الضروري لقراءة التاريخ ولوضع الأحكام والقوانين واستخلاص الدروس، خصوصاً بربط فلسفته بعملية التغيير والنضال من أجل مجتمع خالٍ من الاستغلال والظلم، عبر مملكة الحرية المتجاوزة لمملكة الضرورة التي تحدّث عنها. بهذا المعنى أيضاً، سيكون الحديث عن «الماركسية» باعتبارها حضوراً وليس غياباً أو مغادرة أو عودة أو انبعاثاً، حتى وإن تمّ إهمال الكثير من أحكام ماركس وتعليماته، بل ونقدها ماركسياً، لا سيّما باستخدام منهج ماركس ذاته، الذي لا يزال حيوياً وصالحاً.
تحنيط الماركسية
هذه القراءة ضرورية بعدما تمّ تحنيط «الماركسية» إلى درجةٍ أفقدتها روحها وسلبت لبّها وجمّدتها على نحوٍ ضاعت فيه حيويتها، ومن جهة أخرى أصبح التنصّل منها ومغادرتها والتخلّي عن جوهرها، بعد خنق روحها وكتم أنفاسها، جزءاً من مزاعم التكيّف مع متطلبات العصر وسماته. ومن جهة ثالثة، تتجلّى دوافع الانتقال إلى الضفّة الأخرى من دون حدود، أو حتى من دون أي شعور بالتخلّي والفداحة أحياناً، في محاولات براغماتية وفي ظلّ بيئة ذرائعية مشجّعة، خصوصاً بعد انهيار المنظومة الاشتراكية السابقة. ويتمّ ذلك أحياناً بمواصلة ارتداء قميص «الماركسية»، أو حمل شارتها والتغني بنشيدها، مع استدارة كاملة في المنهج والأدوات، ناهيكم عن السياسات العملية، الأمر الذي يمكن تسميته أيَّ شيء إلّا كونه «ماركسية».
المتجمّدون والمتفلّتون
لهذا سيكون استخدام منهج ماركس وجدليّته ضرورة لكشف خطل المتجمّدين، الواقفين عند علوم القرن التاسع عشر واستنتاجات ماركس وتعاليمه التي كانت صالحة لزمانه، ومن جهة أخرى لتبيان هزال دعاوى المتفلّتين بالتخلّي عن «الماركسية» ومنهجها، بحجّة سقوط النموذج السوفياتي البيروقراطي الأوامري التعسفي، وتكييفها لما تريده القوى المتسيّدة في العالم، بزعم أنّ الصراع الأساسي اليوم هو مع الأصولية الدينية وخطرها، لا سيّما في منطقتنا، وإن كان صراعاً لا يمكن نكرانه أو تجاهله. لكنّ هذا شيء وتخفيض سقف النضال ضد الإمبريالية شيء آخر، علماً أنّ بين الماركسيين والعلمانيين بشكل عام وبين الإسلاميين والجماعات الدينية هناك مشتركات غير قليلة تتعلق بالتصدي للأخطار الخارجية وإنجاز مهام التحرّر الوطني والقومي والسير في طريق التنمية المستدامة والتخلّص من هيمنة الاحتكارات الرأسمالية.
هذه القراءة ضرورية بعدما تمّ تحنيط «الماركسية» إلى درجةٍ أفقدتها روحها وسلبت لبّها
المتحوّلون والتائبون
كما سيكون استخدام المنهج الديالكتيكي لإظهار حقيقة المتحوّلين والتائبين وفضح ادّعاءاتهم، حتى وإنْ لبسوا الكثير من البراقع، بتبرير انتصار الليبرالية المزعوم والهيمنة على العالم والرغبة في التساوق مع الوجه المتسيّد للعولمة بكلّ ما يعكسه من كآبة وسوء طالع والمزيد من الظلم والحرمان والاستغلال، بمبررات أنّ هذا التطوّر لا يمكن ردّه. وحتى لو بدا التمسّك بماركس والماركسية، في إطار الوضعية النقدية، الأساس المنهجي الذي يمكن الاستناد إليه، فإنّ هناك من سيقول: إنه نوع من «البَطَر» الفكري والثقافي أو شكلٌ من أشكال «المثاقفة»، حتى وإنْ كانت القراءة النقدية إبداعية وتوليدية وليست استنساخاً أو تقليداً جامداً أو مبتذلاً. مهما يكن الأمر؛ فالمنهج الماركسي، بحسب قناعتي، ما زال يحتفظ بحيويته، بعدما ظنّ بعضهم أن مكان «الماركسية» أصبح «متحف التاريخ» أو خزانات الكتب وأدراج المكتبات، فمن هذا الذي سيأخذه مثل ذلك الحنين لكي «يعود» إلى ماركس و«الماركسية» بعدما تخلّى عنه وعنها «أصحابهما» وغلّاتهما، وفي بلدانها الأصلية حيث حكمت عقوداً من السنين، كما يقولون؟
ويعتبر بعضهم الآخر «العودة» إلى ماركس و«الماركسية» أو التشبّث بهما، بعدما شهد العالم العزوف عنهما، مغامرة ما بعدها مغامرة، حيث ازدحم الحاضر بفكر النهايات. ولهذا فإنّ نهاية «الماركسية» ستكون النتيجة المنطقية لأصحاب هذا الاتجاه، ولربما يستغربون متسائلين: وما الذي يدفع ببعض الماركسيين إلى التحدّث عن ماركسيتهم من دون حرج أو محاولات إخفاء أو تبرير، بما فيه حين يمارسون النقد الذاتي لتاريخهم الشخصي وتاريخ الحركة الماركسية والشيوعية، بل وتاريخ الفكر الماركسي، ومن موقع الاعتزاز والتقدير، في حين أنّ هناك من يشعر بالاستنكاف ويحاول التنصّل أو التبرير أو الإمعان في المزيد من التوبة في المبالغة والانتقال إلى المعسكر الآخر بحجج نظرية أو بدونها، بالإعلان أو الصمت والمراوغة في التبرير.
البحث عن الحقيقة
بعيداً من الانحياز العاطفي أو الفهم الجامد للانتماء الفكري، فإنّ رغبة أكيدة وصادقة هي ما يقف خلف هؤلاء المتشبّثين في البحث عن الحقيقة، من خلال إعادة قراءة «ماركسيّتهم» وتمركسهم في ضوء وقائع الثورة العلمية - التقنية وثورة الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام والمعلومات والطفرة الرقمية «الديجيتل»، وما أنجزته البشرية من علوم وتقدّم وعمران وجمال وحداثة من جهة، خصوصاً ونحن في صميم الطور الخامس من الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى دراسة التجارب التي حكمت باسم «الماركسية» وأسباب انتكاسها وفشلها، الجامدة منها أو المنفلتة أو المتحوّلة، لكي يستخدموا المنهج أداةً لتحليل وتفسير الظواهر المجتمعية من أجل تغيير المجتمع، وليس التشبث بالصيغ والقوالب التي عفا عليها الزمن. لعلّ هناك من يستغرب حين ينظر إلى من يقوم بمهمة التفتيش في بطون الكتب، لا سيّما الكلاسيكية، ويقرأ الجديد ويقلّب الحال، مراجعةً ونقداً واستشرافاً، وفي ظنّهم أنه يفعل ذلك عبثاً، إذ يسعى لتقديم قراءات «جديدة» لأفكار مضى عليها أكثر من قرن ونصف من الزمان، أو أنها محاولة لنفخ الروح فيها، خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وإذا كان مثل هذا الاختيار مغامرة، فلعلّها مغامرة فكرية مثيرة ونبيلة، هدفها جليل وصادق، بعدما انفضّ عنها المتجمّدون وتخلّى عنها المتفلتون وسخر منها المتحوّلون ونال منها التائبون، ولكن: ألسنا نغامر حين نبحث عن الحقيقة؟! لعلّ هناك من سيقول: إذا كانت «الماركسية» «موضة» ستينيات القرن الماضي، فهل سيتشبّث ماركسيو اليوم بموضة قديمة، كمن يذهب إلى الحج والناس عائدون؟ ثم ماذا يعني أن تكون ماركسياً اليوم؟ أمن باب المناكفة التي تقترب من إغواء عقيم ومجازفة محفوفة بالمخاطر والسير عكس التيار الذي قد يؤدي إلى المزيد من العزلة؟ فالعالم كلّه يتّجه نحو العولمة، والرأسمالية الإمبريالية تتخطّى الحدود والأوطان وتفكّك البنى والتراكيب وتعيد إلحاقها وتبعيّتها، لا سيّما لشعوب وأمم وبلدان الدول النامية، على الرغم من أزماتها المتكرّرة، خصوصاً أزمة عام 2008 - 2009 المستمرة، إلّا أنّ الرأسمالية الإمبريالية لا تزال تستطيع تجديد نفسها ومعالجة آثار أزماتها. كلّ هذه الأسئلة والإشكاليات تواجه الباحث، بل تدفعه إلى المزيد من تسليط الضوء على معنى أن يكون المرء ماركسياً هذا اليوم، أي أن يبقى مخلصاً للمنهج الجدلي وروحه الحيّة، التي كان ماركس «بتمركسه» الحلقة الذهبية الأولى والأساسية فيه، من دون أن يعني التمسّك بما قال به من آراء أو استنتاجات أو تعليمات، حتى وإن كان بعضها صالحاً لزمانه لكنه لم يعد يصلح لزماننا.
الماركسية العاميّة
خلال العقود الماضية، جوبهت بشدة أي محاولة جادة للنقد، سواء على الصعيد الفكري أو المراجعة النظرية أو في دراسة التجارب العملية، لأنّ بعضهم ظلّ مسجوناً في أوهامه أو أوهام غيره بحسب جيل دولوز، إذ من الصعوبة أحياناً أن تواجه مجموعة من الناس لتقول لهم إنّ تصوّراتهم، بل وقناعاتهم، عن العالم والكون والمستقبل كانت خاطئة أو حتى غير سلمية، فما بالك إذا كان بعضها قد بُني على الوهم؟ وأصبح الوهم يلد وهماً آخر، وهكذا، خصوصاً ما يمكن أن ندعوه سيادة «الماركسية العامية» التي رُسمت ملامحها بألوان زاهية وطُعِّمت بأحلام وردية عن مجتمع مثالي أقرب إلى السراب، في حين شهدت التجارب العملية للأنظمة الاشتراكية الشمولية الاستبدادية ممارسات وانتهاكات سافرة لا يربطها أي رابط بـ«الماركسية» العلمية ذات النزعة الإنسانية الواقعية، وهو الأمر الذي يقف وراء انتكاستها وتراجعها وانهيارها.
تزييف الوعي
لعلّ هذه المواجهة ضرورية، ومطلوبة أيضاً، لكي لا تستمر عملية تزييف الوعي أو تغييبه أو مغادرته، بحيث يسهم في تسلّل الخدر والذبول إلى أوساط الحالمين في غدٍ عادل وسعيد وممكن؛ بما يتجاوز واقعهم الراهن، وكذلك لكي لا تستمرّ تغذية الأوهام خارج نطاق ماركس و«ماركسيته» ومنهجه الجدلي من جهة، وذلك بالحاجة إلى استلهام وتطوير «الماركسية» بما يتناسب وحجم التطور في إطار من العقلانية والجدل والتفكير والتأويل الحرّ ورفض الابتزاز واحتكار الحقيقة والنطق باسمها من جهة أخرى.
بهذا المعنى، يكون الحديث عن العودة الجديدة لتأكيد عدم المغادرة أولاً، ثم الحضور ثانياً، لكن بعيداً عن القوالب والصيغ الجاهزة التي تخطّاها الزمن، وذلك من خلال إعمال الجدل والنقد اللذين يمثّلان جوهر «الماركسية»، واستخدام شروطها لإزالة ما علق بها من ترّهات وما أصابها من تحجّر وانكماش وقوقعة، أو محاولات التنصّل والتنكّر والتخلّي عن روحها وحيويتها بحجة مواكبة التطور وتغيّر الظروف بانتصار الليبرالية.
كما أنّ البحث، في إطار الوضعية النقدية، في «الماركسية» من خلال المنهج الجدلي يشكّل إحراجاً لأولئك المتجمّدين ولهؤلاء المتفلّتين أو المتحوّلين أو التائبين، خصوصاً من أنصار الجناح الحزبي التقليدي. وإذا كان النقاش والجدل قد بدأ بخصوص مفهوم ما بعد الحداثة، فالسؤال هو: أين مكان «الماركسية» وماركس منهما، وفي أيّ إطار يمكن الحديث عن «حضارات» ما بعد الحداثة، خصوصاً بعدما أخذت المركزية الأوروبية تقرّ بالتنوّع الثقافي للشعوب واحترام الثقافات المحلية التي تنكّرت لها في مرحلة الحداثة الأولى، لا سيّما إزاء العالم غير الأوروبي؟.
فكر النهايات
وإذا كان الحديث عن ماركس و«الماركسية» قد تراجع خلال العقدين ونيّف الماضية، خصوصاً بعد انهيار النموذج الاشتراكي البيروقراطي السوفياتي وسيادة الشعور بالانتصار النيوليبرالي، حيث بدأ التبشير بفكر النهايات، مثل «نهاية التاريخ» و«نهاية الفلسفة» و«نهاية الماركسية» و«نهاية الآيديولوجيا» و«نهاية اليوتوبيا»، وأصبح ذلك بمثابة التقليعة الجديدة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة؛ لكنّ الأمر لا يخلو من التباس، ففكر النهايات والحتميات التاريخية أريد لهما إعلان فوز النيوليبرالية ونماذجها حتى وإن استعانت بهيغل أو ماركس في إطار مقاربات جديدة، وإنْ بالمقلوب، فالهدف هو التدليل على فوز نموذج للتطور العالمي على آخر بحيث يغدو هذا الأخير هو الوحيد السائد.
ومثلما حاولت أوروبا تعميم نموذجها الكوني الرأسمالي، والتخلّص من البنى التقليدية المعيقة لتوسّع الرأسمالية في بلدانها، والبحث عن أسواق جديدة وموحّدة في كلّ بلد من هذه البلدان، عبر إنتاج موحّد لدولة قومية حديثة ذات هيكلية مؤسسية تستمدّ شرعيتها من الدساتير والقوانين الوضعية التي تعامل الإنسان كمعطى حقوقي وسوسيولوجي فردي وتتجاوز روابطه التقليدية؛ فإنّها حاولت أيضاً تشكيل العالم وفق مقاسات رسمتها العولمة التي ظلّت هي محورها وروحها التي تغطّي العالم كله (4).
لقد سارت أوروبا في طريق الحداثة التي تعني «العقلانية» و«العلمانية» و«المدنية» و«الديموقراطية»، أي رفض الغيبية والظلامية والشعوذة والتسلّط، واعتماد العقل أساساً لنظام معرفي يعتمد على الإنسان وحريته وخياراته، وليس لأيّ اعتبار خارجٍ عنه، وبعبارة أخرى، الاعتماد على الفرد والفردانية ومجتمع المصالح، فالدولة المدنية هي التي تضع مسافة بين الأديان والقوميات والمكوّنات الأخرى، على الرغم من أنّ هذه الدولة المركزية الأوروبية حاولت، في علاقتها بالبلدان النامية، تعميم هذا النموذج على المستوى العالمي، ليسود ويهيمن على العالم، ليس من خلال قوة المثل والإقناع ومن خلال علاقات متكافئة ومتساوية، بل عن طريق إلحاقه بأوروبا «الرأسمالية العقلانية» ذات النزعة الحداثية، وتلك إحدى المفارقات الكبرى.
* باحث عراقي
المصادر والهوامش
1- قارن: عبد الحسين شعبان - تحطيم المرايا في الماركسية والاختلاف، الدار العربية للعلوم العربية، بيروت، 2009. الحبر الأسود والحبر الأحمر: من ماركس إلى الماركسية، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، بيروت 2013.
2- ظلّ مفهوم الحداثة فضفاضاً بما حمله من اتّساع وشمولية، لا سيّما في الفنون البصرية والموسيقى والأدب والدراما وصولاً إلى الشعر والرواية التي طبعت أعمال العديد من المبدعين أمثال وولف وجويس وإليوت وبروست وريكله وغيرهم. أما مفهوم ما بعد الحداثة فقد اتّسم بالضبابية وعدم التحديد، لا سيّما بعد انتهاء عهد السرديات لجميع المذاهب والفلسفات الكبرى ذات النزعات الشمولية، حيث اتجه العالم إلى الإقرار بالتنوّع والتعدّدية والحق في الاختلاف، على الرغم من الاتجاه نحو التفكيك واللاتحديد. ويعتبر المفكر آلان تورين أنّ فكر ما بعد الحداثة يشكّل قطيعة مع أفكار الحداثة، حيث المجتمعات الصناعية المتضخمة التي لا تكفّ عن التسارع والاستهلاك الثقافي، وإذا كانت الحداثة قد استدعت سلطات مطلقة فإن هذه السلطات قد تفكّكت في عهد ما بعد الحداثة، بحيث شكلّت قطيعة أخرى مع النزعة التاريخية عن طريق إحلال التعدّدية الثقافية محلّ الوحدة.
انظر: شعبان، عبد الحسين: الحداثة وما بعدها، مجلة الحداثة، العدد الأول، القاهرة، حزيران/ يونيو، 2010.
قارن: عطية، أحمد عبد الحليم - (تحرير) ليتوار والوضع ما بعد الحداثي، (مؤلّف جماعي)، سلسلة أوراق فلسفية، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2011.
ويعتبر جان فرانسوا ليتوار، الأستاذ الأكاديمي في جامعة باريس الثامنة، أحد أكبر روّاد حركة ما بعد الحداثة، وقد ولد في فرساي عام 1924، وعمل بين عامي 1950-1952 في الجزائر التي شكّلت، كما قال، ضميره السياسي، حيث لاحظ آثار الاستعمار والفقر والتمييز عن قرب، وبعد عودته درس الفلسفة وتخرج من جامعة السوربون عام 1971، وكان عمره 47 عاماً، وتعاطف مع حركة الطلبة والعمال التي قادت احتجاجات واسعة في عام 1968.
ويعتبر ليتوار حركة ما بعد الحداثة، من الناحية المعرفية، خطاباً واقعياً ضد الشمولية والكليانية العمومية التي ظلّت تسيطر على الفكر الغربي منذ ما قبل ماكس فيبر. وتمثّل ما بعد الحداثة حركة فكرية تقوم على نقد، بل ورفض، الأسس التي ترتكز إليها الحضارة الغربية الحديثة، بما فيها مسلّماتها، وتعتبر أنّ الزمن قد تجاوزها.
انظر: ليتوار والوضع ما بعد الحداثي، تحرير د. أحمد عبد الحليم عطيه، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2011، ص11 (مقالة أحمد أبو زيد).
3- انظر: فوكوياما، فرانسيس: «نهاية التاريخ والإنسان الأخير»، ترجمة د. فؤاد شاهين ود.جميل قاسم ورضا الشابي، إشراف ومراجعة مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1998.
4 - قارن: خليل، فؤاد: «الماركسية» في البحث النقدي، دار الفارابي، بيروت، 2010، ص160-164.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا


