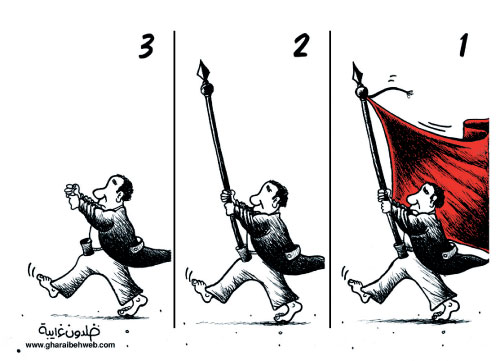وهو سؤال تجاهله طرابلسي في افتتاحيته منذ عنوانها المغلوط «اليسار في الزمن الثوري». فلو كان زمننا الحالي ثورياً حقاً، لكان يسارياً بالضرورة، أي زمن القطيعة مع النيوليبرالية بالذات. فالثورة ليست مجرد انتفاضة جماهيرية تنادي بإسقاط النظام كما يعتقد الكاتب، بل انتفاضة أو حركة شعبية أو حتى حركة انقلابية، تؤدي إلى انتقال السلطة من تحالف طبقي إلى تحالف طبقي نقيض، وليس من حزب إلى آخر، أو من نخبة سياسية إلى أخرى، كما هو عنوان الانتفاضات العربية التي يسميها طرابلسي «انتفاضات ضد النيوليبرالية»، بينما هي، بالملموس السياسي، انتفاضات تقع داخل سيطرة النيوليبرالية بالذات، لكنّها تسعى إلى اكتمالها بالليبرالية السياسية الموجهة.
لا تتقرّر طبيعة الانتفاضات من خلال طبيعة الآلام الاجتماعية للكتل الجماهيرية المشاركة فيها، بل من خلال برامج القوى السياسية المهيمنة على وعي تلك الكتل وحركتها. ولم يعد خافياً أنّ تلك القوى تتمثل في الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى. وهي، كلّها، قوى نيوليبرالية في المجال الاقتصادي الاجتماعي. فهي تؤمن بأولوية القطاع الخاص وبالخصخصة وحرية الأسواق والتجارة وتقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية. أي أنّها كمبرادورية بالكامل. ولأنّ من المستحيل الجمع بين الكمبرادورية الاقتصادية والتحرر الوطني، نرى القوى الإسلامية في السلطة، أو في الطريق إلى السلطة، تنقلب على خطابها السابق المعادي للغرب وإسرائيل، نحو خطاب التعاون أو المهادنة معهما. الخطاب الإسلاموي السابق لم يكن أصيلاً، بل كان أداة لمناهضة الجناح الاستبدادي الاحتكاري من الطبقة الكمبرادورية نفسها. ولذلك، فإنّ المضمون الملموس لشعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، ليس سوى تعبير عن الحاجة إلى نظام جديد يسمح بالتنافسية داخل تلك الطبقة، ويمنح المفقَرين الفتات، بالحدود التي تمنع انهيار الأنظمة النيوليبرالية.
يظنّ طرابلسي أنّ شعار «عمل، حرية، خبز» قد «وضع حق العمل والعدالة الاجتماعية في صلب العملية الديموقراطية»، في سياق وهمه القائل بأنّنا نشهد انتفاضات ضد النيوليبرالية. لكن قوى تجديد النيوليبرالية نفسها ترى أنّ العمالة الرخيصة في مصر، مثلاً، مهدورة بسبب احتكار «البزنس» من قبل النخبة الحاكمة المُطاحة والتي كانت ترفض توسيع صفوفها، وتعرقل التوسع في الاستثمارات وفرص استغلال العمل. الحق في العمل ليس شعاراً ضد النيوليبرالية، فهو لا يتعارض مع حق المُلكية ولا مع حق الشركات في تنظيم الدولة والمجتمع لصالح توسعها. بل إنّه، وحده، ليس حتى شعاراً ديموقراطياً. فلكي يكون كذلك، ينبغي ربطه بشروط العمل الإنسانية والحق في الأجر المتناسب مع كلفة سلة العيش الكريمة، وكذلك مع الحق في التنظيم النقابي والإضرابات العمالية. أما «الحرية»، فلا يمكن النظر إليها بمعزل عن محتواها الاجتماعي والسياسي: حرية «البزنس» والاستغلال والشركات، أم حرية النضال ضد «البزنس» والاستغلال والشركات؟ حرية التبعية للغرب الرأسمالي، أم حرية النضال ضد الإمبريالية؟ حرية المهادنة والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، أم حرية المقاومة؟ حرية الطائفة أم حرية المجتمع؟ حرية الفرد السلوكية والثقافية أم حرية الجماعات الفاشية في قمع تلك الحرية؟ حرية النقاب أم حرية السفور... إلخ؟
لا يمكن لليساري أن يمرّ على شعار «الحرية» من دون نقد محتواه، وتعيين معناه الاجتماعي السياسي في سياق تعيين الشروط الملموسة التي انطرح في سياقها. هنا، نكون بإزاء ليبرالي لا يساري، بل ويساري يريد التأسيس لنهج جديد مضاد للنيوليبرالية التي وجدت أنّ من المستحيل عليها الاستمرار من دون تأمين الخبز للجماهير الجائعة. ولذلك، فهي تفهم وتتفهّم مطالبة الكتل الجماهيرية المهمّشة المجوّعة بما يقيم أودها. وهل يفوتنا أنّ الإسلاميين بنوا جماهيريتهم من خلال برنامج توفير «الخبز» للجائعين؟ وقد اتضح الآن أنّ هذا البرنامج ليس مجرد تكتيك دعوي وانتخابي، بل هو جوهر استراتيجيتهم في إدارة المجتمع في ظل النيوليبرالية، وهذا ما يسمونه بالعدالة الاجتماعية. لكن اليساري هو من يريد اجتثاث الفقر وليس توفير الخبز للفقراء، وهو مَن يسعى إلى الثورة الاجتماعية وليس إلى العدالة الاجتماعية.
يقرأ طرابلسي اعتراف مديري صندوق النقد والبنك الدوليين بقصور النمو في الناتج الإجمالي المحلي في تونس ومصر عن معالجة مشكلة البطالة، وكأنّه انتصار ضد النيوليبرالية جرى تحت تأثير «الثورة»... ولا يتوقف، لكي يرى فيه الحاجة التي تلمسها الإمبريالية لتجديد وتوسيع النيوليبرالية في البلدين. وبالأساس، نلاحظ أنّ طرابلسي يقبل تلقائياً بمفهوم «النمو» النيوليبرالي باعتباره السياق الثابت للنقاش، ولا يقف، كيساري، لنسفه ومعارضته بمفهوم التنمية. ومن المعروف أنّ المفهومين متناقضان اجتماعياً. فالنموّ يركّز على تراكم الثروة بالأرقام المطلقة، بينما تركز التنمية على الأبعاد الاجتماعية والوطنية للمشاريع وتوزيع الثروة وتطور القوى العاملة وشروط العمل الملائمة من حيث المشاركة في الإدارة وسلّم الأجور الاجتماعي المتضمن تلبية احتياجات السكن والنقل والتعليم والطبابة والثقافة والترفيه... إلخ. يتناسى طرابلسي كل ذلك، ويكتفي بلوم الأنظمة التي تتخلى «عن كل جهد تنموي»! وكأنّ التنمية جهد يمكن إلحاقه بمجرى النمو، وليس نقيضه.
ولا أدعي بأنّ هذه أشياء لا يعرفها طرابلسي، بل أدعي بأنّها لا تشكّل، كما هو متوقع من يساري، الأساس في صلب تحليله. بالعكس نراه ينسرح في انتقائية بلا قيود لتأملات مثقف ليبرالي لا يلزمه المنطق الداخلي للتحليل ولا الشروط التاريخية العيانية التي تجري داخلها وليس باستقلال عنها، تأملاته «الحرة»! هنا، يستطيع المثقف أن يماهي بين النموذج النيوليبرالي الاستبدادي في بلدان كتونس ومصر، بجماهيرهما المفقَرة المهمشة، والنموذج الخليجي القائم على إعادة تصدير البترودولارات إلى المراكز الرأسمالية بجماهير الخليج التي تحظى بالرعاية الأبوية. وكأنّ النموذجين واحد! وكأنّ طرابلسي لا يلاحظ طبيعة العلاقة التبعية بين الأنظمة العربية النيوليبرالية وبين الأنظمة الخليجية التي تحميها الإمبريالية كبقرة مقدّسة. وهي تمارس، من موقعها كمحميات بالغة الثراء، دور القيادة في العالم العربي. ومما يستحق تشديد الانتباه أنّ الدور القيادي الخليجي لم يتراجع في ظل ما يسمى الربيع العربي، بل تفاقم إلى حد غير مسبوق. وكان على مثقف يساري يطمح بالتأسيس لفهم المرحلة، أن يطرح السؤال عن سبب ذلك ومعناه، بدلاً من تكرار النقد الصحافي لما يسمى «هدر» الثروات الخليجية.
تشكّل الأنظمة الخليجية المتمتعة بحصانة القوة الإمبريالية ــ كما ظهر جلياً في كسر المسعى العراقي لإخضاعها مطلع التسعينيات ــ موقعاً وسيطاً في الكمبرادورية العربية بين الأنظمة التابعة والرأسمال المعولم ومراكزه الإمبريالية. وتمرّ معظم العمليات التجارية والاستثمارات العقارية والمالية العربية، عبر الوساطة والشراكة الخليجية بالذات، لسببين، أولهما الفوائض المالية في الخليج وثانيهما تشابك اقتصاده الاندماجي بالمراكز الرأسمالية.
وبسبب قدرته على تمويل نمط استهلاكي لحياة شرائح اجتماعية متسعة في الداخل، وتمتعه بالحماية الإمبريالية في الخارج، تمكن الخليج من تطوير منظمة إقليمية فاعلة، هي مجلس التعاون الخليجي، ومركز إقليمي ودولي للعمليات الكمبرادورية في دبي، ومركز للعمليات السياسية والإعلامية والأمنية في قطر التي ساعدت نموذجيّة الشروط الخليجية فيها (مجتمع صغير مموّل، وثروات طائلة مستغلة بكفاءة، وحماية شاملة بالقواعد العسكرية الأميركية) حكّامها الأذكياء على تحويل الدوحة إلى عاصمة الخليج ومركزه كوسيط إقليمي فاعل للإمبريالية. ولا تخطئ العين أنّ ما يسمى الربيع العربي، أو «الزمن الثوري» بتعبير طرابلسيّ، قد منح ذلك الدور القَطري أبعاداً لم تكن متوقعة، ومكّن الخليج من تشديد هيمنته على البلدان العربية، خصوصاً «الثورية» منها، عبر الشريك المحلي المهيمن بدوره على الجماهير المنتفضة، أي قوى الإسلام السياسي. وتظهر تلك الهيمنة واضحة في البعد الأيديولوجي لنهضة الأصولية الدينية في شكلها الوهّابي، كما في البعد السياسي لعلاقات التبعية بين القوى المحمولة إلى السلطة في تونس وليبيا ومصر واليمن وسواها و«المركزين» القَطري والسعودي.
أما البترودولارات، فقد تبيّن أنّ لها وظيفة أخرى هي تمويل الحملات الانتخابية لقوى الإسلام السياسي، ودعم حكوماتها، ولاحقاً تكثيف الاستثمارات الكمبرادورية فيها بالشراكة مع النخب الإسلاموية التي تحظى بتأييد قواعد شعبية واسعة. نحن، بالطبع، لا نتحدث عن مؤامرة أبداً، لكنّنا لا نقع في وهم اعتبار كل انتفاضة جماهيرية أو حركة معارضة عملاً ثورياً. كلا. الانتفاضات الجماهيرية قد تكون، كما يرينا التاريخ بالملموس، عملاً رجعياً، بل ورأس حربة استعمارية كما حدث في ليبيا وكما يحدث في سوريا الآن. ومن هنا، نعتقد بأنّه لا مناص لليساري العربي من طرح السؤال المنهجي حول المعنى الموضوعي للدور الخليجي في «الربيع العربي»، فهل يمكننا ألا نرى في وجه من وجوه ذلك الربيع، غبار الصحراء، وخطة انقلاب، داخل النظام العربي، مكّن ويمكن الخليج من تبوء موقع القيادة العربية المطلقة. (الرياض، الثقيلة الحركة والذكاء، فهمت لاحقاً معنى دعم الدوحة للانتفاضات العربية).
كانت نخب النظام المباركي الاقتصادية تحتكر «البزنس» الكمبرادوري، مما ألّب أجنحة كمبرادورية مصرية ترغب في المشاركة في الكعكة ضد مبارك، بينما كان نظامه يتفلّت من الثقل الموضوعي للقيادة الخليجية، ويسعى إلى الاحتفاظ، يائساً، بموقع القيادة المصرية في النظام العربي التابع للإمبريالية. وهو ما جعل «ثورة» «25 يناير» أقرب إلى انقلاب سياسي مكّن الخليج وأتباعه المحليين (الإسلاميين) من كسر الاحتكار المباركي «للبزنس»، وإطاحة جهود نظامه للإبقاء على دور الوسيط الرئيسي للإمبريالية في المنطقة. ليس بلا معنى أنّ طرابلسي يشارك المرشح الرئاسي الإخواني خيرت الشاطر النظر إلى الأنظمة الاقتصادية النيوليبرالية، من زاوية مركزية هي «فضائح الحكام العرب المخلوعين» و«همجية تسخير السلطة في سبيل الإثراء»، لكن اليساري لا يعترض على فساد الكمبرادورية، بل يعترض على الكمبرادورية نفسها، لذلك لا يمكنه أن يتبع طرابلسي الذي يقترح أنّ «الديموقراطية هي الطريق إلى الاشتراكية»! فهذه الوصفة تصدر عن مثقف يقف خارج الجغرافيا والتاريخ الملموسين في العالم العربي، حيث الكتل الجماهيرية الكبرى المتعطّلة والمفقَرة والمهمّشة في حالة من الخمول الذهني والأمية والاستغراق في العصبيات المذهبية والطائفية والإثنية والجهوية والقبول بالقَدر الإلهيّ لنظم الاستغلال والامتيازات. وهو ما يجعل تلك الكتل قواعد للرجعية. إنّ وصفة الديموقراطية كطريق إلى الاشتراكية، ليست وصفة جديدة مبدعة، كما يصوّرها لنا طرابلسي. إنّها وصفة تيار في الحركة الاشتراكية العالمية، تيار الأممية الثانية، منذ مطلع القرن الفائت، ساجله لينين من موقع استراتيجية الثورة الاشتراكية. لكن ذلك السجال تشكّل في شروط أوروبية. وفي تلك الشروط، كان يمكن تقديم أطروحة متماسكة حول الانتقال الديموقراطي للاشتراكية؛ فمع تجذر أنظمة برجوازية ديموقراطية راسخة وطبقات عمالية منظمة وهيمنة فكرية للاشتراكية، كان يبدو أنّه يمكن التوصّل إلى تغيير اشتراكي بوسائل ديموقراطية. لكن التاريخ أفشل هذه الأطروحة مراراً، بالانتفاضات النازية والفاشية (الجماهيرية) أو بالانقلابات العسكرية أو التدخل العسكري والأمني الإمبريالي، كما حدث في تجارب القرن العشرين الذي انتهى أيضاً بسقوط الاشتراكية السلطوية. ما هو البديل العياني في الشروط العيانية للبلدان العربية؟ ذلك هو السؤال الذي تتطلب الإجابة عنه إبداعاً في الفكر والممارسة السياسية ليسار جديد. هذا السؤال غائب عن نظر طرابلسي الذي واصل، في افتتاحيته، الكلام المرسل على واجب اليسار في دعم المشروع الليبرالي، قبل أن يلطّفه بالاعتراف بأنّ «الثورات» العربية، هي «محط نزاع» مع التدخل الخارجي وقوى الإسلام السياسي. ويرى طرابلسي تلك القوى، كما نراها (ظلامية ورجعية ومهادنة للعدو الإسرائيلي ونيوليبرالية)، لكنّه لا يستطيع أن يرى أنّ التحالف الإمبريالي الخليجي الإسلاموي هو المهيمن فكرياً والمسيطر سياسياً والمدعوم جماهيرياً، في ما يسميه الكاتب «الزمن الثوري». فهل تكون مواجهة هذه الجبهة عن طريق «إرساء المشروع الديموقراطي لليسار» وهو لا يعدو كونه، كما يقترح طرابلسي، خليطاً من المطالب الليبرالية كالمساواة السياسية والقانونية والانتخابات وفصل السلطات، والمطالب الاجتماعية كالعمل والمعاش والسكن، والتأكيد على «المرجعية الزمنية والمدنية للتشريع»!
هكذا! وكفى الله اليساريين شر النضال الطبقي والوطني والاشتراكية (ستأتي من خلال الديموقراطية). فأين التدخل الإمبريالي من ذلك؟ وأين الخليج؟ والإخوان المسلمون والسلفيون والجماعات الإرهابية... إلخ؟ وماذا عن الشروط الموضوعية، الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، لتحقيق «المشروع اليساري». يستطيع طرابلسي أن ينسى كلّ ما يحيط بمشروعه الحلو، لسببين، أولهما أنّ رغباته وتطلعاته كمثقف كبير أهم من الواقع الفعلي، وثانيها أنّه ليس في ذلك «المشروع اليساري» أي نقطة تتعارض مع جوهر النيوليبرالية وسيطرة الإمبريالية. إنّها عرضٌ علماني على المائدة نفسها، ولكن بلا سند من جماهير (تناسبها النيوليبرالية الإسلامية، بسبب تخلّفها الثقافي، أكثر من نظيرتها العلمانية)، ولا سند من حزب يراه طرابلسي شيئاً فائتاً، ويمكن تعويضه بمجلة فصلية!
الأردن: لماذا خسرنا نقابة المعلمين؟
رغم أنّهم لم يشاركوا في نضال حركة المعلمين الباسل خلال العامين الفائتين، إلا في أضيق الحدود، حقق الإخوان المسلمون، فوزاً غير منتظر في أول انتخابات لنقابة المعلمين الأردنيين. من وجهة نظر ليبرالية، لن تكون هناك مشكلة في حصول «الإخوان» على أغلبية قيادية في النقابة، طالما وقع ذلك من خلال صندوقة الاقتراع. لكن، من وجهة نظر النضال الاجتماعي، نحن أمام نكسة. فقد وقعت النقابة الكبرى في البلاد في أيدي جسم قيادي من الامتثاليين المستعدين للتنازل عن حقوق كادحي التربية والتعليم في صفقات سياسية. وفي المحصلة، لم تعد النقابة تمثّل تلك الحركة التي ألهمت قطاع التعليم والحراك الشعبي والبلد كلّه.
لن تكون النقابة قادرة، كما كانت حركة المعلمين غير المقوننة، على خوض معارك كبرى، بسبب الافتقار إلى الإجماع وتقييد المبادرة والتناقض بين الشرعية المنبثقة عن العملية الانتخابية وبين فاعلية الكتلة النضالية المُقصاة. أذكر، مثلاً، أنّ «لجنة عمان الحرّة» التي كانت مسؤولة عن 80 في المئة من نشاطات العاصمة في حراك المعلمين، خسرت، في الانتخابات شرعيتها القيادية، بينما خسرت النقابة القدرة النضالية للّجنة المبعدة. ومثال آخر: معلمات ومعلمو الكرك من التيارات الوطنية، ممن كان تضامنهم الشجاع مركزاً أساسياً لنضال المعلمين، فقدوا اليوم وحدتهم، وتفرقوا إلى مجموعتين، إحداهما متحالفة مع «الإخوان». وهو شقاق سينهك فرع النقابة الكركي.
نكرّر، إذاً، أنّ المشكلة الجوهرية لنتائج انتخابات نقابة المعلمين هي أنّ تلك النتائج لا تعكس واقع حركة المعلمين من جهة، بينما أدت إلى انشقاق في صفوف وحدة تلك الحركة من جهة أخرى. وهو ما يعني أنّنا حصلنا، في النهاية، على نقابة ستلتحق بسواها من النقابات المهنية القائمة، من حيث جمودها وانشقاقاتها الداخلية وانفصالها عن الحيوية السياسية للقطاع الذي تمثله.
لمَ حدث ذلك؟
أولاً، بسبب النظام الانتخابي الأكثري أو الأغلبي (واحد ــ صفر) الذي يمكّن الأقلية المنظمة المموّلة من الفوز السهل، ويقصي الأغلبية الفعلية التعددية الطابع عن التمثيل بما يناسب حجمها. ومثال انتخابات فرع العاصمة واضح الدلالة: فالقائمتان المدنيتان في عمان حصلتا على 11000صوت، وخسرتا لصالح القائمة الإخوانية التي حصلت على 9000 صوت. ولو كان النظام الانتخابي نسبياً، لكان تمثيل العاصمة متوازناً.
ثانياً، بسبب تفكك اللجنة الوطنية لحركة المعلمين، عشية الانتخابات، مما سمح باختراقها إخوانياً، واستخدام شعبيتها غطاء لصالح القوائم الإخوانية الصرف. والملوم في ذلك ليس شخصاً بعينه اراد ضمان موقع النقيب، وإنما نهج البراغماتية والمساومة والفردية وتقديس الأشخاص، مما يتيح لهذا القيادي أو ذاك، التحكّم بالدفّة.
ثالثاً، بسبب التبعثر المعتاد في صفوف القوى الوطنية والديموقراطية والمدنية. وهو تبعثر ناجم، بالأساس، عن اضطراب البرنامج السياسي التقدمي.
رابعاً، بسبب ضعف الموارد والخبرة في صفوف الحركة الوطنية الاجتماعية الجديدة والمستجدة على العمل السياسي، في مقابل تكدّس الموارد المالية الضخمة والخبرة لدى «الإخوان المسلمين».
العبرة المستقاة من المعركة الانتخابية في نقابة المعلمين الأردنيين هي أنّ أيّ انتخابات يخوضها التقدميون من دون إطار أيديولوجي واضح، سوف يخسرونها مضاعفة، في النتائج الانتخابية وفي وحدة الحركة.
بدايات... «يسارية أنيقة مسليّة»
«بدايات» مجلة «فصلية فكرية ثقافية» تقول في تعريف نفسها إنّها تصدر للمساهمة في «بلورة المشروع اليساري في العالم العربي». وقد عجّلت «الثورات الشعبية العربية» في دفعها إلى «حلبة المغامرة الصحفية». وبالفعل، عنونت المجلة عددها الأول بعبارة «الثورات بشبابها» في ما بدا أنّه قبول وتحية للطابع «الشبابي» لما يسمى الربيع العربي.
الافتتاحية السياسية الرئيسية كتبها فوّاز طرابلسي، رئيس تحرير «بدايات» التي تميزت بإخراج جميل في الشكل، ومؤثر في عرض المادة ومريح للقارئ (أنجزته جنى طرابلسي). وقد تناغم ذلك مع كون المجلة مسلية حقاً. اليسار الليبرالي خفيف الظل فعلاً.
«بدايات» أقرب إلى كشكول من الموادّ والمقالات والمداخلات والمواقف، لا يجمعها جامع سوى أنّ كتابها يساريون أو يساريون سابقون، تربطها خيوط لا تُرى بـ«يسار» ثورة الأرز المجيدة! ولذلك، فإنّ «بدايات» لا تقول شيئاً محدداً سوى أنّها تحرّض على النظام السوري، مباشرة والتفافاً، بصراخ كما يفعل إلياس خوري، أو بمكر كما يفعل المحرر.
ينعى خوري، في «تأملات في الشقاء اللبناني»، فشل ثورة الأرز المتبدي في صمت بيروت عن المجازر التي تقع على مسافة 120 كيلومتراً، حيث الثورة السورية، ثورة الحرية التي لا تجد سوى القليل من الشباب اللبنانيين لنصرتها (يقمعهم الشبّيحة). لكن خوري الذي يسترسل بأشياء من هذا القبيل، يُغفل، ربما متعمداً، نهوض أنصار حرية سوريا اللبنانيين من سلفيين و«قوات» وحريريين... إلخ، مما يؤكد وحدة الثورتين في البلدين الشقيقين!
في «سلمية سلمية، ضد القتل» لمحمد دحنون، تأكيد على قوة الحق في مواجهة عنف السلطة. وهي مقاربة صحيحة فعلاً لأنّ التوازن الاستراتيجي بين الجماهير والسلطة، لا يتحقق في ميدان العنف، لكن في الميدان الأخلاقي. ولكن القارئ الذي يدين، بلا التباس، العنف السلطوي في سوريا، يظل يتساءل عن الموقف اليساري من عنف المعارضة. وكان دحنون سيفيدنا جدياً لو وضّح لنا كيف فشل أصدقاؤه في «مجموعة شباب داريا» في تعميم نبذ العنف، ولماذا لم تعد الاحتجاجات في سوريا، سلمية، وإنما عنفية ووحشية، بما يوازي السلوك السلطوي، بل ويزيد عليه بالعمليات الإرهابية العمياء.
ياسر منيف وعمر وضّاحي، من جهتهما، يقدمان عرضاً ممتازاً تحت عنوان «النيوليبرالية والاستبداد في سوريا»، لكنّهما يقعان في الخلط بين المعطيات القيّمة التي قدّماها في الكشف عن التحوّلات النيوليبرالية الكمبرادورية التي أدت إلى الانتفاضة في سوريا وبين هذه الانتفاضة نفسها، بما هي مسعى لاستكمال تلك التحوّلات، لا عملاً ثورياً ضدها. فما يسمى «الثورة السورية» هو في المجال الاقتصادي الاجتماعي، حركة هدفها كسر المعيقات السلطوية أمام النيوليبرالية، وكسر احتكارها من قبل نخبة النظام، وليس إسقاط النيوليبرالية التي ستنتقل من الاقتران باستبدادية البعثيين إلى الاقتران باستبدادية الإسلاميين. كذلك، يتجاهل الباحثان الأبعاد الجيوسياسية للصراع في سوريا وحولها. وهو التجاهل الذي يورّط بعض اليساريين في مواقف لا وطنية، بل ويحشرهم، مع الخليجيين والإسلاميين، في معسكر النيتو.
يتذاكى محرر «بدايات» في تذكير بقايا الحركة الوطنية اللبنانية والفلسطينيين بالتدخّل السوري في لبنان منتصف السبعينيات. ففي ما سمّته «ويكليكس قبل ويكليكس»، نشرت «بدايات» نصوص وثائق أميركية حول التدخل العسكري السوري في لبنان 1976. والوظيفة الراهنة لهذا التذكر واضحة من حيث وقوعها في باب التحريض والتحشيد، لا في باب التأريخ والتفكير.
حتى في زاوية «يا عين» المخصصة للثقافة البصرية، يحضر التحشيد ضد النظام السوري في رسومات رندا مداح، بعنوان «الجولان المعلق بين احتلال واستبداد». ولم نفهم ما إذا كان الاستبداد يمنع المقاومة والقتال لاسترداد الجولان ـ كما نريد ـ أم أنّه يمنع التسوية مع إسرائيل بشأن الجولان، كما يريد المعارض عبد الحليم خدام؟
بمكر لا ينسجم، في رأيي، مع المثقفية والوفاء، يستخدم المحرّر اسم ومكانة الراحل جوزف سماحة، من أجل تبرير ضمني للعدوان الإمبريالي الخليجي على ليبيا. فمن بين مئات النصوص الدالة التي يمكن استذكارها من ارشيف سماحة، يعيد المحرر نشر مقال سماحة ضد القذافي ووعيه الصحراوي. المقال المنشور، لأول مرة، في 1989، كان ثورياً في وقته، لكن سماحة لو كان حياً اليوم، فإنّه، استناداً إلى منطق فكره بالذات، لن يعيد نشره، بل سيدين بقوة حرب النيتو الإجرامية ضد ليبيا التي استبدلت بصحراوية القذافي، صحراوية قَطرية أكثر إجراماً، حوّلت ليبيا إلى صومال جديدة.
ويتبدى مكر المحرر الذي استذكر المقاوم سماحة لصالح النيتو، في استذكاره ليبرالياً من مثقفي ثورة الأرز، سمير قصير، في مقال قديم له حول المقاومة في جنوب لبنان. المقال، في حينه، 1984، كان ممتازاً، لكن قصير، بعده، انتقل إلى المعسكر المضادّ. واستذكاره، هنا، له معنى التعريض الماكر بالمقاومة الفعلية الراهنة وخياراتها السياسية.
في الإيجابيات، هناك نصوص «الثورات بشبابها»، المكتوبة بحيوية من قبل شباب شاركوا في الانتفاضات العربية. النصوص، لا سيما نصوص جمال جبران وعلي الديري، وخصوصاً نص بشرى المقطري، بالغة الغنى والحيوية، لكن دراسة ميسون سكرية بعنوان «الشباب العربي وتربية العولمة» ليس له مكان في هذا الملف.
أهم المقالات الخاصة بـ«بدايات»، بحث صلاح عمروسي «اقتصاد السوق الإسلامي: البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للإخوان المسلمين في مصر». وهو يضيء المضمون النيوليبرالي لذلك البرنامج.
(ن.ح)