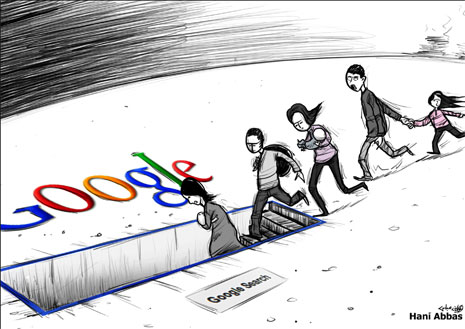كانت قد دخلت علينا أول أيام الربيع، بيد أن دكاكين الأسواق في يافا كانت قد خلت، وسكن صخب الأندية والمسارح والحدائق. كان الجميع يشعر بأن البلاد كلها صارت جثةً نؤجل دفنها، ونشغلُ خواطرنا بالإنكار، حتى داهمنا فجرٌ لم نميز فيه صيحات الناس من أصوات القنابل، يهدُرُ البحر غاضباً كأنه يسعى نحونا منقذاً ومعيناً، وينزاح الناس عن مدينتهم مواكبَ نحو البحر وأخرى نحو الطرق التي يظنونها لم تزل آمنة. كلٌ يرضى من الغنيمة بالنجاة.
كنتُ في الثالثة عشرة من عمري حين حطت رحالنا في صيدا، كنا موفوري الحظ، لم يكن علينا سوى أن نتجرع مرارة اللجوء، وحرارة الفقد، دون ذله وحاجته. لم نواجه العناء الذي واجهه مئات الآلاف من الذين نزحوا عن موتهم إلى انتظارهم، ليسكنوا العراء والكهوف، أو خيم المؤسسات الدولية في أحسن الأحوال. كان والدي لا يزال وادعاً يحتفظ بجأشه وتصلبه، كان يأخذني معه إلى أحد المقاهي في صيدا، كانت تسمى قهوة القزاز، صار المقهى بعد موجات القدوم المتتالية للفلسطينيين ملتقىً يطمئن الناسُ فيه إلى بعضهم بعضا، ويتشاركون الأخبار التي يحظون بها من ناجٍ من مجزرةٍ حلت بأهله، أو من ضابط في أحد الجيوش العربية يحدثهم عن النصر الموعود أو عن الهزيمة المحتومة بعد دخول جيش الإنقاذ.
كان الجميعُ يمنّون أنفسهم ويؤكدون بعضهم لبعض أن العودة محتومةٌ بعد الخامس عشر من أيار. لم تكن عقول الناس لتقبل بأي طريقةٍ أن هذه الغربة سوف تطول. ولم يكن عقلي ليفهم لماذا نعاني كل هذا الشقاء، لو أن الأمر كله مجرد أسابيع. لماذا لا يدخل جيشُ الانقاذ الآن؟ لم لم يدخل قبل الآن ليجنب الكثيرين رحلةً لا تفعلُ أقلّ من أن تصلبهم أحياءً أمام جثث فلذاتهم، وتتهم مروءتهم بكل قسوة.
حين بدأ يقينُ العودة يتحولُ تدريجاً إلى فكرةٍ ،تحتاج إلى نقاش أطول مما تستغرقه كلمةٌ واحدةٌ، يلقيها رجلٌ، بعد أن يرمي حجارة النرد، انتقلنا إلى دمشق. مطلع الخمسينيات، كان والدي يحاول أن يستعيد حرفته الأولى، ويبدأ من جديدٍ عمله في دمشق. التحقت بالمدرسة الثانوية الأهلية في سوق ساروجة، حيث تجاوزت أفكاري عن فلسطين الفضاء الذي شكلته أحاديث أبي وأصدقائه.كان عددٌ من زملائي الفلسطينين قد انتسبوا إلى الأحزاب العربية التي كانت ترى في قضيتهم، مركز الجذب الرئيسي في دعايتها. لكن السؤال الذي كان يقدح في عقلي عن هذه الأحزاب، أن شيئاً لم يتغير منذ ضاعت فلسطين. أقول ضاعت حتى لا يحمل أحدٌ وزر ضياعها، وإن كنا نقول إنه لا بد أن موازين عالمنا، على الأقل، قد انقلبت لينتهي الأمر بنا لاجئين دون بلادنا، وبفلسطين لاجئةً دون أهلها، فإنه على هذه الموازين أن تتغير حتى نستطيع أن نفكر مرةً أخرى كيف نرد أنفسنا إلى فلسطين، ونردها إلينا. أما على هذا الحال، فإن شيئاً لم يتغير، وأسباب هزيمتنا ما زالت تقف وراء ظهورنا تصفعنا كل مرةٍ نحاول فيها النظر إلى ما ضيعناه وراءنا.
بقيتُ حتى أواخر الخمسينيات أغسل رأسي بالأفكار ذاتها التي ينتجها، وأستمع بصمتٍ للحوارات التي لا تنتهي في بيتنا وفي دكان أبي وبين زملاء المدرسة.جُل هذه الحوارات دار حول حتمية التغيير في واقعنا العربي، وضرورة التخلص من الأنظمة المستبدة والرجعية حتى نستعيد نحن العرب وحدتنا ونستعيد بها فلسطين. وكانت أصواتٌ قليلةٌ تكاد تكون خجولة تتكلم عن ضرورة أن يتولى الفلسطينينون أنفسهم زمام قضيتهم، لكن هذه الأصوات كانت أكثر الأصواتِ عرضة للاتهام والتشكيك. كانت الآمالُ معقودةً على ثورة الضباط الأحرار في مصر، وعلى التشكيلات السرية في الجيوش العربية، التي يُحكى عن استعداداتها للانقضاض على الأنظمة المستبدة.
كان البعضُ يرى الانفراج في انتصار مصر على العدوان في عام 1956، الانتصار الذي حين ينظرُ إليه كلُ من لا يشغله البحث اليائس عن الأمل يجده انتصاراً لإسرائيل وحدها، الدولة الحديثة النشأة التي فرضت شروط انتصارها على أكبر الدول العربية، وإحدى أعظم الحضارات السياسية والثقافية في المنطقة.
في عام ١٩٥٨، حصلت على شهادة البكالوريا، ثم ذهبت إلى مصر، لأدرس في كلية الطب بجامعة القاهرة. ومن عرف القاهرة في ذلك الزمان، فقد عرف طبائع الزمان كلها. كانت مدينة الأحلام التي يطمع فيها كلُ طامع. مدينة النوادي، والمسارح، والسينمات والمجلات التي تنضجُ عند منتصف الليل وتُوزع في ضوء المدينة الذي لا يختفي. لم تكن أيُ مدينة تشبهها في ذلك الزمان. ولم أكن لأتمنى شيئاً سوى أن أعيش فيها مرتين، مرةً وأنا مقبلٌ على الحياة، وأخرى وأنا مدبرٌ عنها. دام حال عجبي من صخبِ هذه المدينة الساحر، ومن فرادة الأُنسِ فيها، حتى أُطفئت أنوارُ المدينةِ كلُها في ليلةٍ واحدة.
طوال خمسة عشر عاما كان العالم العربي كله يحيا بنبض القاهرة، كنا مع أغاني عبد الحليم نخوض حربا جديدة في كل ليلة وتنتصر فيها، بل نظن أن مصنعاً يُنشأ مع كل قصيدة ولحن يملآن آذاننا. وحين هُزمنا، لم نسمع حتى أصوات بنادقنا، ولم نسمع إلا الرعد يهز ما تبقى من ادراكنا. كانت هزيمتنا تختلف تماماً عن رحيلنا الأول. لقد تغيرت الموازين التي كنا نظنها قائمة، وجعلت ما كنا نسميه “الكيان» دولةً لها اليد الطولى في واقعنا، فضلاً عن أنها شكّلت وعينا بكل ضراوة.
المثير للشفقة في تلك الأيام، أن هناك من كان يحاول إقناعنا بأننا هُزمنا لأننا لم نقاتل، وأن هذا بحد ذاته مدعاة حتى لا نعدّها هزيمة؟ لقد كانت غفلة؟ غفلت عيوننا عن العدو لحظاتٍ قليلة فاستغلها هذا العدو الغادر! هل تفهمني؟ كانوا يقولون لنا إننا لو قاتلنا ما كنا لنُهزم! فلماذا إذاً لم نقاتل؟! هل كان علينا أن نُحسن الظن بجارنا الطارئ؟ بطريقةٍ عجيبةٍ صارت أسباب الهزيمة هي ذاتها أسباب تمسكنا بالقائمين عليها. كان هذا تجلياً للدمار الذي ألحقته هزائمنا الداخلية والخارجية ليس بعقيدتنا الوطنية فحسب، بل بجذور عقيدتنا الإنسانية كذلك.
لكن كثيرين كانوا يرون هذه الصفعة القاسية على وجوهنا فرصةً حقيقية لأن نتحرر من أوهامنا عن أنفسنا، وفرصةً حقيقيةً للفدائيين الفلسطينيين لأن يتحرروا من قبضة الأنظمة العربية التي فقدت كل كبريائها في أول مواجهةٍ حقيقيةٍ مع العدو، كما رمت الهزيمة الكثيرين في قاع الخيبة، فإنها عززت لدى الكثيرين الإجابات التي صاغوها للأسئلة الدائرة حول ما تغير منذ النكبة حتى الآن: الحرب، كانت هي اجابتهم الواضحة.
قررت الرحيل مرةً أخرى، منهزماً وغير مكترثٍ بجبل الهزائم الذي خلفتُه ورائي. إلى برلين هذه المرة، المدينة التي تشبهني في جروحها العميقة التي لم تندمل. كانت حنونةً عليَ قدر ما يحنُ الضعفاء على بعضهم بعضا. لم أقضِ فيها وقتاً طويلاً، لكن صارت لي فيها حبيبةٌ كنتُ على وشك الزواج بها، حتى لوح لي أملٌ إلى فلسطين كنتُ قد وعدتُ نفسي ألا أعود إليه منذ هزيمتنا الأخيرة. لكن الأمل يبدو صادقاً هذه المرة، صادقاً كصدق البلاد ذاتها. هذه المرة فقط.
نحن ــ الفلسطينيين ــ نحمل سلاحنا بأيدينا، وندير معركتنا بأنفسنا، لكن، ماذا عن هذه الرقيقة التي منحتني زهرة فؤادها، كيف كان لها أن ترضى مني بالوداع، كيف كنت سأبرر لها أنني سأرحل تاركاً قلبي وأمشي عارياً كالريح التي لا تعرفُ أين تنتهي. لم أستطع أن أقول شيئاً، رحلتُ دون أدنى وداع، وتركتُ قلبي ورائي ظاناً أنني سألتقيه هناك; في قلبِ الأرض المحتلة.
توجهت إلى الجزائر مع مجموعة من الأصدقاء الذين كانوا قد التحقوا في وقتٍ سابقٍ لقدومي بأحد التنظيمات الفلسطينية المسلحة في ألمانيا الغربية. تفرغنا في أحد المعسكرات لمدة شهرٍ تدربنا فيه على السلاح الخفيف، انتقلنا بعد ذلك إلى دمشق، ثم إلى جنوب لبنان، التحقت بالطلائع المسلحة هناك برغم أنني كنت قد جاوزت الثلاثين.
صرت أرى نفسي، برغم كبر سني مقارنةً بزملائي، طفلاً يتكوّن وعيه وتكبر يداه أمام عينيه. كنا نتوزع في دوريات ليليةٍ نراقب الحدود يوميا. كان الجميعُ يرى أن دوري كطبيب له أن يخدم الثورة بقدرٍ أكبر من دوري كمقاتل، وكنتُ أعلم في قرارة نفسي أنني أحمل مشرط الجراح أفضل مما أحمل البندقية، التي لم تكن أصلاً متوافرة، فعدد البنادق المتوافر كان في ذلك الوقت قليلاً جداً مقارنةً بعدد الفدائيين، لكنني على الرغم من هذا كنتُ مُصراً على أن أكون بالقرب من فلسطين قدر ما أمكن، بغض النظر عن الدور الذي يمكنني القيام به. وقد كان لي ذلك.
أدركت حينئذ جانبا من الامل لم أكن أعرفه: الأمل المسلح. صرت ارى فلسطين ملء عيني كما أرى نيشان بندقيتي. صرت أشعر بأن قلبي الحر ينبض للسماء التي لا حدود لها. كنت أرى فلسطين كل يوم، أزورها كل ليلة وأعدها بعناق قريب. وبرغم يقيني بأن العدو يترصد لنا في دُشمِه ومعسكراته، فإنني كنتُ سعيداً ومطمئناً بالقدر الذي يجدر بي وأنا على أرضي وفي بيتي المنيع.
كان النصف الأول من السبعينيات زماناً يكتب تاريخاً بأكلمه، كانت الثورة صادقةً على أشدها، وكانت سماءُ فلسطين رحبةً نلجأ إليها كلما استعصت علينا الإجابات، حتى صارت ذات السماء ملبدةً بإجابات لم يكن يخفى على أحدٍ زيفُها، وحتى صرت أشم رائحة الهزيمة القاسية. قررت الرحيل قبل حتى أن أحاول دفع الهزيمة عن نفسي على الأقل. كان هروباً، هذا ما قاله لي الكثيرون. نعم لقد جبُنت، لكن شجاعتي لم تكن لتكف عنا الهزيمة. كانت مشاهد الخروج من بيروت بعد رحيلي بخمس سنين تزرع كل بنادق الفدائيين في صدري، شاهدتها هنا من على مقعدي في لندن حيث أتممت دراستي وقد اِبيَضَّ فوداي.
مرت بعد ذلك سنينٌ باردةٌ، لم يكن من المفاجئ أن نشاهد بعدها عودة الجنرالات إلى فلسطين، واكتفاءهم بهذا القدر من الوطن، إن صح أن يكون وطناً. صارت هزائمنا بعد ذلك تحمل قدراً أقل من المرارة. فلم يعد أملٌ بالانتصار يعتري أيَّنا. الأمل، هذا اللعين، لولاه لما غشيت قلوبَنا الحسرة.
عاد اللعين يطاردني، وربما يطارد الكثيرين غيري، حين هتف الناس في كل الميادين بصوتٍ واحد، في تونس، وفي مصر، وليبيا، واليمن وسوريا والعراق، في كل مكانٍ نهشه الاستبداد، في كل العواصم التي تحولت إلى شركات أو إلى اقطاعيات. كان شكل الأمل حينها مختلفاً. خدعني مرةً أخرى، صدقته أنا السبعيني الذي عرف من أخبار الزمان ما عرف. كم كنتُ أخشى أن ينكشف زيف الأمل بعد خمسة عشر عاماً أخرى، نمني فيها أنفسنا بأن يكون لنا وطن، لكن يبدو أن الزمان صار أشد رأفةً بنا، فأسرع بالخيبة إلينا حتى لا نحبس أنفاسنا سنين طويلةً نحسب فيها المسافة بيننا وبين الانتصار المحتوم، فمصائبنا العاجلة خيرٌ من مصائبنا الآجلة. وكلها يا بُني مصائب.
كنت تحت ماربل آرتش، وكان أمام عينيَ يجتمعُ الناس كلٌ بجسده وذاكرته، تعتريهم خطيئتي ذاتها، الأمل مرةً أخرى. بينهم أطفالٌ ربما تقلُ أعمارهم عن عمر الثورات التي نهضت في شوارعنا ولا أدري بعدُ ما فعلت بقلوبنا، وربما ولدوا قبل هذا اليوم في مخيمِ للاجئين في صحاري البرد والقيظ قبل أن يصيروا مثلي لاجئين في صحاري الروح في أوروبا. ربما تحمل قلوبهم ما كان يحمله قلبي قبل بضع عقود، وربما لم يتبقَ لهم إلا ما يُقيتُ أيامهم العادية التي يعيشونها الآن، لكن من قُتلوا ما زالت دماؤهم حرّى مهما مر عليها الوقت، ومهما أصاب الياس أمثالي من الناس، وإن القاتل ما زال يدبُ على الأرض، وما زالت سكاكينه حامية.
لم تسكنّي الحماسة لكي أترجل نحو المجتمعين وأشاركهم تآزرهم. وإنني وإن كنتُ أعلم أنه لا يجوز للحر أن يشاهد الموت من على مقعده، فإنني أجلس الآن هنا أشاهد موت الآخرين من على مقعدي، وأتمنى لو أنه كان بوسعي أن أقول للضحايا إنهم لم يموتوا وحدهم.
الآن يا بُني، لا أعرف إن كان الله قد أراد بي خيراً حين أطال في عمري لأشاهد كل الأشياء التي أحببتها تُقتلع من روحي، ولأشاهد كل البنادق التي هتفت لأجلها تُزرع في صدري. أنا هنا، أقترفُ الحنين، وأشاهدُ موت الآخرين البعيدين من على مقعدي، وأتمنى لو أنني أنسى طعم التلال وخواطر الصبا. بُني، إن أغراكَ زمانُك بالنسيان، فإرخِ له زمام قلبك، ولا تسأل عن أشياء لا تملك الإجابة عنها.
* كل الشخوص الواردة في هذه القصة وجُل أحداثها تخيلية.
قصة | إرخ زمام قلبك