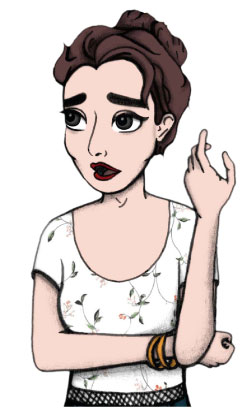لم أتحمّل يوماً صوت أبي عالياً في البيت. كنت أحشر جسدي تحت اللحاف وأصطنع طنيناً خفيفاً بصوتي، كي تخفت الضجّة في الخارج. لا أريد أن أسمع أبي يصرخ، ولا نحيب أمّي وهي تردّ عليه بصوتٍ متهدّج من فرط ما تكاثفت الدموع في حنجرتها وتلعثم كلامها. لم يكن أبي عصبياً، وأمي لم تكن ضعيفة. هذه قصة حُشرت في رأسي حين عشت حكاية سارة (اسم مستعار) جارتنا، من دون أن أعترف لها أنّي كنت أسمع صراخها المتكسّر يومياً خلف جدار غرفتي.
كنت أطفئ الضوء حتى أغرق بالعتمة. أستلقي على سريري كي أمهّد للنوم. أتقلّب قليلاً. أتفقّد هاتفي حتى يثقل النعاس. لكنّي بقيت لفترة طويلة أستيقظ في الليل. أنظر إلى ساعة الهاتف، التي تكون بين الثانية والثالثة فجراً. أسمع صوت صراخاً يخفّف الحائط الفاصل من علوّه. صراخ قريب، يعلو ويتضاءل رويداً رويداً حتى يُكتم نهائياً. ثم يعلو وتتغير نغمته. أحاول استراق السمع عبر لصق أذني في الحائط البارد، في محاولة لالتقاط أي كلمة تقولها، ولا أفلح. لا أسمع طرفاً آخر أيضاً. هو صوت سارة فقط. أعرف صوتها. أطابقه صباحاً مع صوت المرأة وهي تصرخ لبائع الخضر بأن يتمهّل كي تنزل إليه.
هي سارة إذاً، وهذا زوجها في البيت. سمعت صوت سيارته وهو يركنها في مدخل البناية. ولم يكن هناك فارق كبير بين وقع قدميه على الدرج وإغلاقه باب بيته وبين صراخ سارة. كنت كلما التقيتها، حدّثتني عن زوجها بعيون لامعة. أخبرتني كم يحبّها وكم من المرّات حثّها على ترك العمل كي ترتاح. أتفحّص وجهها وهي تحكي. ألملم خيباته برأفة، وأعرف أنها تكذب. أعرف ذلك من النّشيج المتقطّع الخارج من صدرها وهي مسترسلة بالحديث. تحكي من دون توقّف، ولا تترك لي مجالاً كي أعقّب، حتى لكي أحسدها على زوجها الذي يحبّها. ترمي الحديث في جهة مجهولة. هناك شيء داخلها يُولول. لم أسألها يوماً عن زوجها، لأني إن فعلت، ستفضحني عيناي، سأشيح بنظري عنها إن شَعَرتْ بمعرفتي بشيء ما. كانت تحكي بمفردها، ولا رغبة لها أن تسمع. تريد أن تكذّب الرجل الليليّ.
لم أعد أستطيع النوم قبل تفقّد صوت سارة. أريد أن أتأكد أنها لا تزال على قيد الحياة، لأنّها اختفت عن الأنظار لأيام. أريدها أن تصرخ كي أطمئنّ وأنام. فكرت كثيراً بالتحجج بشيء طارئ كي أطرق باب بيتها وأخلّصها من زوجها. فكرت بحلولٍ سورياليَة كثيرة، بعدما تفاقم قلقي. سارة البنت العشرينيّة، لم يزر بيتها أحد. كلما دعوتها إلى بيتي اعتذرت لعدم ردّ الدعوة في بيتها بسبب «التعزيل» أو لأن أهلها القاطنين في الجنوب جاؤوا لزيارتها وسيبقون عندها لأسابيع.
لكن في إحدى المرات، تقصدت افتعال مشكلة أمام باب بيتها بالتواطؤ مع جارتنا جنى. فتحت باب بيتها وحاولت أن تهدّئني وهي متسمّرة أمام العتبة. لم أهدأ. افتعلت صراخاً عالياً، حتى شعرت أنها مرغمة على استقبالي، أنا وجنى، في بيتها كي تلطّف الأجواء بفنجان قهوة ساخن. اعترفتُ لسارة بكلّ شيء. بصوتها الذي ينخر أذنيّ كلّما هممت للنوم. لم تستغرب ذلك، ولم تكذب حينها. قالت إن زوجها ينتظر منها طفلاً. كان متزوجاً قبل أن ترتبط به ولم تنجب له زوجته السابقة أولاداً. لم يمض على زواج سارة سوى سنة ونصف، لكنه لا يستثني يوماً من دون علاقة جنسية معها، ولا يدخل إلى البيت من دون جهاز فحص الحمل. كان كلما وجد النتيجة سلبيّة، شتمها وضربها بقدميه على بطنها.
كانت تخاف أن تطلب منه الذهاب إلى طبيب لإجراء الفحوص، لوجود احتمالٍ كبير أن تكون المشكلة منه. لم تحكِ سارة أي شيء عن زوجها. لم تؤنّبه. لم تغضب منه في حديثها. كانت تسوق المبررات لتصرفاته في كلّ جملها. لا تترك مجالاً للتعقيب. تفكر في أنها لا تستحقه، فهو يريد أطفالاً وهي لا تزال عاجزة عن ذلك. أخذها شرودها لدقائق، ثم نظرت إلينا بأسى وقالت بما معناه، أن يضربها يومياً أفضل من أن يتزوج امرأة أخرى. أخذت رشفة من فنجان القهوة المرّ وراحت تضحك عالياً. تضحك من دون توقف. حتى لفّها صمت طويل امتدّ حتى اليوم، حين أنجبت منه فتاة بعد سنتين، فلم يبق له أثر. حتى أن سارة لا تزال تجهل مكانه. تذكر أن آخر جملة قالها قبل أن «يطبش» الباب خلفه «لو كان إجا الصبي، كنّا صلّينا عالنبي».
«لو كان إجا الصّبي»