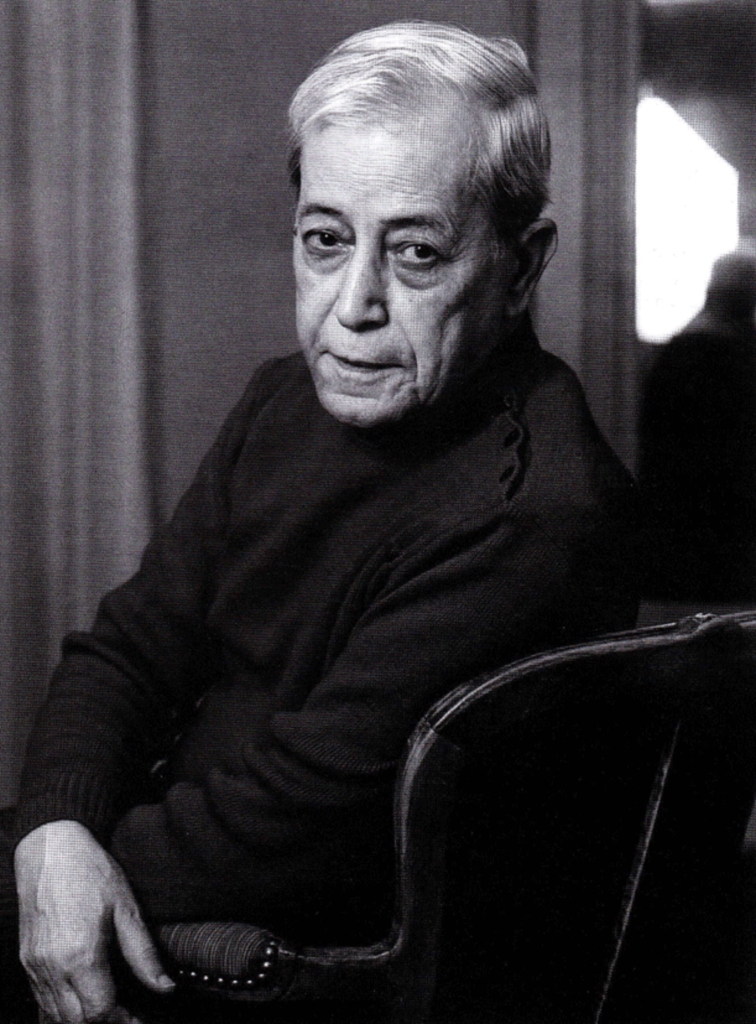
المقولة أعلاه مقتطفة من نص مجهول لمحمد ديب لم ير النور سوى بعد مرور 12 سنة على وفاته. نُشر هذا النص، للمرة الأولى، ضمن عدد خاص بالأدب الجزائري أصدرته مجلة Hesperia الاسبانية المتخصصة في الأدب المتوسطي، في حزيران (يونيو) 2015 (*). وفقاً للمجلة الإسبانية المرموقة، فإن أرملة محمد ديب، كوليت بيليسان، هي التي زوّدتها بهذا النص، بعدما عثرت عليه بين أوراق زوجها غير المنشورة. هكذا، صدر هذا النص الجريء، في البداية، مترجماً الى الإسبانية، قبل أن يُنشر أصله الفرنسي على موقع La plume francophone في كانون الثاني (يناير) 2016. في مرافعته ضد الخلفيات النيوكولونيالية التي تتحكم في موقف الإستبلشمنت الثقافي الفرنسي من إبداعات الأدباء المغاربيين، كتب محمد ديب: «بخلاف ما توحي به المظاهر المخادعة، فإن هؤلاء النقاد (الفرنسيين) يسلّطون على الكاتب المغاربي نظرة إقصائية تُمارس التفرقة والعزل، وتفرض عليه دونية لا فكاك ولا مخرج منها. ألا يُذكّركم ذلك بشيء ما؟ (إشارة ساخرة الى النظرة التي كانت سائدة أيام الاستعمار تجاه سكان المستعمرات بوصفهم شعوباً دونية يجب تلقينها الحضارة من قبل «الرجل الأبيض» المتفوق!). إذا كان الجواب نعم، فلا بد لنا، توخياً للإنصاف، أن نقول إنهم (أي النقاد الفرنسيين) كأفراد قد يكونون بريئين، في غالب الأحيان، لكن المنظومة الفكرية التي ينتمون إليها غير بريئة على الإطلاق».
ويضيف: «لا أتحدث فقط عمن لا يمتلكون سوى قدر ضحل من الثقافة، لكنهم يعتقدون أن ذلك القدر يكفيهم، أو يزيد، حين يتعلق الأمر بتقييم الكُتاب المغاربيين، فيطلقون العنان لأقلامهم دون خشية! هناك أيضاً ذلك الأسلوب الأكاديمي المتقن في دفع عمل أدبي الى الانغلاق على ذاته، بهدف جعل هذه الذات سجناً داخلياً لهذا الأدب. هذا التوجه الغالب حالياً في النقد الفرنسي يسلّط على الكاتب المغاربي نظرية تعمل على الزج به في سجن داخلي يجعله أسير ذاته المفترضة. ثم يجري تعميم ذلك، بشكل ضمني (بل معلن أحياناً)، لينسحب هذا السجن الداخلي، بشكل أشمل، على نظرة هذا الكاتب الى المجتمع وإلى الثقافة اللذين يتحدر منهما».
من منطلق رفض هذا الفخ النقدي المنصوب عمداً للكُتّاب المغاربيين في فرنسا، يواصل محمد ديب مرافعته ضد الاستبلشمنت الثقافي الغربي، قائلاً: «هؤلاء النقاد، الذين يتلذذون بتصنيف أعمال الكُتاب المغاربيين في فئات أدبية هامشية، كيف يخفى عليهم أننا لو نظرنا الى الأمور في شموليتها، من منظور عالمي، فإن الأدب والفكر اللذين تنتجهما أوروبا هما الهامشيان! لكن هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل بأن «لا أحد أكثر صمماً ممن لا يريد أن يسمع»، بل إن الصمم هنا يضاف إليه العمى أيضاً! إن أي واحد من كتبي، مثلاً، يجد من الصدى العالمي ما يفوق أكثر الكتب مبيعاً، اليوم، في باريس. في حين أن الأهمية أو القيمة أو بشكل أعم التأثير الأدبي الذي يفترضه هؤلاء النقاد في الأعمال الأدبية الأوروبية والغربية لا تستند، في أغلب الأحيان، سوى إلى الموقف المسبق الذي يفترض تفوّق الحضارة الغربية التي أفرزت تلك الاعمال».
ويضيف أنّ «من يعتمدون مثل هذه المقاربات لدراسة أعمالنا ما زالون أسرى لمواقف وأفكار نمطية متجذرة بعمق في مخيلاتهم، وبشكل أعم في «العقول المدبرة» للأوساط الأدبية التي ينتمون اليها، ما يجعلهم يقاربون أعمالنا الأدبية وفق سلم من القيم المغلوطة، التي عفا عنها الزمن. وهنا يجدر التذكير بالأحكام القيمية المسبقة، التي لا تمت بصلة الى الأدب، والتي ما زالت متجذرة بقوة، مهما قيل العكس، في «الكائن الثقافي» الغربي الذي يعمل هؤلاء النقاد على إقناعه بضرورة اعتماد تراتبية في قياس قيمة أو تأثير الأعمال الأدبية وفقاً للأصول التي يتحدّر منها كُتابها».
ويمضي محمد ديب بعيداً في خلخلة يقينيات النقاد (والقراء) الغربيين، بخصوص التفوق الحضاري والأدبي المفترض للغرب، قائلاً: «هناك مصدر آخر للخطأ (في المقاربة الفرنسية للأدب المغاربي) يتمثل في الافتراض المسبق بأن مقياس الحكم على قيمة أي عمل مكتوب بالفرنسية هو مقارنته بالأدب الفرنسي، في حين أن هوة سحيقة تفصل بين أعمالنا وأعمال المؤلفين الفرنسيين. فالنقاد الغربيون يصرّون على تجاهل نقطة اختلاف جوهرية في الدلالة العامة لأعمالنا ووظيفتها، مقارنة بالأعمال الأدبية الغربية: بشكل عام، لم يعد الغرب ينتج سوى أعمال استهلاكية أو بعبارة أخرى أعمال تقتصر دلالتها ووظيفتها في السعي بشكل عمدي للتأقلم مع رغبات القرّاء في لحظة أو في مكان محدّدين. ويرجع ذلك إلى كون الفلسفة الاستهلاكية قد أصبحت المرجعية القيمية للمجتمعات الغربية. أما نحن، وبحكم افتقادنا لمثل هذا الإطار، فإن أعمالنا أكثر تحرراً من تلك القيود التي تلقي بثقلها على الكُتاب الغربيين. بالتالي، فإن أعمالنا أكثر أهلية لأن تكون أعمالاً منطلقة وتأملية صرفاً، لأنها غير مطالبة بأن ترضي زبوناً معيناً في لحظة وفي مكان محدّدين».
قد يتساءل القارئ لماذا بقي هذا النص مجهولاً طوال سنين؟ لماذا لم يُنشر في حياة الكتاب؟ في أي ظرف أو مناسبة تمت كتابته؟ ولماذا أحجم محمد ديب عن نشره؟ أسئلة تبقى عالقة، لأن أي تفاصيل إضافية لم تُكشف عن هذا النص من قبل أرملة الكاتب، ولا من قبل المجلة الإسبانية التي نشرته.
الشيء الوحيد المؤكد أن محمد ديب لم يحجم عن نشر هذا النص من باب مهادنة الإستبلشمنت الثقافي الفرنسي. فقد سبق لصاحب «الحريق» أن عبّر، عام 1993، عن موقف راديكالي ضد استمرار الأجيال الجديدة من الأدباء المغاربيين في الكتابة باللغة الفرنسية. في مقالة مدوية نشرها آنذاك في صحيفة «ريبتور» (قطيعة) الجزائرية (**)، التي كان يديرها الأديب الشهيد الطاهر جاعوت (اغتالته أيدي الإسلاميين الغادرة في أيار/ مايو 1993 في الجزائر العاصمة)، واجه محمد ديب الأجيال الجديدة من الأدباء المغاربيين بمجموعة من الأسئلة الحارقة: «هل من اللائق أن يستمر الواحد منا في بيع حميمية بلاده الدافئة إلى المخيلة الغربية الباردة لفرنسا، التي ما زالت تصنّف الكُتاب المغاربيين في مكانة أقل من مكانة الخادمات البرتغاليات؟ هل يمكن للإنسان أن يكون متلائماً مع ذاته وهو يكتب بلغة الغير؟ كيف له أن يستكين لذلك، وهو يعرف أن لغته تمتلك قدرات حضارية وتعبيرية عالية؟ هل يمكن للكاتب أن يبدع وأن يكون حراً ضمن جهاز لغوي أجنبي؟ وماذا يحدث للمرء، ثقافياً ووجدانياً، حين يفقد أي صلة بلغته الأم؟»
رداً على تلك التساؤلات، كتب محمد ديب: «إن اللغة ليست مجرد أداة اتصال باردة، بل هي أيضا دفء وانتماء رمزيان. لذا، فكل كلمة تكتبها بلغة الغير أشبه برصاصة تطلقها على نفسك وعلى قيمك وهويتك، إذ ما معنى وما جدوى العالمية إذا كنّا بلا جذور؟».
وختم صاحب «الجري على الضفة المتوحشة» تلك المقالة بخلاصة بالغة المرارة عن «وحشة الاغتراب الثقافي» التي عانى منها طوال حياته، قائلاً: «بعد أكثر من نصف قرن من الإبداع بلغة الغير، ألتفتُ الى تجربتي فأجد، بكل حسرة، أنها كانت بلا جدوى. لقد بقيتُ دوماً أعيش غربة المقصي ووحشة الغريب، وأشعر أنني أعسكر وحيداً في الحقل الأجرد للغة ليست لغتي، تائهاً أركض خلف وهم التجذر في فضاءات ومدن بقية مغلقة بوجهي الى الأبد، فظللت كالغجري أعيش بمحاذاة أبوابها الموصدة، وأهلها يخافون ويحترسون مني، خشية أن أسرق دجاجهم»!
(*) مجلة Hesperia، العدد 19، منشورات Ibersaf Editores، مدريد، يونيو 2015.
(**) صحيفة Ruptures، العدد 20، الجزائر، مايو 1993.


