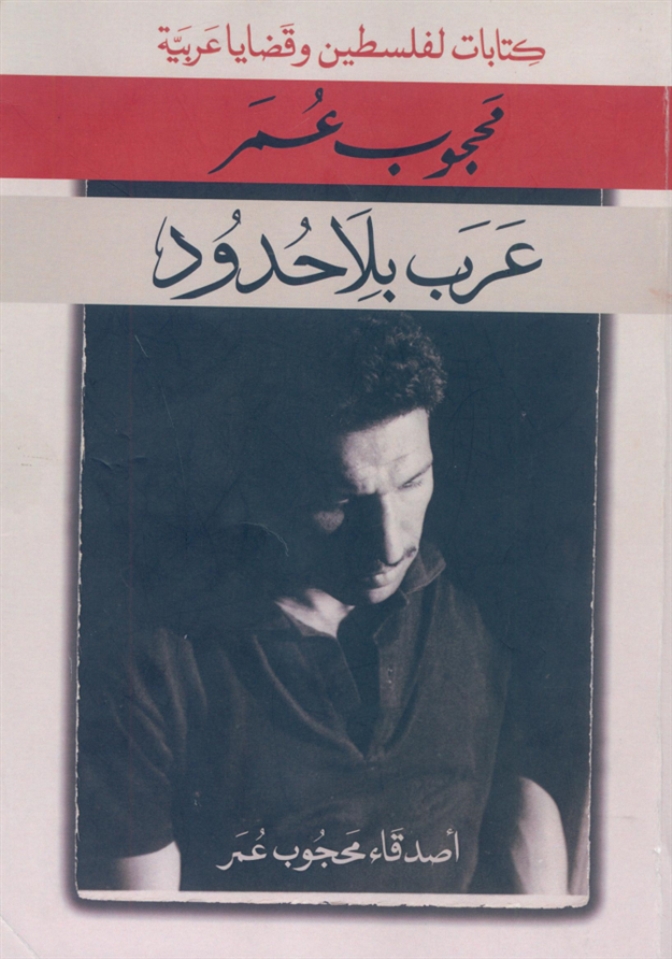
«الحكيم» الذي عاش مرتحلاً بين ميادين الاقتتال والاشتباك بدءاً بمصر والجزائر، وصولاً إلى الأردن ولبنان، تمكّن من تكديس رصيد هائل من الزخم المعرفيّ والميدانيّ، ما أتاح لإسهاماته أن تكون أكثر عمقاً وخصوبةً وإدراكاً للتحولات في العالم العربي، ولسيرورة النضال الفلسطينيّ وأدواته على وجه التحديد. حقيقةٌ تبدو جلية في معظم المخطوطات التي يحتويها كتاب «عرب بلا حدود»، وإن كان منها ما يستدعي السجال أحياناً.
ولما كان «خدام اللطافة»ـــ لقب يروق لمحبي محجوب مناداته به نظراً لشدة تواضعه ـــ شاهداً على أبرز الأحداث المصيرية التي هزت الوطن العربي، كالحرب الأهلية اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982 واستيطان الـ48، وحرب أكتوبر والانتفاضة الفلسطينية وحربيْ الخليج، ومعايناً بارعاً لكثير من التشققات والشروخ التي عصفت بالعديد من المنظمات الثورية والائتلافات الدولية حتى آلت بها إلى دوامة التقهقر والاندثار، فإنه أجاد تقديم معالجةٍ استكشافية شاملة لمجمل هذه الوقائع والأزمات فور حدوثها، صائغاً بذلك معجماً تأريخياً مصغراً لتركة هذا الماضي، واستشرافياً للمستقبل في الآن نفسه.
لم تكن بيروت التي قصدها بعد خوضه لمحنة أيلول الأسود في الأردن عام 1970، محطةً اعتيادية في حياة مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وإذ إن شهادة عمر للغزو الصهيوني الذي امتد حتى مشارف العاصمة اللبنانية وما رافقه من استهجان عربي مشروط كانت قد وردت في كتابه «الناس والحصار» عام 1983 (دار العربي للنشر- القاهرة)، إلا أنها أيضاً تحضر في النصوص التي ضمّها كتابه الجديد، كأنموذج فاقع على حالة الهبوط القومي العربي إزاء كل الأزمات السياسية الملحة، بما فيها القضية الفلسطينية «المشتركة».
في مجموعته الأرشيفية المكثفة، ينحو الكاتب إلى المقاربات المنهجية، المذيلة بالاقتراحات والتوصيات التي تنوّه بضرورة الالتحام العربي والالتفاف نحو الواقع الفلسطيني ورأب صدوعه. يأتي ذلك سعياً منه إلى تكريس نزعته القومية العروبية المناهضة لـ «الانعزاليات الإقليمية والاستقلالية التنظيمية». رؤيةٌ تناقض تجربة المفكر الأممية الوجيزة، لكنها تآلفها في بعدها الطبقي والشعبويّ: «وهل يمكن إحداث تقدم اجتماعي جوهري قبل التحرير والوحدة؟ هل يمكن إلغاء الاستغلال الرأسمالي في وطن محتلّ؟» (1977_«قضايا تنظيمية في الطريق إلى الوحدة» العدد 67 من مجلة «شؤون فلسطينية»).
لاحقاً، يلج صاحب «حوار في البنادق» (1975_ دار الطليعة) إلى غياهب الهيكل المؤسسيّ الإسرائيليّ، متقفياً أثر التغيرات الداخلية الطارئة على المجتمع اليهوديّ، والصدامات الفكرية الناشئة عن اقتحام السيل الليبرالي الغربي للمحيط اليميني المتطرف الطاغي على أنساق الكيان الاستيطانيّ الاجتماعية والثقافية. ينشغل بعدها في رصد تجربة نتنياهو في الحكم (1997)، ونقد دعاويه الإجلائية القائمة على «الترانسفير» والإبعاد القسرييْن للفلسطينيين القابعين بين أسوار الاحتلال.
وفي حين ترتطم قراءات الكاتب والشاعر المصريّ للراهن الفلسطيني ومآله بشيء من الطوباوية في بعض الأحيان، كمقترحه باتحاد الأقطار العربية، وهو موقف إيجابي تعلله المناخات الأيديولوجية المهيمنة في تلك الحقبة وحيثياتها، إلا أنها لا تحيد عن الواقعية الشديدة في أحيان أخرى. ولعل إسهابه في توكيد أهمية «الخطوة الجريئة» التي أقدم عليها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ19، وتقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة، هي المثال الأنصع على ذلك: «إعلان الاستقلال الذي يراه البعض منقوصاً لأنه لا يشمل كل الوطن الفلسطيني الآن، يعد خطوة عملية في الهجوم على العدو الصهيوني وشق صفوفه» (1990 ــ «مسيرة الاستقلال الوطني»، العدد 205 من مجلة «شؤون فلسطينية»). إضافة إلى مواقفه المحابية لمعهادتيْ أوسلو 1 و2 واتفاق غزة- أريحا، بحجة أن «الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو اختراق تاريخي في مجرى الصراع العربي- الإسرائيليّ» (1993 ــ «اتفاق غزة-أريحا وتغير الاستراتيجية الإسرائيلية»، العدد 23 من مجلة «شؤون الأوسط»).
عاش مرتحلاً بين ميادين الاشتباك بدءاً بمصر والجزائر، وصولاً إلى الأردن ولبنان
على الرغم من انحيازه المطلق لتجارب منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» في مقارعة الاحتلال، بكل ما تكتمه هذه الأخيرة من تعرجات وثلوم، إلا أن «راهب الثورة» لا يستثني الدور الرئيس الذي لعبته الفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى كحركة «حماس»، وغير الفلسطينية كـ «حزب الله» في إرهاق العدو الصهيونيّ ميدانياً وإرهاص مطامعه المتطاولة. وفي إحدى أحدث دراساته التحليلية، يعرّج عمر على عدوان «عناقيد الغضب» الذي شنّته إسرائيل على لبنان في نيسان (أبريل) 1996، مشرّحاً ما أحاطه من معطيات وأهداف استراتيجية تقضي باقتياد لبنان وسوريا إلى حالة من التزعزع والفوضى، وإضعاف «دور إيران المتنامي في الساحة الشرق أوسطية». إلا أنه لا يلبث أن يخلص إلى الإخفاق الذي منيت به تلك المحاولات بعدما فشلت في «عزل حزب الله» في الساحة اللبنانية، وإفقاده الدعم الجماهيري العربي، باعتباره أبرز قوة مقاومة عسكرية حالياً لإسرائيل» (1996 ـ «الحرب الإسرائيلية ضد لبنان» ــ العدد 51 من مجلة «شؤون الشرق الأوسط»).
ولعلّ وثيقةّ أرشيفية غزيرة كهذه، بكل ما تكتنزه من نضج وحدس معرفيّ ثاقب، ستدفع قارئها إلى التساؤل حتماً عن طبيعة الآراء التي كان سيدلي بها ابن فلسطين ونصيرها الصلد لو أنه شهد على كارثة القرن التاريخية التي أدت إلى استلاب كامل القدس على مرأى من العالم أجمع، في زمن الورع الترامبيّ!


