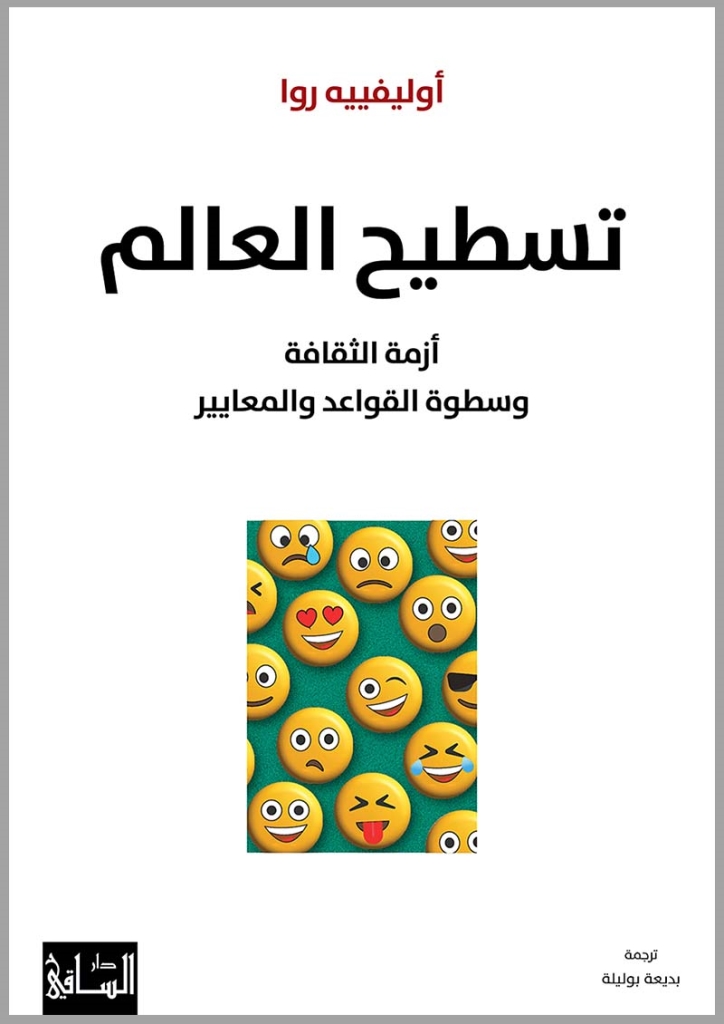
يُميّز روا بين نوعين من الثقافة: الثقافة الإنسانية كاللغة والدين وطريقة التعبير والقيم الأخلاقية، وهي مشتركة بين أفراد المجتمع، والثقافة الراقية التي تمثّل أفضل إنتاجات المجتمع من كتب وروايات وفنون ومتاحف ومناهج تُدرّس في الجامعات. الكارثة اليوم أنّنا نشهد تغييباً للثقافة الراقية وانتشار ثقافة شعبويّة تقوم على النسخ والتقليد لأهداف تجارية بحت. يلجأ مروّجو هذه الثقافة إلى اختيار منتج ثقافي ناجح في مجتمع معين ونسخه وتسويقه، من دون الأخذ في الحسبان ثقافة الشعب المُتلقّي. هذا ما يسمّيه روا «تسطيح العالم». والأمثلة كثيرة تشمل الأفلام والمسلسلات والطعام والثياب والسجائر وانتشار اللغة الإنكليزية المعولمة ورسوم المانغا اليابانية.
يُحدّد المؤلف أربعة أسباب رئيسة لتسطيح العالم هي: النيوليبرالية المعولمة، إزالة الحدود بين الدول، تنامي النزعة الفردية، والتكنولوجيا الجديدة، وخصوصاً الإنترنت. يؤكّد أنّ تسطيح العالم بدأ في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، جزئياً كاستجابة للثورات الشبابية في أوروبا والولايات المتحدة والثورة الصينية الثقافية، إضافة إلى أزمة الأيديولوجيات الكبرى التي فشلت في تحقيق سعادة الإنسان. يؤكد الكاتب أنّنا لا نعيش اليوم فترة انتقال ثقافي فقط، بل أيضاً أزمة تطال مفهوم الثقافة نفسه. يعبّر عن قلقه من التفكّك الثقافي الذي يعيشه العالم، وخصوصاً أنّ هذا التفكُّك لا تستتبعه إعادة تثقيف للمجتمع كما كان يحصل حين تندثر ثقافة محلية بسبب الاستعمار وتحلّ مكانها الثقافة المهيمنة. يستكشف الكاتب التغييرات الثقافية العميقة الناجمة عن الإنترنت والعولمة، مسلّطاً الضوء على المرجعية الذاتية للشبكة العنكبوتية، وتبسيطها المخيف للغات، وتذويبها الثقافات التقليدية لمصلحة ثقافات هجينة غير متصلة بالواقع. يُعطي روا مثالاً على ذلك الملفات الشخصية التي تُنشأ على مواقع التواصل، إذ تكون مُبسطة وخالية من العمق، وتقترب أحياناً من النماذج النمطية، إلى جانب التوافقات بين الأفراد التي تقترحها بعض تطبيقات المواعدة المبنيّة غالباً عن طريق الخوارزميات، ما لا يضمن أنها ستكون فعّالة في العالم الحقيقي. ينتقد روا تحوّل المجتمع المعاصر إلى العالم الافتراضي بشكل متزايد، إذ تحلُّ الشخصيات الوهمية والهولوغرامات مكان الإنسان، وتُستبدل التفاعلات البشرية بتفاعلات رقمية كالإيموجي والإيموتيكونز، ولهذا التجريد تأثيرات عميقة على فهمنا للواقع والإنسانية.
يثير الكاتب مسألة سطوة القواعد والمعايير في المجتمع الحديث. يُلاحظ أنّ المجتمع المعاصر يميل إلى تقليل التنوّع وتعقيدات السلوك البشري عبر فرض قواعد ومعايير صارمة تؤثر في جوانب مختلفة من حياتنا، كأساليب اللباس وقواعد السلوك الرقمي، وكيفية التصرُّف في المجتمع. من جهة يمكن رؤية سطوة القواعد والمعايير، كمحاولة للتحكم بالفرد وفرض رؤية مُعيّنة للخير والشر، ومن جهة أخرى، يمكن اعتبارها استجابة للتغيّرات المتزايدة في المجتمع، إذ تُوفر إطاراً ثابتاً يُمكن للأفراد الاحتكام إليه. مع ذلك، يمكن أن يؤدي الاستناد إلى المعايير، إلى تجانس السلوكيات وقمع التنوع والإبداع البشري. يُلاحظ الكاتب اختفاء الخصوصيّة في المجتمع الحديث. أصبح الجميع ينشرون حياتهم وقصصهم على مواقع التواصل، كما أصبحت جوانب عديدة من الحياة اليومية، مثل الجنس والعلاقات العاطفية، مجالات للتجارة والتربّح الماديّ. لذا نرى حالياً توجهاً إلى تنظيم الخصوصية بشكل متزايد وقوننتها، ما يعني أنه حتى حياة الأفراد الأكثر حميميّة أصبحت تخضع لمعايير وقواعد خارجية. يُلاحظ روا أيضاً التغيير في الخطاب بين الناس واختفاء التلميح لمصلحة التصريح، إذ إنّنا صرنا مضطرين لشرح كلّ أفعالنا وأقوالنا حتى لا يُساء فهمنا، فالفنّان يجب أن يُفسر لوحته للجمهور، والطبيب يجب أن يشرح الخطوات التي يقوم بها، حتى المطعم أصبح يُقدّم لائحة طعام مليئة بشروحات مسهبة حول كل طبق.
يعزو ذلك إلى النيوليبرالية المعولمة وتنامي النزعة الفردية
يطرح روا مسألة مركزية هي فقدان القيم الإنسانية كالحرية الفردية والمساواة واحترام التنوّع في عالم يزداد تشدّداً وترميزاً. يلاحظ أنّ جميع الفاعلين، سواء كانوا محافظين أو تقدميّين، علمانيين أو دينيين، نسويين أو ذكوريين، شعبويين أو نخبويين يسهمون في تفتيت الثقافة والهويّة. لقد تقلّص مفهوم الثقافة بسببهم إلى مجرد مجموعة من الرموز الخالية من المعنى بسبب التركيز المُفرط على أمور سطحيّة على حساب الفهم العميق للثقافات المختلفة. على سبيل المثال، غالباً ما تُختزل ثقافة مجموعة عرقية بطعامها أو ملابسها التقليدية، من دون مراعاة لمعتقداتها وقيمها وتاريخها. يتطرق روا أيضاً إلى غياب الموضوعية واختفاء التسامح والمرونة، وخصوصاً في عالم السياسة، إذ لم تعد هناك حقائق ثابتة، وأصبحت كل جماعة تتبنى حقائق بديلة وتعتبر أفكار الآخرين غير مقبولة.
يثير الكاتب أيضاً مسألة غياب القضايا الكبرى التي كانت تُحرّك المجتمع كله في القرن الماضي كالمطالبة بالعدالة الاجتماعية ومقاومة الهيمنة بسبب سيطرة النزعة الفردية. لقد أصبح المجتمع منقسماً إلى أقليّات وجماعات تعاني كلّ منها مشكلاتها الخاصة وتُطالب بحمايتها كالنسوية والجندريّة والمدافعين عن حقوق الحيوان... أمر أدّى إلى المزيد من التفتيت الثقافي. كما تطرق إلى مسائل الهويّة الجنسية التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة، إذ لم يعد جنس الإنسان مثلاً مُحدَّداً بيولوجياً عند الولادة، بل أصبح بناءً اجتماعياً، ما أسهم في تعميق أزمة الهويّة.
مع ذلك، يؤكد أوليفيه روا أن الثورة على كل هذه الخزعبلات والتفاهات ما زالت ممكنة. لذا يدعو إلى نسج روابط اجتماعية خارج المساحات المحمية وبعيداً ن جماعات الاهتمامات المتشابهة . يؤكّد أنه على الرغم من تحديّات التسطيح، هناك أشخاص يعملون على استعادة التواصل بالاستناد إلى ما يجمعهم بدلاً من التركيز على ما يُفرّقهم، مشيراً إلى أنّ إعادة تثقيف المجتمع يُمكن أن تبدأ عبر إعادة بناء رابط سياسي عميق بين أفراده كما فعل محتجو «السترات الصفر» في فرنسا، الذين تحرّكوا جماعياً للاعتراض على سياسات التهميش الحكومية.


