انبثقتْ فكرةُ الكتاب من دافعٍ خارجي حرّكَ ذهنَهُ للخوض في إشكاليةٍ تاريخيةٍ حاولَ بحثَها على أمل الوصول إلى حقيقتها الـمُلْتَبسة دينياً وتاريخياً. أرادَ أنْ يُظهِرَ أنّ مريمَ المجدلية، لم تكنْ مجرّدَ امرأةٍ عابرةٍ وإنما هي ذاتُ خطورةٍ في تاريخ المسيحية نتيجةً لقيامها بعملية مَسْح يسوع وقُربها منه وتفضيله لها على سائر الحواريين وإصرارِها على حضور عملية الصَّلْب ومن ثم زيارتها لقبره وتبليغِها الحواريين نبأَ الصعود في الحكاية التي يذكرها انجيل مرقس. ويبدو أنّ علي الشوك أراد أنْ يُبْرِزَ دورَ مريم المجدلية في استمرارِ الرسالة ومواصلةِ حيويةِ الفكرةِ بعنادٍ يكشف عن قوتها الكاريزمية؛ فكرةِ الخلاص أو التحرّر من عبودية الطغاة من الرومان واليهود على حدّ سواء... لتتجلى في النهاية، عظمةُ هذه المهمة التي ينهضُ بها طرفان قد يبدوان متناقضَيْن: أحدُهما نبيٌّ هو المسيح، والطرف الآخر بغيّ سكنت الشياطينُ جسدَها فطهّرَها المسيحُ، صاحب المعجزات، من هذه الشياطين. لكنّهُ بطبيعة الحال لم يستطعْ أنْ يُنقذَ نفسَهُ من غواية جمالها الجسديّ الآسر، فوقعَ في غرامها ومارس الحب معها طبقاً لمصادر مهمّشةٍ وغير رسميةٍ، كالأناجيل الغنوصية والهرطوقية المسماة بالأبوكريفية التي استلهمَ منها كازانتزاكس روايتَه «الإغواء الأخير للمسيح». واستلهمَ منه المخرج مارتن سكورسيزي رؤيته لفيلمه الذي حمل عنوان الرواية ذاته.
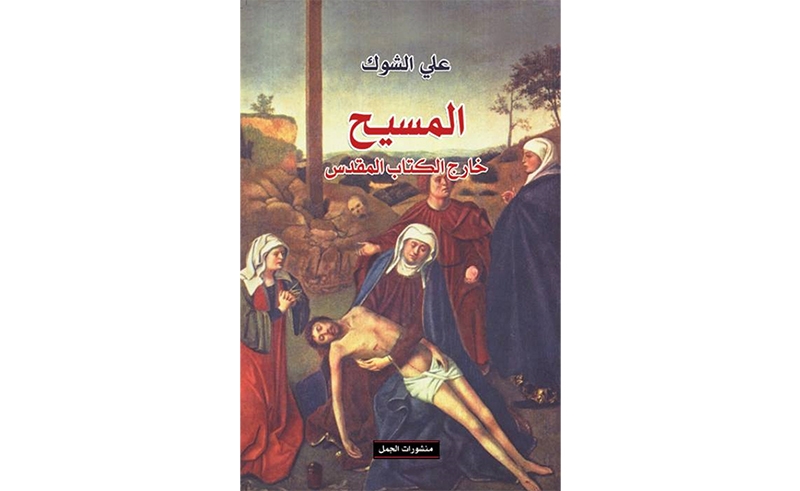
اعتمدَ علي الشوك على هذه الكتب مصادرَ لفكرته عن المسيح والمجدلية والمعمدان والملابسات التي رافقت مسيرتَهم، فهو يصوغ فكرتَهُ على النحو الآتي: إذا رجعْنا إلى الكتابات الهرطقية، سنجدُ أنّ المسيحَ والمجدليةَ كانا شريكَيْ حياةٍ جنسيةٍ وليس كزوجٍ وزوجة. وفيلم «الإغواءُ الأخير» أحدثَ هزّةً نفسيةً لعلي الشوك، يعرفُ أسبابَها من قرأَ سيرته «الكتابة والحياة»، لا سيما علاقاته بالنساء اللواتي عرفهنّ في العراق وخارجه، وبالتالي موقفه من المرأة، فحفّزَهُ ذلك على الخوض في تاريخ المجدلية والمرويات المتعلّقة بها ومراجعة تاريخ المسيح والمسيحية. فالذي يعرفُ علي الشوك ويعرف طريقته في الكتابة، سيعرف حتماً سرّ اهتمامه بهذا الموضوع. مع ذلك، هو يُعطينا سبباً نفسياً لتأليف هذا الكتاب، فيقول: «وأنا أصلاً لم أجدْني مؤهّلاً للكتابة عن هذا الموضوع بعدما أصبحتُ عاجزاً تقريباً عن الكتابة، بحُكم تقدّم سِنّي وتردّي ذاكرتي. أنا كنتُ أريدُ أنْ أُلهّي نفسي في الأيام القليلة المتبقية من عمري بشيء يدفعُ عني كآبةَ الشيخوخة أو يُخفّفُها، ففكرتُ بالكتابة عن مريم المجدلية». إنّ هدفَ علي الشوك من الكتابة عن هذا الموضوع، أنه لا يريدُ أنْ يضعَ نفسَه موضع الخوض في تفاصيل الإشكالية التاريخية الملتبسة حَوْل هوية المسيح وقضية ألوهيته الشائكة منذ أن أنكرها آريوس، ومسألة زواجه من عدمها، وعلاقته بالمعمدان وسالومي والمجدلية وأخت لعازر ومسألة أصل المسيح وأصل يوحنا، والمسيحية وعلاقتها بالإمبراطورية الرومانية وباليهودية وبالحكام اليهود وسوى ذلك من تفاصيل جرى بحثُها تفصيلياً من قبل مختصين في تاريخ الأديان والحضارات.

لكنه أرادَ أنْ يُبلورَ رأياً يهمُّه شخصياً، ويتوافق مع تكوينه الثقافي، وهو القبض على المثال والأنموذج الأول تاريخياً للمرأة صاحبة الإرادة، يقول: «من كلّ ما تقدّم، نحن نرجّح أنها (أيْ: مريم المجدلية) كائن حقيقي. وليس أسطورياً»، ليُبرزَ مشاركةَ الأنثى في الأحداث المصيرية في التاريخ، ودورَها في الكفاح من أجل الحرية ومن أجل الفكرة المقدّسة، فكرة تحرير الإنسان من العبودية. يجعلنا هذا، أمام خلاصات ذات دلالة كبيرة بالنسبة له وهي: رجاحةُ عقل الأنثى التي مُنِحَت الحقَّ بتلقي الرؤى لأنها تتمتعُ بإدراكٍ أكبر مما عند بطرس، ودورها في التحرر، وقدرتها على حَمل الرسالة؛ رسالة تبليغ صعود المسيح وعدم موته كفكرة خالدة. وقدرتها على الغواية كجزء من هويتها في الكفاح من أجل الحرية والسعادة؛ الحرية من عبودية الجسد، والسعادة بتحقيق رضا النفس، وقدرتها على المواجهة عندما واصلت الرسالةَ بعد صَلْب المسيح، وقدرتها على القيادة بوصفها رئيسة مجموعة الحواريين استناداً إلى إنجيل مريم الذي يستقي منه علي الشوك فكرته. فهي تحثّهم على أن لا يتراجعوا عن مهمتهم لأنّ روحَ المسيح ما زالت معهم. هو يرى أنَّ المسيحيةَ مَدينة لمريم المجدلية باجتراح فكرة البعث، بَعْث المسيح من قبره بعد موته، وصعوده إلى السماء. لذلك، يحاول توجيهَ نقده للكنيسة من خلال طريقة تعاملها وتقييمها لمريم المجدلية. على الرغم من أنها أولُ من اصطفاها المسيحُ لتُعلنَ نبأَ صعوده إلى السماء بعد موته، إلا أنه جرى تهميشها من قِبل الكنيسة والأناجيل الرسمية.
إنّ إعادةَ قراءة التاريخ، تحظى بأهميةٍ خاصة لأنّ لها أبعدَ الأثر في البحث عن تفسير موضوعي وعقلي للتاريخ.

وعلى الرغم من أنّ التاريخَ الديني يرفض هذا النوع من التفسير، إلا أنَّ ذلك لا يجب أن يكون عائقاً أمام كشف الحقائق وزَيف بعضها. ضمن هذا المساق، جاءت قراءة علي الشوك لتاريخٍ مُلْتبس، هو التاريخ الديني، وبالذات في حيّزٍ محظورٍ ومسكوتٍ عنه. وأعني بذلك، تاريخ مريم المجدلية وعلاقتها بالمسيح، ووجود المسيح نفسه وولادته وعلاقته باليهودية وبالسلطة الرومانية، وعلاقته بيوحنا المعمدان. مع ذلك، فإنّ هذه القضيةَ ليست جديدةً على البحث التاريخيّ المعمَّق في «تاريخية» المسيح، وتاريخية المجدلية. ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، تركَ هرمان ريماس أستاذ اللغات الشرقية في جامعة هامبورغ، مخطوطاً ضخماً بحوالَى 1400 صفحة نُشِر لاحقاً عن حياة المسيح لم يجرؤ على نَشْره في حياته، يقولُ فيه: «إنّ يسوعَ لا يُمْكنُ أنْ يُعدَّ مؤسسَ المسيحية أو أنْ يُفْهمَ هذا الفهم، بل يجب أنْ يُفْهمَ على أنه الشخصيةُ النهائيةُ الرئيسيةُ في جماعة المتصوّفة القائلين بالبعث والحساب»، ومعنى هذا أنّ المسيح لم يُفكّرْ في إيجاد دينٍ جديدٍ، بل كان يفكرُ في تهيئة الناس لاستقبال دمار العالَم المرتَقَب، وليوم الحشْر الذي يُحاسِبُ فيه اللهُ الأرواحَ على ما قدَّمَتْ من خيرٍ أو شرّ. وبعض المؤرخين مثل ديڤد شتراوس في كتابه عن حياة المسيح اعتبرَ أنّ ما في الإنجيل من خوارق الطبيعة ينبغي أن يُعدَّ من الأساطير الخرافية. ودعا إلى إعادة كتابة حياة المسيح الحقيقية بعد حْذف هذه العناصر منها.
جرى تهميشها من قبل الكنيسة والأناجيل الرسمية
قصةُ علاقة مريم العذراء بالجندي الروماني التي يثقُ الشوك بروايتها في كتابته التي سبق أن اعتبرَها ضرباً من ضروب العلاج النفسي، فإنّ مؤرّخاً مختصّاً بتاريخ الحضارات هو ديورانت يرى أنها بعد تدقيقها وبإجماع عدد من المؤرخين النقاد مجرّد «افتراء سخيف». لكن الشوك يُعزّزُ تصديقَه لهذه الحكاية من خلال بعض الوثائق التي أُخِذَتْ من مصادر مهمّشة في الغالب على نحو ما أسلفنا. وكذلك مسألةُ الـمَسْح من قبل المجدلية ينفيها سفر إشعيا. ففي لوقا ٤/١٨ أنّ المسيحَ أتى إلى الناصرة، حيثُ كان قد نشأَ. ودخلَ إلى الـمَجمَع حَسَبَ عادته يومَ السبت، ووقفَ ليقرأَ. فأُعْطيَ دَرْجَ النبي إشعيا، ففتحَ الدَّرْجَ ووجدَ المكانَ المكتوبَ فيه: «روحُ يَهْوَه عليَّ، لأنه مسحَني لأُبشّرَ الفقراءَ، أرسلَني لأُكرّرَ للمأسورينَ بالعِتْق وللعُميان بِرَدِّ البصر، لأصرفَ المسحوقينَ أحراراً».
* ناقد وأكاديمي عراقي مقيم في السويد ــ آخر أعماله «الهيمنة الرمزية ـــ تفكيك الأنساق الإيديولوجية للخطاب»، و«اللغة المقنّعة ـــ المواجهات الرمزية بين النص والسلطة».



