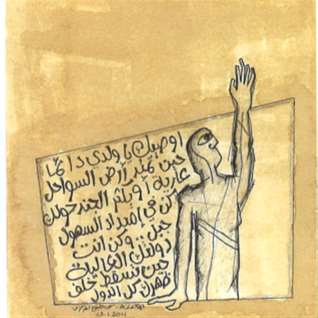(دينا مطر)
وهذه الكلاب والقطط المتطايرة حولي... أهي الكلاب والقطط التي كنّا نعرفها وتعرفنا، يا لها... ما بالها الآن تطير خائفةً، وتمرّ حذرةً، وتقف لاهثةً، وعيونها مثل جمر راح يومض وسط رماد كثيف. لماذا هي ليست هي، وقد عاشت هادئة أمام البيوت وقربها، وفي الحواكير، وبين براميل الماء، والمازوت، وبين أيدي أولادنا. لماذا هي الآن هلوعة نافرة، وعمّ تبحث في ركضها المجنون هذا؟
والحمام، أين هو حمامك أيها المخيّم، أين هو تلويح العصي فوق البيوت، فوق الأسطحة، وأين هو الصفير، وأين الغناء، وأين المباهاة بالرفوف التي تصير قبل غروب الشمس سقوفاً من حمامٍ لسماء المخيّم؟
وأين هي المناداة التي تلفّ المخيّم من السكة شرقاً إلى بيوت الشيخ رضوان غرباً، وأهلها ينادون على العرانيس المشوية والمسلوقة، وعلى أسياخ لحم المصارين والفشافش، وأقراص الفلافل، وغزل البنات، وأكياس البطاطا المرقوقة، والزلابية، والمشبك والعوامة، وتفاح العنبر؟ أين هم الأطفال، أين هي ثيابهم الملوّنة، أين هو صخبهم وجريانهم مثل السواقي بين البيوت، وأين هي ألعابهم، أين هو طيشهم الألوف. وأين هو علوبة مجنون المخيّم وملحه، أين هي مطارداته، وأين هو قصبه الذي جعله خيولاً رامحات؟
أين هي بساطة الحياة حين يعيش المرء مثل عيشة علوبة، إن جاع دقّ أقرب باب إليه من أبواب بيوت المخيّم كي يأخذ رغيفاً مدهوناً بالزيت والزعتر، أو رغيفاً محشواً باللبن الجميد، وإن عطش دقّ الأبواب، ومدّ كأسه البلاستيكية لكي تُملأ فيشرب هو وثوبه وقلائده الملوّنة التي تطوّق عنقه وتخشّ.
أين أنت يا علوبة، أتستحم، وفي أيّ بيت وقع الدور عليه اليوم، إن كنت تستحم، أين هو صوتك العالي الرّاجف المدوّي الخائف من الماء، والصابون؟ وإن كنت نائماً لائذاً بشجرة أو ظلّ حائط، أين هو شخيرك الذي يحرس نومك، آااخ يا علوبة، أظنّ أنك خرجت أيضاً، خُطاك تبعت الخُطى، وخوفك لحق بخوفهم عندما هبطت قنابل الطائرات الـ «F16» و«الكواد كانتر»، فغطّت بيوت المخيّم. خرجت عندما دخلت إلى المخيّم حمم النيران المخيفة، والبلدوزرات ذات الأنياب الحديدية المسنّنة، والدبابات الصاعقة بأصواتها المزمجرة؛ علوبة... هل عدت إلى رشدك، هل عاد عقلك إليك، بعد أن سلبوك إياه جزءاً جزءاً في السجون التي مررت بها، السجون التي امتصّت عافيتك، وحيّدت أمانيك الغاليات، فهويت بأحلامك من الدراسة في لندن، أو أمستردام، أو لاهاي، أو هافانا، أو موسكو، إلى أن صرت تطلب أمناً في عريشتك، أو في الشارع، أو داخل المقهى. وأين هي الشموع التي عشقتها، يا علوبة، بعد أن تعلمت صنعها في قوالب في مدرسة المهن اليدوية في القدس، أين هي قولتك التي مشت في المخيّم مشي العطر في الهواء: امشوا وراء الشموع تدلكم على النور. أين هي الآن دكانك الصغير الذي تعلوه لافتة مكتوب عليها، شموع علوبة وسط هذا الركام؟ وأين هي زينب ابنة أخيك حلم حياتك ورجاؤك من الدنيا؟ وأين هي وقيدة الشمع الذي حملته إلى باحة مدرسة الفاخورة، كي تحتفل بنجاح زينب التي ستصير ممرضة في مستوصف المخيّم بمريول أبيض؟
وأين هي عربة المتولي الكارو، والكديش، والسرج المقصب، واللجام، وعصا الخيزران، وأين هو المتولي المتباهي بها كما لو أنها يخت بحري بألف غرفة وغرفة؟ أين هي قرقعة دواليبها، وأين هو صرير بوابة البايكة التي يبيت بها الكديش؟
وأين هي كوارة التبن الطينية، والأكياس، وران الخشب المملوء بالماء، ومذود العلف، وطيور الدجاج والبط وديوك الحبش، أين هي طلاقيات الأرانب الطينية؟
أين هي مملكة المتولي، وأين هي طلته العفية، وقد حنّى شعره الأشيب، وطوّل شاربيه، ولبس الخواتم الكبيرة بأحجارها الملوّنة، وأين هي سترته العسكرية الكفاردين بأزرارها الذهبية، وسرواله المنفوخ عند الفخذين، وأين هي جزمته العسلية الطويلة التي ادّعى بأنها جزمة نابليون بونابرت التي سها عنها، فتركها وراءه حين جاء إلى غزة غازياً، يوم سكن قصر الباشا؟ وأين هو طول المتولي الذي يشابه طول سروات خديج قرب ملعب جباليا الترابي. وأين هو صوته الضاج. وأين هي صباحاته التي تبدأ بحمد الله وشكره.. والقهوة. أين هو كرسيه الخيزراني الذي سمّاه أولاد المخيّم بكرسي الملك. وأين هي «الطربيزة» الصغيرة التي تحمل قهوته وصحن سيجارته وإبريق الماء وكأس الماء أمّ العنق الطويل وفيها وردة جوري كبيرة؟ وأين هي تينة البيت يا متولي، وأين هو محمد عبد المطلب المنادي بعلو صوته: «أحبك... وححبك على طول»؟
وأين هم الباعة الجوالون المنادون على «روبابيكيا».
وأين هي روائح فطائر الزعتر التي تخبزها نوفا العبد (أم غزال)، التي تدفع منها بعشرات إلى صاجها، وتستعيدها عشرات، وكؤوس الشاي آتية من كولبة ابن المهدية عشرات فعشرات. أين هي ألوان الزعتر الفلسطيني، الخضير، والأخضر، والخضراوي، والزيتي، والذهبي، والقمري، والقرميدي، والعسلي، وأبو رهجة؟ وأين هي فطائر الجبنة المغموسة بالنعناع، والبقدونس، والحميضة، والهندباء، والزيتون، والزرنج، والبيسة، والرويحة، والزيت، والخرفناس، والفليفلة، والتيجانية، والهاوسة، والشومر، والحبّة السوداء؟ أين هي روائحها التي تصير في الفجر اسماً من أسماء المخيّم، وعلامةً دالة عليه؟
يا أَلله، حتماً لا يوجد مكان في الدنيا له جمال يشبه جمال هذا المكان في المخيّم، حين يصير صاج نوفا العبد (أم غزال) مكاناً ألوفاً للقاء العشاق في غبشة ليست هي بليل أو نهار، إنها برزخ للمناولات والنظرات واللهفات وسماع الأصوات والوشوشات والهمسات والتمتمات التي لا تصير كلاماً. هنا، نعم هنا... يتذوق العشّاق طعوم الصّباح الطالع، ومعنى أن يحلم العاشق بموافقة قريبة من معشوقته قبل أن يهلّ الضوء، وأن يحسّ بجمال أصابعها لمساً، وأن يرى برق نداوة عينيها كلما التفتت أو استدارت أو مالت، هنا اجتماع لعصافير... تطلب بهجة الدنيا! نوفا العبد (أم غزال) أيتها النعمة الإلهية... أين أنت؟
قطعاً، بل قطعاً باتاً، ما أنا الطبيب جواد، جرّاح العظام، وهذا الذي أراه... ليس مخيّم جباليا، فلا البيوت بيوته، ولا المدارس مدارسه، ولا الشوارع شوارعه، ولا الأزقة أزقته، وما فعلته يدُ الخراب وأبقته ليس مخيّماً أبداً.
أنا الآن هنا... كائن آخر، لست طبيباً، والمخيّم الآن هنا... ليس مخيّماً أيضاً، أنا هنا كائنُ الانتظار الذي ينتظرُ زوالَ هذا الغبش... كي يطلع النهار.