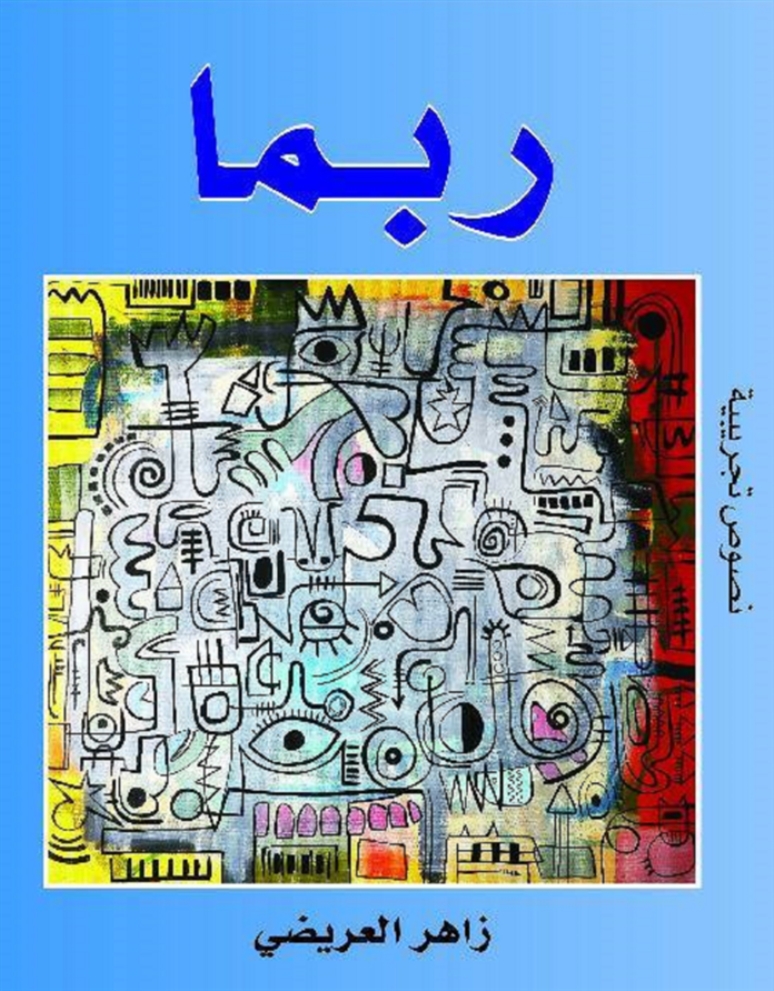
«ربما» (نصوص تجريبية ـ دار أبعاد ـ ٢٠١٨)، هكذا أراد زاهر العريضي لمجموعته أن تحمل عنواناً يأخذنا إلى تلك المنطقة الرمادية الملتبسة والمخاتلة التي هي من ديدن الشعر ذاته. نصوص العريضي في المجموعة الشعرية الرابعة بعد «رحيل في جسد» (٢٠٠٨) و Offline (٢٠١٠) و «أنا الغريب هناك» (ـ٢٠١٤)، لا ترسو على شكل كتابي موحد، فقد تطالعنا في بداية المجموعة نصوص بمنتهى السيولة مثل: «الشاعر/ هو ذلك الأحمق/ الذي أعاد الذين سقطوا سهوا/ ليقولوا كلمتهم الأخيرة» أو «ماذا تفعل الشجرة/ حين تضجر من المكان؟/ هل تهجره/ أم تورق حزناً؟»، وكذلك «رجل الثلج/ يبتسم للشمس/ لتنقذه من الملل»، الى نصوص نثرية لا تنقصها الدهشة (تذكرني ايران بأميركا. طهران بواشنطن. لا أخرّف ولا أبتدع ذلك... حين كنت أنتقل بين الشوارع المواجِهة بالمصعد الكهربائي لا عبر الجسر، أسمع موسيقى بالأنحاء، عازف الكمان يجلس علي الجسر ويبتسم للعابرين وأمامه وعاء للنقود. كما في نيويورك وواشنطن، يتنقل العازفون بين محطات الميترو والأرصفة الضيقة. لكن عازفي الشوارع في أميركا لو شاهدوا كيف امتلأ وعاء عازف طهران بالنقود لجاؤوا إلى هنا).
يضمن العريضي مجموعته نصوصاً هي أقرب إلى القصة القصيرة مثل «ماذا يفعل شاب من بلاد ال بم بم في بانكوك» الذي يمتد على صفحات ستّ، ونصوصاً أخرى عن انطباعاته في مدن كثيرة كطهران ودبي ومسقط وغزة وباريس بلغة قد يخفت فيها الإيقاع الشعري والنثري لتحاكي الأمكنة من زاوية الانطباعات الشخصية وما هو أشبه بأدب الرحلة. مقابل الإسهاب، وبما يتيح له الشق الثاني من العنوان (نصوص تجريبية)، يضمن العريضي مجموعته أيضاً مجموعة من الشذرات هي أقرب لشعر الومضة أو شعر البيت الواحد: «أجمل ما في ذاكرتي أنها تنسى الأشياء السيئة»، «أخطر ما في المرآة حين تصبح قديمة»، «ماذا نقول للفراشات الحزينة؟ من هنا مر الغراب! وهذه الأرض مليئة بالضفادع؟».
عنوان يأخذنا إلى تلك المنطقة الرمادية التي هي من ديدن الشعر ذاته
يختم العريضي مجموعته بتضمينها مجموعة من البطاقات البريدية من غرناطة وهافانا وطوكيو ومرسيليا لا تخلو من المفارقات. على بطاقة هافانا نقرأ: «هافانا فاتنة ومغرية، إنها راقصة استعراض تتبرج كل صباح... إنها ستينية بشهوة عشرينية». كلما تخفف زاهر العريضي من ضغط اللغة اليومية للإعلام والصحافة (وهو المخرج والمنتج في قناة «الميادين»)، طالعتنا في مجموعته سحنة الشعر الذي لا يتطلب بنى تحتية أو أمكنة استثنائية أو تجهيزات لوجستية ضخمة، بل هو أقرب الى ذلك الصوت الخافت الذي يكفي ليستثير لدى كل منا هذا الشيء المنسي والمنكّس والمهمل: الدهشة، التي قد لا تكون بقدر دهشة الولد أمام البحر ولكن قد نكون إزاء دهشة حساسة من دون دليل ليست إلا ومضة داخل أنفسنا وأمام الكون: «نحن غبرة كونية يا صديقي/مشهد مؤقت سينتهي بعد قليل/ رغم ذلك/ يستفزني هدوؤك/ قل لي/كيف أتعلم أن أمسك الكواكب/ كما تمسك بتبغ سجائرك» أو «كأن المدينة ابتلعت بيار/ بعد حين يباغتك/ حاملاً إليك جريدة ويبتسم/ كأنه يقول لك/ متعة أن تحمل في يدك جريدة/ وتحتسي القهوة في باريس/ متعة الكنائس كصلاة خاشعة/ يهمس أحمد بقربي ونحن نعبر/ هل الله يساعد من لا يؤمن به؟/ ربما ومن يدري؟». قبل أن يكون نوعاً أدبياً، الشعر ابتداءً هو حالة وعي، ووضعية في الوجود وطريقة خاصة لمقاربة الواقع. كيفما أراد زاهر العريضي أن يطوع الشكل في خدمة المعنى وأن يعطي «النصوص التجريبية» مرونة الحرية التي تعفيها من المحاكمة الصارمة بمقاييس قصيدة النثر (التي قد لا توجد أصلاً)، فإن ما كتبه في «ربما» ينطبق عليه ما يقوله جورج بيروس، أحد أبرز شعراء فرنسا في القرن الماضي: «إن أجمل قصيدة في الكون لن تكون إلا انعكاساً شاحباً لما هو عليه الشعر: طريقة حياة، طريقة في أن نسكن العالم ويسكننا».


