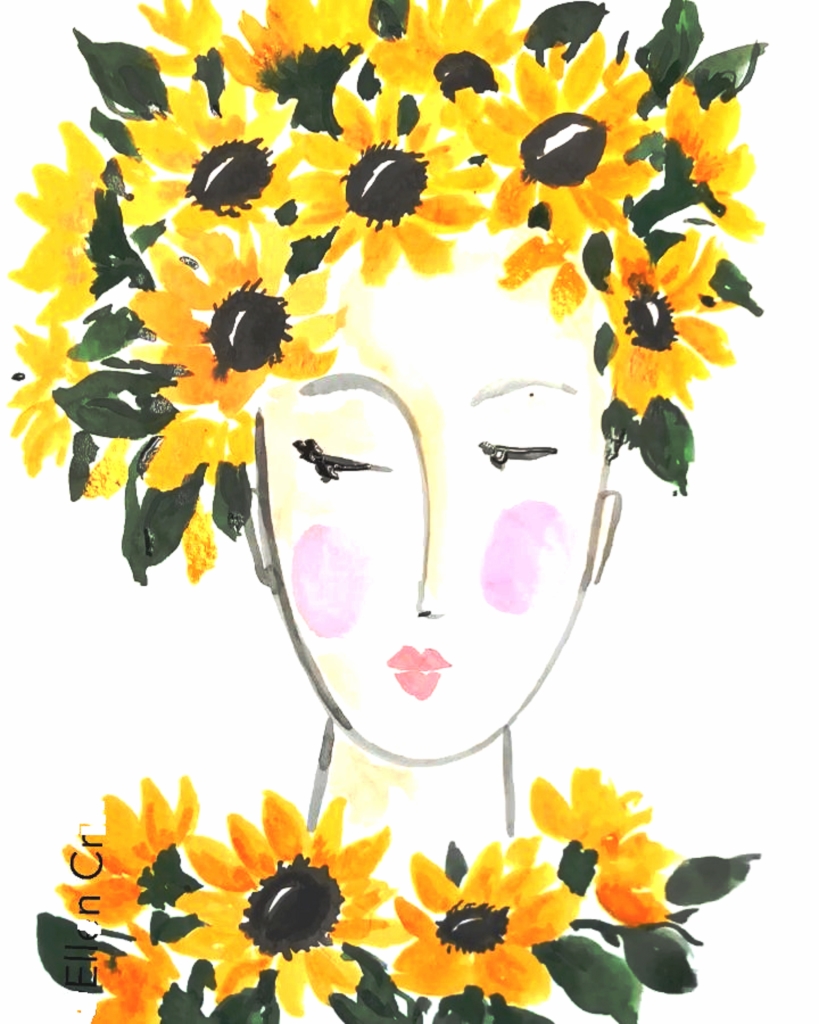
إلين كريمي تْرِنْتْ ـــ «شمسٌ حورية» (ألوان مائية على ورق ـــ 2019)
اسمي خالد الهلالي. ولدت يوم 5 نوفمبر 1975. في منتصف ذلك النهار، انتزعتني من رحم أمّي انتزاعاً مولّدة طيبة لكنها صمّاء. أتصور أنها لم تسمع زعيقي، مثلما لم تُصِبْ قبله شيئاً من صراخ زبونتها المتوجّعة. أقدّر أنها عاينت فَحَسبُ حركة فمي المهتاجة، فندّت عن وجهها ابتسامة رضا، قبل أن تسلّمني إلى أمي المتصببة عرقاً، كما يسلّم طرد بريدي نفيس.
بعد غروب شمس نفس اليوم، ظهر الحسن الثاني على شاشة التلفاز، ببذلته الصارمة الزرقاء، وألقى خطابه على أبي وأمي وإخوتي ووسط الكل أنا داخل مهدي الدفئ: «علينا أن نقوم كرجل واحد، بنظام وانتظام»…
لم يكنِ النظام ولا الانتظام يوماً سمتي المميّزة. يكفي إلقاء نظرة دائرية على زوايا مكتبي، أو، لمزيد من الاطمئنان، على حجرات بيتي في حي لقبيبات.
[اشترك في قناة «الأخبار» على يوتيوب]
بيتي! ماذا أقول عن بيتي؟ لقد خيّم عليه الهدوء فجأة، ومساحته زادت على نحو مخيف. أما الربيع، فابتهاجي به لم يُعمِّر.
نعتقد في البدء أن الطلاق والحرية وجهان لعملة واحدة. لكن سرعان ما نعي أن تلك العملة مثلها مثل وَرِق أصحاب الكهف والرقيم. حين نستيقظ أخيراً من سباتنا ونذهب كي نَصرف حريتنا في سوق الحياة المصطخب، لا نجد أيادي صديقة تناولنا ما نريد، بقدر ما نصادف نظراتٍ تحدجنا باستغراب لأن قطعنا المعدنية لم تعُد متداولة.
وجدت نفسي وحيداً مع حريتي الجديدة التي طالما تمنّيتها، لا أعرف ماذا أصنع ولا كيف أتصرف. حننت إلى جاهليتي الأولى. جربت أن أخرج لمعانقة ليل المدينة المغري. فوجئت بكل شيء يبدو غريباً غير مأنوس. البارات لم تعد بارات، المراقص لم تعد مراقص، بحثت عن ساقياتي الطيّبات فلم أجدهن، بحثت عن عمّ بلال، كان يشرب دوماً لوحده في الزاوية، اشتقت لابتسامته، كان يوزّعها بالتساوي من مكانه على الكل. أتراه مات؟ أم أنّ مرضاً مزمناً أقعده في عقر داره؟ شيئاً فشيئاً، تسلل إحساس بالوحشة إلى صدري، مضيت أتنقل كالتائه وسط أضواء بدّلتْ من طيفها، حتى ضوضاء الأمكنة تغيّر فيها شيء، كأن نبرات دخيلة اخترقتها، كل معالم المدينة تلاشت، الموضة تحوّلت، موضة اللباس والمشي والجلوس، موضة الشرب والرقص والابتسام والتثاؤب والكلام، كان في جعبتي في ما مضى عبارات غزل ومراودة أشهرها عند اللّزوم بنوع من التوفيق، اليوم بدا كل ذلك كلغة ميتة، ولم يعد للأسف يثمر عن شيء يذكر.
ليل المدينة كان مغرياً بحق، لكني اكتشفت في المحصلة أني لهثت وراءه بلا طائل. حريتي جهاز إلكتروني متطور ضيّعتُ دليل استعماله، فصار يعبث بأعصابي. سحقاً! إذا استمر معي على هذه الحال، سوف أضرب به عُرض الحائط وأستريح.
قلت في نفسي: الحرية تتطلب ممارسة يومية. هي لا تشبه ركوب دراجة هوائية مثلاً. فالواحد منّا يتدرب على قيادة الدراجة مرة واحدة في العمر، وحين يعود إليها، ولو بعد سنين، فما إن يضغط بقدمه على الدوّاسة حتى يدور الجنزير، فتنطلق به العجلتان في توازن تامّ. الحرية نأتيها كي نركب صهوتها بعد طول غياب، فلا تتردد في أن تطوّح بنا كبغل جامح. تلك قاعدة كونية، تحصل مع الأفراد والشعوب على السّواء.
طفقت أحوم لبعض الأيام. ثم ما لبثت أن أقفلت عليّ باب البيت وركنت إلى عزلتي.
عدا حالات الضرورة القصوى، لم تعد لي بعد انصرام يوم عملي الرتيب سوى بعض الانشغالات، إن لم أقل الحركات المعدودة التي أدمنتها، والدائرة في فلك مكتبتي وشاشة تلفازي المسطحة، كانت مثل عكاكيز أستند إليها في ليلي الأجدب، سعياً إلى ملامسة تخوم واحة النوم المتباعدة الأطراف. صرت بحق أعيش كبهيمة بدماغ مركّب، علفها الآداب العصرية والسينما العالمية والوثائقيات. حتى مخطوطي الذي كنت متحمساً لإكمال الاشتغال عليه، ظناً مني أن الوقت وحده كان ينقصني لذلك، صرت لا أقترب منه إلا لماماً. من جهتها، صلتي بالنساء غدت بيولوجية صرفة. قلبي الذي أضحى خشبياً كدولاب ناعورة صار يضخ الدم بحياد تام. لقد نأى بنفسه عن نوازل العاطفة وتقلباتها. قرر ألا يراهن من جديد داخل كازينوها الأهوج، ولو بخفقة صغيرة واحدة.
أو على الأقل، هكذا اعتقدت.
أقبل الصيف وأقبل معه رمضان. عمدت إلى إرجاء تاريخ عطلتي، اقتداء بغالبية زملائي الموظفين. والحال أن المسألة برمّتها لم تعد تعني ليَ الشيء الكثير. فأن يطول يوم رمضان أو يقصر، أن يصادف زمنَ القيظ أو أَوانَ البَرَد، أنا في حلّ من الأمر. ما دمت سأقضي عطلتي السنوية وحيداً، فأن أستفيد منها في عز الصيف أو مقتبل الخريف، لا فرق. لا فرق أن تتزامن إجازتي مع شهر الإمساك والتّقوى، أو مع موسم خلع الملابس في المسابح وشواطئ البحار.
أكثر شيء غلبني على أمري نظام البيت. جاريت ظروفي ما أمكن لي أن أجاريها، ثم ذات صباح طفح بي الكيل. لم أجد بدّاً من إحياء آصرتي بشامة الخادمة. كان قراراً مصيرياً. كنت قد ألفت شيئاً فشيئاً غض الطرف عن امتلاء محيطي المباشر بأصناف من الفتات المبثوث ومتبقيات الطعام. ألفت حواشي البيتزا المقضومة وقناني الجعة المفرغة وعلب العصير المشطوفة ونثارات الفواكه والبسكويت. ثم جاء ذلك النهار. بمجرد ما فتحت عينيّ، لمحت قشرة بطاطا نِيئَة بمحاذاة أنفي، ففهمت أنها قاسمتني السرير لتلك الليلة. أصابني هلع شديد. هالني ما صرتُ إليه، وأخذت تتراءى لي صور كابوسية صادمة جزت بعناية من عوالم التشرد والصعلكة لم يكن بطلها سواي. بعدها بقليل، قفز طيف شامة إلى ذهني. تبدّت في هيأة طوق نجاة. إنها بلا شك منقذتي الأثيرة من الضياع والاندثار. تذكرت فجأة صحن البطاطس المقلية الذي لم أفلح البارحة في إخراجه إلى الوجود. عاودني نفس شعور الخذلان القاسي الذي بطش بكياني ساعتها. كان الأمر محبطاً للغاية: عويدات البطاطا تفحّمت عن آخرها قبل أن تتجاوز حدود فمي، إذ كنت مستغرقاً في مشاهدة قرص مدمج مقرصن اسمه بوغافر 33، وهو فيلم ذاكرة يؤرخ لاستبسال رجال ونساء وأطفال آيت عطّا في مقاومة المد الاستعماري بدايةَ الثلاثينيات. مع أني في الأصل، كنت أنوي قلي خمس أو ست سمكات موسى كانت منسية عندي في حجرة التجميد، لكني استصعبت تلك المهمة أيّما استصعاب، فأعدت حُوَيْتاتي فوراً إلى مرقدها في الثلاجة، وأقنعت نفسي باختصار العناء والاكتفاء بطبق بطاطا سريع مَريء. علماً أن ما حفزني أكثر على اختياري ذاك هو كوني قد قرأت، في صباح ذات اليوم، خبراً عن دراسة علمية أنجزت بطلب من مجلس البطاطا البريطاني خلصت إلى أن البطاطا المقلية «تحسن المزاج وتبعث البهجة في النفوس وتهدئ الخواطر». فعلاً، لقد تحسن مزاجي.
وأنا أستعيض عن السمك بالبطاطس، لم أكن على وعي بأني أعود بالبطاطا المقلية إلى سيرتها الأولى. لم أفكر ساعتها في ذلك الصياد الوالوني الذي دأب على قلي السمك على ضفاف نهر المُوز، إلى أن جاء اليوم الذي تجمد فيه المجرى واختفى السمك فكان أولَ شخص يهتدي إلى فكرة تقطيع البطاطا ورميها في الزيت الحامية. الفرنسيون يصرون على أن البطاطا المقلية ظهرت أول ما ظهرت فوق جسور السين، بعيد الثورة الفرنسية، بل إنهم يعدّون البطاطا المقلية حجة من حجج العبقرية الباريسية. مهما يكن، فذلك الشخص الذي، في نهاية القرن الثامن عشر، ولأول مرة في تاريخ الجنس البشري، قذف بالبطاطا في زيت القلي، سواء أكان بلجيكياً أو فرنسياً أو من جزر القمر، ذلك الأخ اتضح جليّاً أنه أشد حيلة مني مليون مرة. فبينما كللت تجربته الرائدة بالنجاح، لا وبَلْ فتحت الباب على مصراعيه لتقليد سعيد ما لبث أن غزا الكرة الأرضية على امتدادها، احترقَتْ أنا بطاطسي بالكامل، وكل ما استطعت صنعه آخر المطاف هو قطع الغاز بامتعاض، ثم إغلاق باب المطبخ على جو دهني ثقيل محتقن بأبخرة الزيت المحروقة السامة، كان الكثير منها للأسف قد تمكن من أن ينفذ إلى آخر زاوية في البيت.
حاولت أن أواسيَ نفسي ما استطعت، فاحتراق مقلاة بطاطس ليس نهاية العالم، لكن وقع الحادث على قلبي كان مدمّراً. لم أشعر إلا وجفوني تبتل بدمع ساخن ما لبث أن انهمر على شفتي، ثم صارت الدموع تستحث بعضها، إذ كان تماسها مع لساني يذكّرني بطعم الملح الذي رأيت نفسي سلفاً وأنا أذره على البطاطس المستوية الشقراء، الضاربة إلى حمرة خفيفة، والتي كنت منّيت نفسي بقرقشتها في استلذاذ بالغ.
في الغد، وبعد خمس سنوات من الانقطاع، اعتزمت إذن دعوة شامة لاستئناف الخدمة. قصدت بيتها فور فراغي من عمل المكتب. علماً أني كنت أجهل كل شيء عن التزاماتها الراهنة وعن جدولها الزمني. ربما تكون قد غيرت مسكنها، أو انتقلت إلى حي آخر أو حتى مدينة أخرى، هذه أشياء تحدث. لعلها استبدلت وظيفة الخادمة بأخرى أفضل منها، ولماذا لا تكون قد فازت باليانصيب، أو ربما هلكت على متن أحد قوارب الموت في البحر المتوسط؟!
خمس سنوات، لا يجمعها إلا الفم، مضت كلمح البصر، وأحياناً أخرى بدا فيها الوقت ثقيلاً، متلكئاً، لا يدير وجهه السمج حتى يرهق العصب، يقتل العرق ويزهق الروح. أشياء كثيرة حدثت. احتفلت بعيد زواجي الأول، اندلعت حرب تموز في جنوب لبنان، سُجن ابن شامة، مات زوجها، اكتشفت الناسا الماء في باطن القمر، أعدم صدام، مات بينوشي من تلقاء نفسه، صَدَرت بلاي ستيشن 3، اندلعت حرب غزة في غزة، نال الجبل الأسود استقلاله عن الصرب، نلت أنا استقلالي عن زوجتي، مات ثالث آخِر محاربي الحرب العالمية الأولى، ماتت آخر الناجين في ملحمة التيتانيك، حتى روز ماتت، ليس كيت ونسلت، بل كلوريا ستيوارت، أفلس «بنك ليمان براذرز» في أقل من ثلاثة أيام وهوى على أنفه بعدما ظل واقفاً منذ سنة 1850، استبدَلتُ كالون قفل البيت أربع مرات، قرأت كتباً كثيرة، لم أقرأ كتباً أكثر، حيَّنْت نظاراتي الطبية أربع مرات أيضاً، صارت الأرض أكثر ازدحاماً، صار الفيسبوك ثالث بلد من حيث عدد السكان بعد الصين والهند، صار الفضاء مكتظاً واصطدم قمران اصطناعيان في قلب السماء.
(*) الفصل الأول من رواية بالعنوان نفسه، صدرت أخيراً عن «دار مرسم» الرباط.
(**) عبد الهادي السعيد شاعر وروائي مغربي، ولد سنة 1974، في إحدى ضواحي مراكش. حصل سنة 1996 على «جائزة اتحاد كتاب المغرب» عن ديوانه الشعري الأول «تفاصيل السراب». يكتب باللغتين العربية والفرنسية. صدرت له سنة 2002 مسرحية عن «دار لارماتان» في باريس، تحت عنوان Infactus ou les mots décroisés. ومن دواوينه العربية: «لا وأخواتها» (2003)، «روتين الدهشة» (2004)، «الحدائق ليست دائماً على صواب» (2014)، «سِفر الوجوه» (2020). من ترجماته في الشعر: «قريني العزيز» لعبد اللطيف اللعبي (2015).


