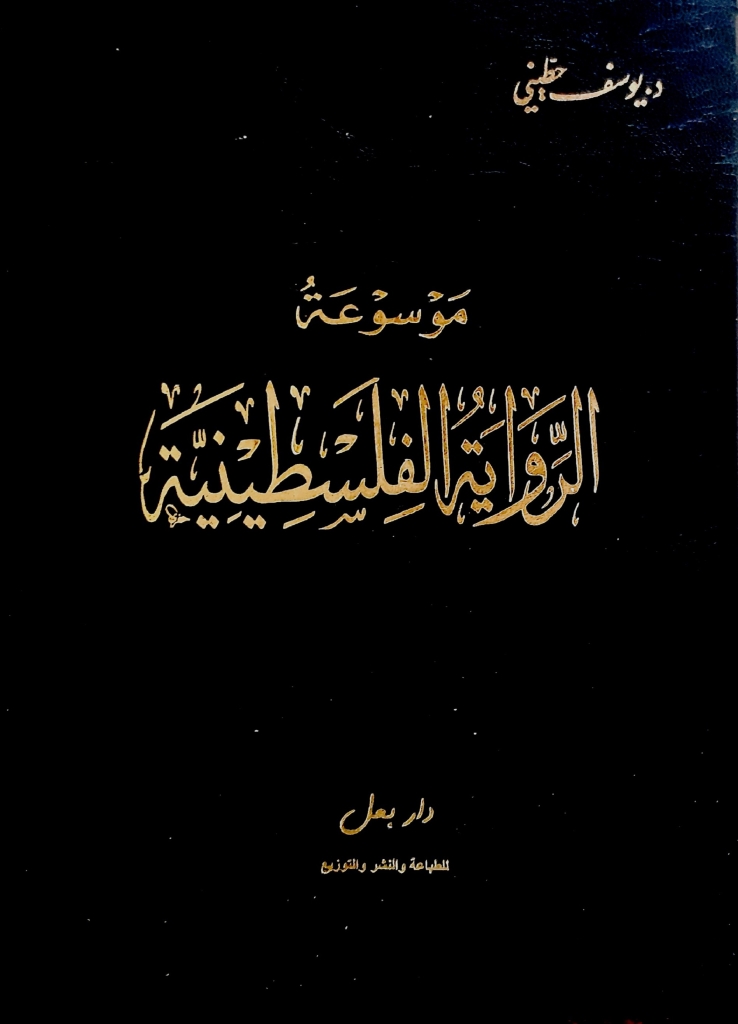
يشير الباحث إلى أن مواكبة تطورات القضية الفلسطينية روائياً لا تضع كل هذه الروايات في مكانة واحدة، لعدم استيفاء شروط الفن الروائي «الأمر الذي منح عدداً من الروايات جواز سفر غير شرعي إلى عالم الرواية». ستعتني معظم روايات ما بعد النكبة بأرشفة الزمن المستعاد، مثلما فعلت سحر خليفة في «أصل وفصل»، من خلال قراءة تطورات الانتداب البريطاني على فلسطين. وسيستعيد فيصل حوراني في «بير الشوم» الصراع الدائر على فلسطين أرضاً وشعباً، قبل حدوث النكبة، من موقع تاريخي أكثر منه جمالياً، فيما غطّى غسان كنفاني مرحلة خصبة من مراحل النضال الفلسطيني، راصداً عتبات التشرّد واللجوء والمقاومة ببلاغة روائية لافتة محاولاً صناعة تاريخه الخاص، من خلال اقتفاء أثر شخصيات عاشت النكبة في خيام التشرد وانتهت إلى خيام التدريب، بعد انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1965، كما في «رجال في الشمس»، و«أم سعد». وستتعدد مرايا البلاد المنكوبة في عمل إبراهيم نصر الله «الملهاة الفلسطينية»، إذ تتعانق الرؤية بالتاريخ بالفن في روايات متعاقبة. وستغيب الفانتازيا التاريخية عن المدوّنة الروائية الفلسطينية تقريباً، عدا بعض شطحات إميل حبيبي التي مزجت التاريخ بالوثيقة، كما في «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل».
ستقتسم الرواية الفلسطينية الزمن بالتذكّر الداخلي حيناً، والتذكّر الخارجي طوراً، كتعويض عن خسائر الأمس وتوثيقها في آنٍ واحد، ما يفتح العدسة إلى أقصاها على سرديات متجاورة، كما في «يوميات سراب عفّان» لجبرا إبراهيم جبرا، و«ما تبقى لكم» لغسان كنفاني، و«الهجرة إلى الجحيم» لمحمود شاهين، عبر اللجوء إلى طرق سردية مبتكرة، وإيقاعات لغوية ترنّ مثل جرس لشحن العاطفة على نحوٍ أكثر تأثيراً. كأن الروائي الفلسطيني يُنشئ تاريخاً لمقاومة النسيان في جغرافيا مختطفة، ما يستدعي أسطرة المكان والشخصية والحكاية. وإذا بالموت يصبح «لا نقيضاً للحياة بل استمراراً لها»، ولو كان الحلم سراباً في صحراء لا نهائية. هكذا تحضر شخصية المناضل بوصفه نموذجاً جذّاباً وأسطورياً، فهو «البطل الذي لا يُهزم»، نظراً إلى قوّته الجسدية ومهابة حضوره. ثم سنرتطم بشخصية «المثقف الثوري» التي تتقاطع مع شخصية المناضل لجهة القوة والنبل والحكمة. في رواية «عباد الشمس» لسحر خليفة، تثور «رفيف» على الاحتلال، وترفض الانضباط والانصياع حتى للإشارات الضوئية التي تنظّم مرور السيارات والمشاة. لكن هذا التمرّد ينتهي إلى حرية مقيّدة، وهناك نموذج «الفلسطيني الكوني» كما يتبدى في معظم أعمال جبرا إبراهيم جبرا التي تنطوي على شخصيات تتطلع إلى الكمال على عكس شخصيات كنفاني التي ترصد النقصان. على المقلب الآخر، تحضر صورة الفلسطيني العاجز والمتواطئ الذي يبحث عن خلاصه الوهمي بتعامله مع سلطة الاحتلال، أو ذلك الذي ينفصل عن شعبه، وفي المقابل سنصطدم بشخصية العدو، والإنكليزي المستعمر، واليهودي المستعمر، والطاغية الذي يمارس أشكال الاضطهاد ضد الفلسطينيين، فيما تحتل شخصية الأم مكانة مرموقة بوصفها أماً جمعية، ثم شخصية المرأة المتمردة ومواجهتها «الاضطهاد المركّب»، وهو ما نجده في روايات سحر خليفة، وليانا بدر، وسلوى البنا، وأخريات، من موقع نسوي في المقام الأول.
توثيق نحو 2000 رواية فلسطينية صدرت خلال 100 عام
لعل ما يميّز الرواية الفلسطينية عن الرواية العربية هو علاقتها بالمكان: أن تكتب عن أرض محتلة، ومحاولة استعادتها بالحنين والوثيقة والذكريات والمقاومة، فههنا قرى مدمّرة، وبيارات مغتصبة، ومخيّمات، ومناف، ومستعمرات، وجدران عازلة. كلّ هذه المفردات أفرزت نصّاً مختلفاً عن سواه، بخطاب روائي ينهض على «الإحساس المظلم بالفضاء»، والتناوب بين «حلم الوطن، وحقيقة المنفى». شريط طويل من المدن والقرى المستعادة في الحكاية، كما لو أنها فردوس مفقود، تتأرجح بين «هنا/ وهناك»، فيما تحضر مدينة القدس بكل تجلياتها المكانية كأيقونة مقدّسة. على المقلب الآخر، يلجم المنفى أحلام الفلسطيني ويشدّه إلى واقع مختلف، فكيف للمنفي أن يجد قبراً في أرض لم تعد متاحة؟ وكيف ينظر إلى البحر إلا كعدو، وهو يبتعد عن اليابسة في هجرة قسرية إلى اللامكان؟ وإذا بالمكان الأول بعد احتلاله يتحوّل إلى منفى آخر. هذا القلق الوجودي أنتج نصّاً مكانياً متخيلاً، ففي «البحث عن وليد مسعود»، يصف جبرا إبراهيم جبرا بلدته القديمة بأنها «تتلألأ كجوهرة». وهو ما سيتواتر في روايات أخرى بتشكيل فضاء مكاني متوهّم يعوّض الخسارة المحقّقة، بطبقات متعددة، تبدأ بالبيت، مروراً بأماكن اللجوء الأولى بما فيها اصطبلات الدواب، ثم السجن كنوع من الإقامة الجبرية والإذلال والتعذيب. وإذا بالحياة داخل السجن تتساوى مع الحياة خارجه، تحت قبضة الاحتلال الإسرائيلي. وسيلجأ روائيون آخرون إلى أمكنة افتراضية كإشارة إلى ضياع الفلسطيني نفسه، في رحلة سيزيفية، ومتاهة حقيقية بلا ضفاف، ما ينعكس على عناوين الروايات أيضاً، مثل «عقارب الوحل»، و«برج اللقلق»، و«الهجرة إلى الجحيم» و«السفينة»، و«الصبّار»، و«سداسية الأيام الستة»، و«الحياة على ذمة الموت». ويلتفت الباحث الفلسطيني إلى سطوة الأغنية الشعبية، والموروث، والأمثال الشعبية، والأسطورة، والخرافة، على الخطاب الروائي وتوظيفها كمكوّن أساسي في الفضاء العام، والوجدان الشعبي الجمعي، وكذلك الاتكاء على اللهجة العامية في النسيج السردي وتطريزه في السياقات اللغوية والإيقاعية.
على الأرجح، فإن هذا التشظي الأسلوبي في السرديات الروائية الفلسطينية، أتى من وعورة الواقع الفلسطيني وتحولاته التراجيدية المتعاقبة، لكن عبارتين لغسان كنفاني وردتا في روايتين له، ستختزلان هذا الجحيم كلّه: «لماذا لم تدقوا جدران الخزّان؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزّان.. لماذا؟» (رجال في الشمس)، و«أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا يحدث ذلك كلّه» (عائد إلى حيفا).


