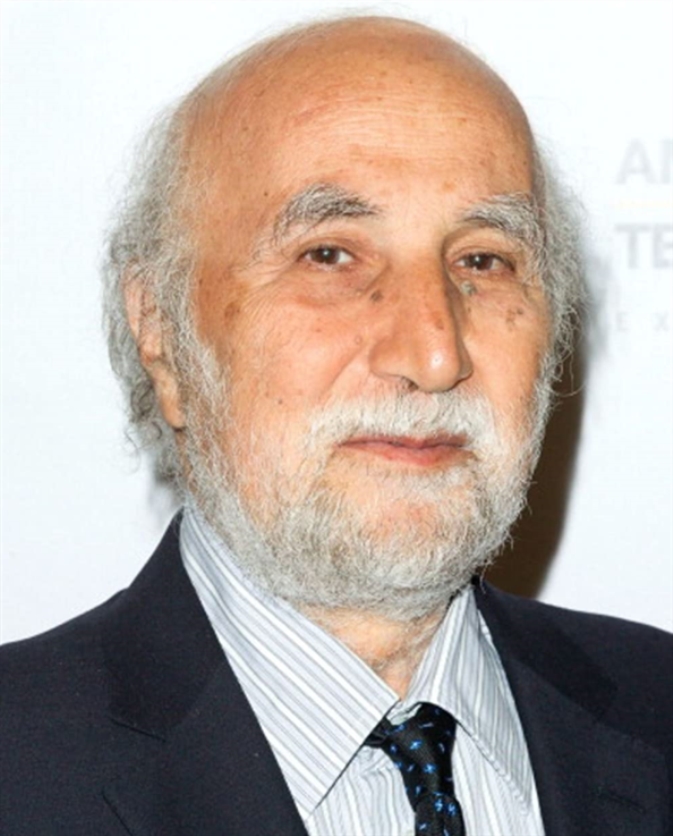لم يكن عجمي يظهر في الإعلام التقدّمي أو الإعلام الحرّ الذي كان يمكن أن يوجّه نقداً له. كان يظهر في الشبكات الأميركيّة التي تطلّبت منه ذمّ الفلسطينيّين والعرب، وكان يفعل ذلك بحماسة وعداء شديديْن. لم يكن يمنح مقابلات لصحافيّين يُعدّون مقالات نقديّة عنه، مثل مقالة آدم شاتز في مجلة «ذا نيشن». أخطأ عجمي الحسبان مرّة واحدة. كان مدعواً إلى مؤتمر في دبي (كانت الإمارات والسعوديّة تقدّره حقّ تقدير في آخر حياته، خصوصاً لأنه كان قريباً جداً من أجهزة الحكم في إسرائيل ومن قادة الحزب الجمهوري في واشنطن) وطلبت محطة سعوديّة إجراء مقابلة معه، فظنّ أن المقابلة ستكون على نسق مقالات صديقه عبد الرحمن الراشد. لكن المُحاور لم يكن إلا الإعلامي السعودي البارع والتقدّمي، داود الشريان (الذي نَعاني ذات يوم في جريدة «الحياة» بعنوان «نهاية رجل شجاع»، لأنني انتقدتُ خالد بن سلطان). داود الشريان أبدعَ في محاورة عجمي لم يسمع عجمي هذا الكلام من قبل من أي مُحاوِر. سأله الشريان عن سبب كراهيته للشعب الفلسطيني وعدم إبدائه أي تعاطف معه، كما سأله عن الوحشيّة الأميركيّة في العراق. كان عجمي مرتبكاً ولم تسعفه لغته العربيّة الضعيفة في الردّ، خصوصاً أنه معتاد على الأسئلة السهلة في الإعلام الأميركي. لكن عجمي كان صريحاً عندما أخبر الشريان أنه دائماً يعتبر نفسه أميركيّاً وليس عربيّاً. وهذا كان واضحاً في كل مقابلاته على الشاشات الأميركيّة، أن يستهلّ إجاباته بالقول: إنني كأميركي، كذا وكذا. وهذا ديدن عدد من المتحدّثين العرب في أميركا. يناشدون الرجل الأبيض كي يقبلهم واحداً منهم، مع أن الرجل الأبيض لن يقبلهم في صفوفه لأنه يعتبرهم، مهما نطقوا بالصهيونيّة، رجلاً ملوّناً خارج العرق السائد. وأوضح عجمي أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تعنيه، كما ظلّ يكرّر أن مشروعه هو مشروع ليبرالي علماني. لكن عجمي تحالف مع اليمين المسيحي ومع المحافظين الجدد الذين روّجوا له. أين الليبراليّة العلمانيّة في الحزب الجمهوري الذي أيّده؟
أذكر ذلك جيّداً، أن إدوارد سعيد وصف عجمي (بالإنكليزيّة) أمام تجمّع للعرب الأميركيّين بـ«العم عبده»، على نسق «الأنكل توم»، أي الأسود المُطيع الخانع
تحدثتُ في الحلقة الماضية عن غرابة حصول عجمي على مركز أكاديمي في جامعة برنستون بعد تخرّجه من «كليّة شرق أوريغون» ثم «جامعة واشنطن في سياتل»، لأن جامعة برنستون في قسم العلوم السياسيّة عادة تعيّن فقط خرّيجي خمس أو ست جامعات فقط. لكن البروفسور ريتشارد فولك يوضّح الأمر في مدوّنته في 9 تموّز، 2014. ريتشارد فولك هو أستاذ شرف في القانون والعلاقات الدوليّة في جامعة برنستون وهو من القلّة المُجاهرة بتأييد الحق الفلسطيني في أميركا (تعرّفتُ عليه للمرّة الأولى في منزل سري مقدسي، أستاذ الأدب المقارن في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وكنا مشاركين جميعاً في مؤتمر عن فلسطين). وفولك عمل مقرّراً لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واعترض اللوبي الإسرائيلي على تعيينه. يعترف فولك أنه كان مسؤولاً عن تعيين عجمي في جامعة برونستون. يقول إنه تشارك مع عجمي في نفس الرؤية للعلاقات الدوليّة وأنه هو الذي عرَّف عجمي على إدوارد سعيد وإقبال أحمد (إقبال أحمد مثقّف باكستاني يساري وكان صديقاً قريباً من سعيد ومن أصدح الأصوات المطالبة بالحق الفلسطيني في الغرب، وكان خطيباً في معظم المنتديات والمؤتمرات العربيّة في أميركا، قبل أن تقضي الأنظمة الخليجيّة على كل المنظمات العربيّة-الأميركيّة لأن الجمهور كان معارضاً للحرب الأميركيّة في العراق في 1990). نفر فولك من كتابات عجمي ومن التوجّه السجالي «الموالي لإسرائيل». ويلاحظ فولك أن مراثي عجمي اختلفت: إطراء وتبجيل من جريدة «وول ستريت جورنال» الصهيونية وذمّ وتقريع من جريدة «الصباح» التركيّة التي اتهمت عجمي بالانتهازيّة وقالت إننا سنتذكره فقط لاعتذاريّته عن الجرائم الإسرائيليّة (كان من مؤيّدي الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في 1982، مثله مثل الكثير من أهل الجنوب، للأسف—وهذه الحقيقة ستقبّح تاريخ جبل عامل إلى الأبد). هلّلَ عجمي للغزو الأميركي للعراق وزها في مقابلة الشريان أن ديفيد بتريوس، القائد العام للقوات الاحتلاليّة في العراق، كان يطلب مشورته. كان ضيفاً دائماً في جلسات الكونغرس ولم يكن يخيّب توقعاتهم في ذم الشعب الفلسطيني والسخرية من العرب. قالت عنه جريدة «الصباح» التركيّة إنه مثال «المسلم الجيّد»، بحسب تعبير محمود ممداني في كتابه «مسلم جيّد، مسلم سيّء: أميركا والحرب الباردة وجذور الإرهاب». وانقطعت الصداقة بين فولك وبين عجمي باستثناء لقاء عابر في التسعينيّات في العاصمة الأميركيّة. يقول فولك إن عجمي كان قلقاً من كلام ضدّه صدر عن إدوارد سعيد واعتبره عجمي بمثابة «حكم إعدام». ولم يكن ما قاله عجمي لفولك صحيحاً أبداً. كلّ ما في الأمر، وأنا أذكر ذلك جيّداً، أن سعيد وصف عجمي (بالإنكليزيّة) أمام تجمّع للعرب الأميركيّين بـ«العم عبده»، على نسق «الأنكل توم»، أي الأسود المُطيع الخانع (أنا للأمانة قلتُ لسعيد يومها إن العبارة يمكن أن تستعمل لقمع الأفكار الحرّة مع أنها تصلح في حالة عجمي).
ويتناول فولك حالة التحوّل من موقف تقدّمي إلى موقف يميني رجعي (مع أنني أشكّك في مطابقة حالة عجمي مع الظاهرة لأنه لم يكن تقدميّاً في حياته، بل لبس الرداء عندما كان ذلك ملائماً لحصوله على وظيفة من خلال علاقة مع الأكاديمي التقدّمي، فولك). والتأمّل في الظاهرة مفيد لأننا، خصوصاً في لبنان، شهدنا حالات عديدة من التحوّل من اليسار إلى اليمين الرجعي. يُشكّك فولك في صوابية تحليل التحوّل بناء على لحظة تأمّل عميق. يتساءل فولك: هل هي صدفة أن التحوّل يكون نحو الجهة الرابحة والثريّة؟ من هنا، أنا لا أؤمن بنظريّة التحوّل: إن هناك مثلاً مَن كان يساريّاً عروبياً ثم اشتراه رفيق الحريري. أقول إن هذا الشخص لم يكن وطنيّاً أو يساريّاً من قبل بل كان في الأصل انتهازياً. كان هناك انتفاع في الماضي من الانضواء في صف المقاومة الفلسطينيّة والحركة الوطنية، وعندما أفلست الحركتان هجرها معظم مؤيّديها. والصحافي اللبناني الذي كان في صف المقاومة ثم انتقل إلى العداء لها: هذا لم يكن إلا منتفعاً في الحالة الأولى ووجد أن الانتقال أنفع. هذا يصلح في حالة عجمي. تقرّب من الأكاديمي ريتشارد فولك عندما وجد في الصلة دفعاً لطموحاته الأكاديميّة في بداية عمله، ثم وجد أن المنفعة أكبر في الصف الصهيوني. وقسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة برنستون من أعرق المراكز الصهيونيّة في الجامعات (وترأسه برنارد لويس لسنوات، وهناك تعرّف لويس على عجمي. ونفر فيليب حتي من المركز في آخر سنواته وعاقب جامعة برنستون بأن أوصى بنقل مكتبته إلى جامعة مينسوتا).
أمّا عن علاقة عجمي اللاحقة بإسرائيل (وهو لم يتناولها في الكتاب لأن الكتاب يتطرّق لسنواته الأولى في بيروت، من الطفولة إلى الصبا حتى مجيئه إلى أميركا بعد تخرّجه من الثانويّة) فهي موضوع فصل في كتاب المؤرّخ الإسرائيلي، مارتن كريمر، «فؤاد عجمي يذهب إلى إسرائيل» في كتاب، «الحرب على الإرهاب: إسرائيل والإسلام والشرق الأوسط». وكريمر كان تلميذاً لعجمي في جامعة برنستون في عام 1974. يقول عجمي إنه كان عنده حس الحشرية نحو إسرائيل منذ أن كان يشاهد المطلّة من قريته أرنون في جنوب لبنان. بعضنا نرى فلسطين المحتلّة والمستوطنات من الحدود الجنوبيّة وينتابنا غضب شديد لمشهد فلسطين وهي مُحتلّة، والبعض الآخر تنتابه حشريّة عن العدوّ. كأن يقول فرنسي واقعٌ تحت الاحتلال النازي إن حس الحشرية نحو النازية نمى عنده تحت الاحتلال. يعترف كريمر أن عجمي لم يكن في عام 1974 ثائراً من أجل فلسطين والعروبة (عندما كان يفترض أنه كان قومياً عربيّاً متحمّساً لفلسطين). على العكس، يروي أن كان هناك في صفّه ضابط مدفعيّة إسرائيلي (شارك في حرب تشرين) وأن عجمي كان مهتماً جداً به، وفي مقابلة مع جريدة الجامعة قال الضابط الإسرائيلي عن عجمي إنه «يتفاهم معه جيداً». هذا في عام 1974.
ويروي مايكل كريمر أن عجمي أخبر تلاميذه في عام 1979 أن ياسر عرفات وجّه له دعوة لزيارته برفقة عدد من تلاميذه. من المؤكد أن عجمي، المعروف بعدم احترامه للحقيقة، اختلق القصّة كي يبهر السامعين. وهذا ديدنه في المهنة التي أوجدها لنفسها: المخبر المحلّي الذي يستطيع أن يروي بأسلوب جذّاب أخبار تدغدغ المخيّلة العنصريّة للسامعين في الغرب. لم يكن عرفات قد سمع بعجمي (ومن المستغرب أن نبيه برّي كتب مقدّمة الترجمة العربيّة لكتاب عجمي عن موسى الصدر، أو ربما هو لم يعرف عن علاقات ودور عجمي في الولايات المتحدة على حقيقته).
يقول عجمي إنه كان عنده حس الحشرية نحو إسرائيل منذ أن كان يشاهد المطلّة من قريته أرنون في جنوب لبنان
يرصد كريمر بدايات تحوّل عجمي، إذا كان هناك من تحوّل، إلى مرحلة انتقاله لوظيفته الجديدة في مركز الدراسات الشرق الأوسطيّة في كليّة الدراسات الدوليّة المتقدّمة التابعة لجامعة جونز هوبكنز، وتعرّفه على مارتن بيريتز، ناشر المجلّة الصهيونيّة المتطرّفة، «ذا نيو ريببلك» (للأمانة، لم تعد المجلّة مملوكة منه وتغيّر خطها التحريري كثيراً في السنوات الماضية، وابتعدت عن الهوس بالمصلحة الإسرائيليّة). وكان عجمي قريباً من محرر الشؤون الثقافيّة في المجلّة، ليون فيزلتير، وهو الذي أشرف مع زوجته على تجميع أوراق مذكرات عجمي ودفعها للنشر. وتقرّب عجمي أيضاً من مورت زاكرمان، ناشر مجلّة «ذا أتلنتك» (هي أصبحت مملوكة من أرملة ستيف جوبز، ويحرّرها سجّان إسرائيلي سابق) ومجلّة «يو أس وورلد أند نيوز ريبورت». والأخير كان نافذاً في منظّمات اللوبي الصهيوني في واشنطن وأيوا. الاثنان أخذا بعجمي: كان يندر أن تجد عربياً في أميركا لا يمانع في ذم القضيّة الفلسطينيّة والسخرية من العنصر العربي. وموهبة عجمي الكتابيّة واللفظيّة زادت من رواجه ومن الطلب على استعراضاته الإعلاميّة والخطابيّة.
كانت أوّل زيارة لعجمي إلى إسرائيل في عام 1980. يومها، بحسب ما روى في مجلّة «يو أس نيوز»، عبرَ عبْر جسر أللنبي. ويقول كرايمر أنه منذ تلك الزيارة أصبح يزور فلسطين المحتلّة (إسرائيل بالنسبة له) بانتظام، وكان يطير مباشرة إلى مطار بن غوريون. وكان أصدقاؤه، مثل كريمر، ينتظرونه قبل المرور في قسم الجوازات كي لا يعاني من الإذلال الذي يتعرّض له كل عربي، ولو كان أميركيّاً، في المطار. (يقول رجل أعمال عربي معروف أن الأخ غير الشقيق لعجمي، محمد، المقيم في لندن، كان يحتفظ بجناح دائم في فندق الملك ديفيد وكان يزهو بصداقاته مع زعماء إسرائيل). يقول عجمي في مقالة في «يو أس وورلد» إنه كان يعرف الكتاب والصحافيّين الإسرائيليّين من زياراتهم إلى أميركا، وقال إن إسرائيل «انفتحت نحوه». طبعاً، طمأن قراء المجلة الصهيونيّة بأن «قصة فلسطين ليست قصّتي». (عنوان مقالته هو «نهاية القوميّة العربيّة». كم كان يحب العبارة لأنها منذ أن كتبها في مقالة في مجلّة «فورين أفرز» في شتاء 1978، أصبح رثاء القوميّة العربيّة من اختصاصه، وقلّده كثيرون من العرب في الغرب، مثل عضيد داويشا في أميركا وبسام طيبي في ألمانيا). يقول كريمر إن زيارات عجمي لإسرائيل كانت «خاصّة» وأنه لم يُلق محاضرات فيها. وكان يلتقي بمسؤولين إسرائيليّين. وكان صديقه، إيتامار رابينوفيتش (المؤّرخ المقرّب من رابين) ينظّم له لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليّين. يطري كريمر على عجمي عندما يقول إن عجمي لم يكن يزهو بخبر لقاءاته مع رؤساء حكومة إسرائيل. ولماذا يزهو؟ خصوصاً أن انحيازه السياسي كان واضحاً، وكانت اللقاءات ستزيد من صبغته الصهيونيّة. يقول عجمي إن «ثقافة الجامعات (الإسرائيليّة) وحدّة المناظرات الفكريّة فيها قضت على التردّد الذي ساوره في بداية زياراته». لم يلاحظ عجمي حدود المناظرات الفكريّة وأن الإيمان بدونيّة الشعب العربي كان ولا يزال محلّ إجماع بين مثقّفي العدوّ.
وكانت أوّل إطلالة (علنيّة) لعجمي في مناسبة صهيونيّة أميركيّة في 1992 في حفل لجمع التبرّعات لمنظمّة صهيونيّة استيطانيّة في نيويورك، وكان الخطيب الآخر هنري كيسنجر. يقول كريمر إن الإعلام العربي ضجّ بالخبر وذمَّ عجمي بعنف. هذا غير صحيح على الإطلاق. لم يكن عجمي معروفاً أبداً في العالم العربي في حينه ولم يتم ذكر الخبر في أي من منابر الإعلام العربي. أصبح عجمي معروفاً لقسم من العرب (فقط) بعد غزو العراق لأنه كان بوقاً من أبواق الإدارة الأميركيّة وعصر الفضائيّات عرّفه على جمهور عربي لم يكن يدري به (لا يزال هناك من العرب من يسألني: من هو هذا الفؤاد عجمي الذي تكتب عنه؟). وفي عام 2012، حضر عجمي حفلاً لـ«أصدقاء جامعة تل أبيب الأميركيّين» بمناسبة تكريم صديقه برنارد لويس. وكلمة عجمي في المناسبة، ووراءه العلم الإسرائيلي، ركيكة للغاية وهزليّة وهزيلة، وملؤها الإعجاب بلويس ونهجه والتنصّل من العالم العربي. يعترف أنه كان في عام 1974، عندما كان قومياً عربيّاً بحسب السرديّات المغلوطة، يتقرّب من لويس عندما وصل إلى جامعة برنستون ويلقي عليه التحيّة باحترام، إلى أن سأله لويس عن أصله وسمح له بمناداته باسمه الأوّل. ولم ينس عجمي في كلمته أن يذمّ بإدوارد سعيد وأن يتنبأ أن التاريخ سينصف الذي نطق بالحقيقة، أي أن سعيد كان الكاذب عن الشرق الأوسط وأن الخبر اليقين هو عند المؤرّخ الصهيوني، برنارد لويس. ويقول إنه بالرغم من نقد لويس في العالم العربي فإن صحافيّين عرباً كانوا يقصدونه كي يتعرّفوا على لويس. طبعاً، هؤلاء الصحافيّون يعملون في إعلام الخليج الذي روّجَ لكَ ولبرنارد لويس ولعتاة الصهاينة. وبعد وفاة عجمي أفردت صحيفة «الشرق الأوسط» قسماً خاصاً بالمراثي عنه، وكلّها من مؤيّديه وأنصاره، من دون استثناء. لم تنشر أي كلمة نقد ضدّ فؤاد عجمي. الصحافة العربيّة تجاهلته في الغالب، لكن موقع «الحرّة» رثاه بحرارة ودموع مدرارة (هو موقع المحطة التلفزيونية العربيّة الرسميّة للحكومة الأميركيّة والمُكلّفة من الحكومة بضخّ البروباغندا الأميركيّة باللغة العربيّة. وموقع «يوتيوب» يضع تحذيراً حول مضمونها من أميركا لأن ضخ الأكاذيب الحكومية مسموح فقط خارج الحدود الأميركية بحسب القانون).
هذه المقدّمة كانت ضروريّة للتعريف بعجمي إلى الجمهور العربي قبل التطرّق، في الحلقة المقبلة، إلى كتابه الأخير الذي صدر بعد وفاته.
(يتبع)
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
asadabukhalil@